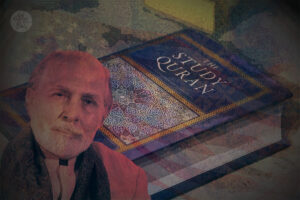لم تولَد ظاهرة الوشايات داخل الدولة والمجتمع من فراغ. بهدف السيطرة على مفاصل البلاد كافةً تهيّئ الأنظمة الشمولية بيئةً حاضنةً لإنماء الوشاية. وهذا ما قام به نظام الأسد في سوريا حين جنَّد أفراد المجتمع ضدّ بعضهم، وفتح الباب لاستقبال تقارير أمنيةٍ لقاء امتيازاتٍ ماديةٍ ومعنويةٍ، لتنشأ في المجتمع شبكةٌ من المخبرين المنتشرين في الشوارع والمستشفيات والمكاتب والمدارس. ومع سقوط بشار الأسد في نهاية سنة 2024، بقي وراءه إرثٌ تنظيميٌ في ثقافة المؤسسات السورية، لا يزال يثقل كاهلها. ويزيد الحالة تعقيداً حاجة المؤسسات الغارقة في الفساد إلى بناء آليات إبلاغٍ فعّالةٍ تتصدّى للتجاوزات وتفضح التلاعبات. ولعل لهذه المؤسسات في القوانين التي سنّتها جنوب إفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) لمحاربة الفساد مثالاً يمكن استلهامه في بناء عدالةٍ تنظيميةٍ داخل المؤسسات نفسها. وهو ما يساهم في التعويض عن الفجوات في القوانين التي لا توفر حمايةً كليةً أو فعليةً للمبلِغين عن الفساد.
وتتعدد أوجه الوشايات في الواقع الاجتماعي. ومكان العمل ليس عنها ببعيدٍ، بل يكاد يكون بيئةً خصبةً لها لما فيه من تنافسٍ وصراع طموحات. وتشير ديفارشا رامجيتان، المتخصصة بقانون العمل من جنوب أفريقيا، في مقالتها "ذي إمبلويي ذات كرايد وولف" (الموظف صاحب الإنذارات الكاذبة) المنشورة في نوفمبر 2024، بأن خطورة الوشايات الكيدية في أماكن العمل تتمثل باستهدافها أشخاصاً أبرياء أداةً لتصفية الحسابات. وفي مراحل متقدمةٍ من الانغماس في هذا السلوك يتسلح الوشاة بزلّات مَنْ حولهم، ويوثّقونها رصيداً يستخدمونه عند الحاجة لأهدافٍ شخصية. وبحكم اهتمامي البحثي في العلوم الإدارية وتقاطعاتها السياسية والاجتماعية، وثّقت قصةً سأذكرها مثلاً بلا تعيين أسماء الأشخاص والأماكن، حفاظاً على سلامتهم.
في مايو سنة 2025، في قريةٍ تقع شمال غرب سوريا أفضت وشايةٌ كيديةٌ إلى فصل ثلاث معلماتٍ ومديرةٍ من مدرسةٍ حكوميةٍ بعد أن ترصّدَت لهنّ زميلةٌ تدعى رهف (اسم مستعار). وعلى مدار أسابيع كان قرار الفصل هذا حديثَ الجيران وجلسات السمر في القرية. ومثل أيّ إشاعةٍ تتحور القصص وتتعدد الروايات، إلا أنها جميعاً كانت تصبّ في فضيحةٍ تطال المفصولات بعد أن لاحت حولهنّ تُهَمُ الفساد. جاهرت رهف بأنها مَن كانت وراء فصل "عصابة" متمثلةٍ بالمعلمات الثلاث والمديرة. وبحسب رواية شهودٍ على الواقعة تواصلَت معهم الفِراتْس فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، كان سبب الفصل شكوىً تقدّمت بها المعلمة رهف تَتّهم فيها المديرةَ بسوء الإدارة وبالارتشاء والسرقة.
أفضت الشكوى إلى حضور لجنة تحقيقٍ رسميةٍ من المجمع التربوي المسؤول عن المدراس في المنطقة. وفي التحقيق أدلت المعلمات الثلاث بشهاداتهنَّ وأكّدن على أن الادعاءات بحقّ المديرة ما هي إلا تلفيقاتٌ من المعلمة رهف بسبب عدم سماح المديرة لها بالتسيّب. انتهى التحقيق بقرار اللجنة فصل المديرة والشهود دون توضيح الأسباب. وبعد السؤال عن دواعي الفصل كان الردّ بأن رهف قدمت للّجنة تسجيلاتٍ توثّق أحاديث خاصةً بالمعلمات، تثبت أنهن لا يَرْقَيْن إلى مستوى عضواتٍ في مؤسسةٍ تعليمية.
لم تعلم المعلمات المفصولات محتوى التسجيلات، ولكنهن كنّ على يقينٍ بأنّ أحاديثهنَّ الخاصة استُخدِمت ضدّهن في التحقيق بسبب شهادتهن لصالح المديرة. لذا اشتكَيْن على زميلتهنّ بدعوى انتهاك خصوصيّتهن. ظهر تسجيلٌ بصوت رهف تعترف فيه لأحدٍ ما بحيازتها كثيراً من الأحاديث الخاصة بالمعلمات في المدرسة. ومع ذلك أنكرت لجنة التحقيق ورهف وجود أيّة تسجيلاتٍ بعد رفع الدعوى القضائية ضدّهم.
ومع زوال الذريعة الرئيسة لفصلهنّ، توجّهت المعلّمات مراراً إلى المجمع التربوي ومديرية التربية ومكتب التعليم في محافظتهنَّ للمطالبة بإعادة النظر في قرار الفصل. وأثناء رحلتهن بين هذه المؤسسات، لم يقبل بعض المسؤولين حتى سماعَهن، فيما سوّغ مسؤولون آخَرون قرارَ الفصل. غير أن إصرار المعلّمات على المطالبة بحقوقهنَّ أثمر عن إعادة المديرة ومعلمةٍ واحدةٍ فقط إلى وظيفتَيْهما، في حين بقيت المعلّمتان الباقيتان بانتظار إنفاذ وعدٍ قَطَعَه مسؤولٌ رفيع المستوى بإعادة تعيينهن وردِّ اعتبارهِن في أقرب فرصةٍ ممكنةٍ، وفقاً لرواية شهودٍ للفِراتْس فضّلوا عدم ذكر أسمائهم خوفاً من إيقاع الضرر على المعلمات.
هذه النتيجة، على أهميتها، لم تُنهِ كلَّ الآثار التي خلّفها قرار الفصل وما سبقه من مزاعم مغرضة. فكان الأذى الذي سبّبته الوشاية الكيدية أعمقَ وأعمّ.
من هذه الدراسات واحدةٌ شملت سبع عشرة دولةً نشرت سنة 2019 بعنوان "كروس ناشونال إيفيدنس أوف أ نيغتيفيتي بايِس إن سايكوفيسيولوجيكال رياكشنز تو نيوز" (دلائل عابرة للحدود على التحيز السلبي في ردود الأفعال النفسية العضوية في الاستجابة للأخبار)، أعدّتها مجموعةٌ من الباحثين. كشفت أن لدى البشر نزعةً فطريةً للانحياز إلى الخبر السلبي. إذ تكون استجاباتهم النفسية والعضوية أقوى تجاه المعلومات السلبية مقارنة بالإيجابية. المثير للاهتمام أن هذه الاستجابة، وإن تباينَتْ بحِدّتِها من شخصٍ لآخَر محكومين بسِماتهم الشخصية أو ظروفهم، إلا أنها عابرةٌ للحدود والثقافات. أيْ أنها سمةٌ إنسانيةٌ أكثر منها صفةً خاصةً بمجتمعٍ دون غيره.
وفي سياقٍ قريبٍ، توصلت إميلي ثورسون، الأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية بجامعة سيراكيوز في نيويورك في دراستها "بيليف إيكوز" (صدى المعتقد) المنشورة في سنة 2016 إلى أن التصحيحات، حتى وإن كانت فوريةً ودقيقةً، لا تمحو بسهولةٍ أثر المعلومات الخاطئة. تظلّ المعلومة الأولى عالقةً في الذهن ويدوم تأثيرها على المواقف والانطباعات اللاحقة. لتفسر بذلك بهذه النتائج مجتمعة، سبب صعوبة إزالة الضرر المعنوي المرتبط بالسمعة حتى بعد اعتذار الواشي أو تراجعه عن الخطأ.
تزداد خطورة هذه النتائج في أماكن العمل تحديداً، مع تمثّل السمعة المهنية رأسَ مالٍ معنوياً بالأساس. كذلك لا تقتصر آثارها على الفرد نفسه بل تمتد لتقويض الثقة داخل بيئة العمل نفسها. لهذا تؤكد ديفارشا رامجيتان في مقالتها في أكثر من موضعٍ على أضرار الادعاءات الزائفة أو المشوِّهة للسمعة في المؤسسات. بالإضافة إلى تعطيل هذه الادعاءات سير العمل والتسبب بخسائر مالية. وفي بعض الأحيان، قد يتعرض موظفون أبرياء لإجراءاتٍ تأديبيةٍ أو يفقدون وظائفهم استناداً إلى اتهاماتٍ لا أساس لها. كذلك فإن الأثر النفسي على من يُتَّهمون ظلماً قد يكون بالغاً، مما يؤدي إلى التوتر والقلق ويسهم في خلق بيئة عملٍ سامة.
ففي تقرير "للجدران آذان: تحليل وثائق سرية لقطاع الأمن السوري" الصادر في أبريل سنة 2019، يكشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن ملابسات المسألة، ويزيح الستار عن طبيعة المخبِر (الواشي) الذي قد يكون زميلاً أو طبيباً أو حتى قريباً. واستند التقرير إلى عينةٍ تحليليةٍ من نحو خمسة آلاف صفحةٍ من وثائق جُمعت من مقراتٍ حكوميةٍ مهجورةٍ من عدّة محافظاتٍ سوريةٍ بعد انسحاب النظام منها على خلفية الصراع المندلع. المرة الأولى في 2013 عند انسحاب قوات النظام من الطبقة والرقة. والثانية في 2015 بعد انسحابها من مواقعها في محافظة إدلب. ويشير التقرير إلى أن النظام السوري عمل منهجياً على ترسيخ سلوك الوشاية ضمن إستراتيجية توسيع الرقابة والسيطرة. وكشف أن المخبِرين كانوا من شرائح متعددةٍ تشمل الجنود والضباط والعاملين في القطاع الصحّي والمعارف وحتى أفراد العائلات. فكان الجندي يُوقِع بزميله والطبيب بمريضِه والمرء بقريبِه، إما مجبَرين بالقوة أو طوعاً لقاء امتيازاتٍ وحوافز.
كذا لم يسلم المعلِّمون من عدوى الوشاية، ففي مقالة واشنطن بوست بعنوان "ذا فول أوف أسدز إنفورمنت ستيت ليفز سيريا ريفن باي بيتربيلس" (سقوط دولة المخبرين في عهد الأسد ترك سوريا ضحية التوجس) التي نشرت في مايو سنة 2025، والتي تناولت فترة ما قبل سقوط الأسد، يرِد الحديث عن بلاغاتٍ رفعها معلمون سوريون بعد أن أفصح طلابهم عما سمعوه في منازلهم. أدّت تلك البلاغات إلى اعتقال أهالي هؤلاء الطلاب وتغيّبهم عن المدرسة.
وبيَّنَ تحليل المركز السوري للعدالة والمساءلة أن هذه الممارسة لم تقتصر على المجتمع، بل امتدت إلى داخل الأجهزة الأمنية نفسها. فقد وُثّقت حالات تجسّسٍ متبادلٍ بين الفروع الأمنية المختلفة. ويخلص التقرير إلى أن هذه السياسات عزّزت الخوف والانقسام داخل المجتمع السوري، وجعلت من الوشاية أداة قمعٍ مؤسسية. وبسبب تعسف النظام في التعامل مع التبليغات، تحولت الوشايات من إبلاغيةٍ أمنيةٍ إلى كيديةٍ وأداةٍ لتصفية الحسابات وتوريط الأبرياء. يشير التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب لبلاغات المخبرين حتى في حالات تقديم معلوماتٍ ملتويةٍ وغير منطقيةٍ، ولم تكن تحقّق في الموضوع. وكانت الإستراتيجية المتّبعة هي الاعتقال الفوري ومن ثمّ طرح الأسئلة لاحقاً.
مع استفحال الحالة أصبح كاتب التقرير نموذجاً اجتماعياً مألوفاً. ولعلّ شخصية "عادل الفسّاد"، التي ابتدعها الكاتب ممدوح حمادة في المسلسل الفكاهي الساخر "ضيعة ضايعة" الذي بثّ بين عامَيْ 2008 و 2010، من أبرز الشخصيات الثقافية التي جسدت هذه النموذج. تدور أحداث المسلسل في قريةٍ افتراضيةٍ في ريف اللاذقية، حيث اعتاد "عادل" (قام بدوره الممثل عبد الناصر مرقبي) التجوال في القرية بعيونٍ شاخصةٍ وآذانٍ متربصةٍ بأحاديث الناس، محوّلاً اليومياتِ العاديةَ إلى تقارير أمنيةٍ تعرَض كما لو كانت مؤامراتٍ ضدّ الدولة. وعند كلّ وشايةٍ يقف عادل بقامةٍ منتصبةٍ ونظرة فخرٍ، بينما تُعزَف في الخلفية موسيقى وطنيةٌ، في مشهدٍ يصوّر الواشيَ واهماً بأنّه بطلٌ قوميّ.
يتحدَّث المهندس السوري عبد الحميد البالغ خمسة وستين عاماً للفِراتْس عن "عادل الفسّاد" الذي عرفه شخصياً في نقابة المهندسين بمدينة حلب. وهو اللّقب الذي أطلقه الموظّفون هناك على أحد زملائهم بعد أن اشتهر بمراقبتهم ورفع تقارير دوريةٍ عنهم إلى مسؤولين أمنيين. بناءً على تجربته في العمل بعدّة منشآتٍ حكوميةٍ – كان مديراً في بعضٍ منها – يؤكّد عبد الحميد أنّه في كلّ مؤسسةٍ سوريةٍ يوجد "عادل فسّاد" أو أكثر يتمتعون بالحصانة والامتيازات بعد إثبات ولائهم للسلطة بتقاريرهم. وفي الغالب هم شخصياتٌ غير محبّبةٍ يتجنّبهم العاملون ويتوخّون الحذر منهم.
ولكن حسب الأكاديمية نفسها، يُعاب هذا النموذج بأنه قد يفضي إلى تقييماتٍ غير دقيقةٍ ومدخَلاتٍ غير بنّاءةٍ أو غير كافيةٍ، بالإضافة إلى تأثّر التقييم بالتحيّزات الاجتماعية. يتحول تقييم الزملاء من تبليغٍ موضوعيٍ إلى وشايةٍ كيديةٍ، كما حدث في قصة المعلمات حين كان تبليغ إحداهنّ على الأخريات محض افتراءٍ لدوافع شخصيةٍ، كما أحُيل لنا من شهود. ويضاف إلى عيوب النموذج أن السماح للزملاء بتقييم بعضهم بعضاً قد يخلق حالةً من الارتياب بين أعضاء الفريق ويُسبّب صراعاتٍ وعداواتٍ فيما بينهم.
وفي حالاتٍ أخرى وتبليغاتٍ أشدّ حساسيةٍ قد تتحول الصراعات والعداوات بعد التقييم السلبي – حتى إن كان واقعياً – إلى عمليّاتٍ انتقاميةٍ من المبلغين. كما حدث مع أبي إبراهيم، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنيةٍ، وهو سوريٌ تجاوز السبعين من عمره.
يقصّ أبو إبراهيم للفِراتْس حكايته التي جرت أحداثها منذ أكثر من عشرين عاماً بين جدران إحدى المؤسسات الحكومية السورية التي كانت تغزوها شبكات الفساد بمباركةٍ من كبار المسؤولين. فبعد أن تسلّم أبو إبراهيم منصب المدير المالي لتلك المؤسسة في مدينة حلب، بدأ مشواره بنجاحٍ صادقت عليه الثناءات والمكافآت التي حصدها. بدأت مثاليّةُ الحالة تنحسر حين حاول رئيس لجنة المشتريات رشوته مراراً بشكلٍ غير مباشرٍ، إذ عرض عليه مبالغ ماليةً كبيرةً تحت مسمى "هدايا" أو "عيديّة" في الأعياد. رفض أبو إبراهيم عطايا رئيس اللجنة تكراراً وأكّد له أنه يتلقى راتبه من الدولة فحسب.
تبيّن لاحقاً أن محاولة إغداق الهدايا عليه كانت استدراجاً لإدخاله في شبكة فسادٍ بدايتها رئيس اللجنة ولا يُعلم نهايتها. فقد اكتشف أبو إبراهيم تلاعباً في الفواتير المالية وتدوين مبالغ كبيرةٍ تحت بند مصاريف لإصلاح مراكب وآليّاتٍ تفوق أسعارَ الآليّات الجديدة. قدّم أبو إبراهيم تقريراً لمدير الفرع يكشف فيه عن التلاعبات المالية ليردّ عليه المدير: "لماذا تخبرني بذلك؟"، وليعلم أنّه كان كمن يستنجد بالذئب لحماية القطيع.
انكشفت التلاعبات ودوّى ضجيج الفضيحة إلى حدٍّ جعل التحقيق الأمني في الواقعة أمراً حتمياً. وفي التحقيق أدلى أبو إبراهيم بشهادته وقدّم الوثائق المطلوبة، ولكن النتيجة كانت التستر على الضالعين الكبار وتقديم مدير لجنة المشتريات للمحاكمة ومن ثم حصوله على حكمٍ مخفَّفٍ لتستّره على مدير الفرع والمتورطين ذوي النفوذ.
عكّر أبو إبراهيم صفوَ السارقين الكبار، فعوقب على إبلاغه برَكْنِه جانباً في موضعٍ لا صوت له فيه. ومن مديرٍ ماليٍّ في موقعٍ مفصليٍّ يتناسب مع مؤهلاته، تحوّل إلى موظفٍ إداريٍ يقوم بمهامّ يوميةٍ مكررةٍ وينتظر موعد التقاعد متجنباً المواجهة والسؤال عن سبب تهميشه لضمان سلامته وخوفاً من انتقامٍ أشدّ. وعلى الرغم من مرور سنواتٍ طوالٍ على الواقعة، ما زال شعوره بالظلم مستمراً. وحتى بعد تقاعده ضربت أبا إبراهيم الحسرة حين قال للفِراتْس إنّ البديل الذي جاؤوا به كان أقلّ خبرةً وكفاءةً منه.
إذ تشير بيانات مؤشراتِ الحوكمةِ العالميةِ الصادرة عن البنك الدولي إلى ضعفٍ شديدٍ في السيطرة على الفساد في سوريا تحت سلطة نظام الأسد. إذ سجّلت سوريا في مؤشر "التحكم في الفساد" سنة 2023 معدلات فساد مرتفعة. يعكس المؤشر مستوىً مرتفعاً جداً من استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصيةٍ في سوريا، سواءً عبر أشكال الفساد الصغيرة أو الكبرى. ويتّسق هذا التقييم مع نتائج مؤشر مدرَكات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، والذي منح سوريا في تقرير سنة 2024 درجة 12 بالمئة فقط، لتحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولةً بين أكثر الدول فساداً عالمياً.
وعلى الرغم من غياب دراساتٍ أحدث تقيّم وضع المؤسسات بعد سقوط الأسد، قد تبقى مؤشرات الأعوام السابقة دليلاً على الحاجة الملحّة لتعزيز مكافحة الفساد. فالأسد رحل عن سوريا، لكن كثيراً من الفاسدين بقوا فيها. فوفق تقريرٍ للقناة الثانية بتلفزيون سوريا في أغسطس 2025 اعتمد شهاداتٍ ميدانيةً، فإن موروث الفساد الذي رسّخه النظام السابق لا يزال قائماً في بعض أوجهه في مؤسسات الدولة السورية والحياة العامة. عرض التقرير تجارب أشخاصٍ، منهم من اضطرّ إلى دفع رشوةٍ للحصول على مساعدة قوى الأمن، وآخَر من أجل تسهيل استصدار صكّ براءة ذمّةٍ لعقارٍ تجاريٍ استأجره. ويشير التقرير نقلاً عن مختصين بالشأن القانوني، منهم المحامية عهد قوجة، بأن منظومات الفساد بعد سقوط الأسد عادت لتشكيل نفسها لتوائم الظروفَ الجديدة. وأضافت قوجة لموقع تلفزيون سوريا بأن مكاتب الشكاوى التي استُحدِثَت في عهد ما بعد الأسد ما زالت شكليةً ومحدودة الفاعلية، مشيرةً أيضاً لعدم وجود "ثقافة الشكاوى" لدى كثيرٍ من المواطنين.
وقد يُنسب هذا إلى الإرث الثقيل من البلاغات الأمنية والوشايات الكيدية التي تورطت فيها المؤسسات عقوداً، إذ استُخدِم الإبلاغ أداةً لتصفية الحسابات الشخصية. كذا فإن غيابَ آليّاتٍ إداريةٍ فعالةٍ للتحقق من المعلومات المقدمة وغيابَ الإجراءات الحمائية، جذّر هذا الإرث أكثر فأكثر.
لهذا السبب يبدو منطقياً أن تبدأ مكافحة الفساد داخلياً بمنح الصوت للمبادرين في كشف الانحرافات وحمايتهم من أي عملياتٍ انتقامية. فانتقام السلطة من أبي إبراهيم اقتصر على تبديله من موقعه وسلبه الوظيفة التي استحقها بعد سنواتٍ من الخدمة. لكن في حالاتٍ أخرى لا يمكن التنبؤ بمقدار الأذى الذي قد يلحق بالمبلّغين، خصوصاً حين يعني كشف التجاوزات الاصطدامَ مع أطرافٍ متنفّذة.
إبان سنوات الفصل العنصري التي بدأت في 1948 حين صار الفصل المادّي بين السلطة البيضاء الحاكمة وغالبية أبناء عرقيات البلاد الأصلية من السود سياسةً رسميةً، غرقت جنوب إفريقيا في ممارساتٍ إداريةٍ فاسدةٍ حابت وعزّزت قبضة سلطة الفصل العنصري والمقربين منها. وبالمحصلة شجعت هذه الممارسات مباشرةً أو بشكلٍ غير مباشرٍ أهلَ البلاد للتماهي مع منحى السلطة وركوب الموجة لغرض المعيشة والحصول على شيءٍ من الامتيازات. تمثلت أوجه الفساد الإداري مثلاً في تلاشي الحدود بين المال وأقطابه والسلطة، وتصميم آلياتٍ حكوميةٍ سرّيةٍ لإخفاء الفساد أو المستفيدين منه وحصر أغلب المنافع في الأقلية البيضاء. وكانت أبرز مظاهر هذا الفساد "من فوق" ما عُرف بِاسم "فضيحة مولدر غيت" في نهاية السبعينيات. إذ افتُضِح أمر استخدام الحكومة أموالاً عامةً لتمويل حملاتٍ إعلاميةٍ وسياسيةٍ لغاية شرعنة ممارسات الفصل العنصري في البلاد.
عقودٌ من الفساد أورثت حملاً ثقيلاً على جنوب إفريقيا استمرّت تداعياته بعد نهاية حقبة الفصل العنصري. وعلى الأثر وبعد سنواتٍ من استفحال الفساد بدأت تولَد تشريعاتٌ لتشجيع التبليغ على الفساد وحماية المبلّغين من أيّ عملياتٍ انتقامية. تمثل التحفيز على الإبلاغ بسنّ قانون الإفصاح المحميّ سنة 2000. وهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص من خلال توفير إطارٍ قانونيٍ للموظفين للإبلاغ عن أيّ سلوكٍ غير قانونيٍ أو غير نظاميٍ من أصحاب العمل أو زملائهم دون خوفٍ من الانتقام.
بعد سنواتٍ واجه القانون انتقاداتٍ لقصوره في حماية المبلغين وضآلة الحماية المضمونة لهم. فبينما ضمن التشريع الحمايةَ من الانتقام في مكان العمل، كان الانتقام الخارجي من المخبرين عن المخالفات أمراً شائعاً. وكان المبلغون يتعرضون لخطر التشهير والأذى المالي والتهديدات بالقتل وحتى الاغتيال. لذلك مُرر تعديلٌ على قانون الإفصاحات المحمية سنة 2017 يوفر حمايةً أكبر مع توسيع نطاق الحماية ليشمل الموظفين السابقين والعاملين المؤقتين والمنقولين، وألغى بنود السرية في العقود إذا كانت تعيق حقّ الإبلاغ. كذلك منح حصانةً من الدعاوى الجنائية أو المدنية للمبلغين بحسن نيةٍ غير المتواطئين في المخالفة، وأتاح إمكانياتٍ أوسع للإفصاح خارج جهة العمل في حال الخوف من الانتقام أو إخفاء الدلائل.
ومع ذلك، ما زال القانون يمرّ بمراحل متواصلةٍ من السعي للتعديل، إذ تُناقَش حالياً مقترحاتٌ إصلاحيةٌ جديدةٌ تهدف إلى توسيع نطاق الحماية لتشمل التهديدات خارج بيئة العمل، وتعزيز سرّية الإفصاحات، وتأسيس آليّات دعمٍ قانونيٍ وأمنيٍ أكثر صرامةً للمبلغين وفقاً لما جاء في تقريرٍ صادرٍ عن المنصة الإفريقية لحماية المبلغين في مايو سنة 2025 .
وعلى ما في القانون من فجواتٍ، يشير التقرير نفسه إلى أن تشريع الإبلاغ عن المخالفات في جنوب إفريقيا يُعدّ من بين أقوى التشريعات وأكثرها تقدماً في إفريقيا. إذ يُظهر مسحٌ سريعٌ لتأثير تشريعات المبلِغين عن المخالفات على مدى العقد الماضي أنها أداةٌ أساسٌ في مكافحة الفساد والاحتيال في جنوب إفريقيا، وخاصةً على المستوى المؤسسي. أيْ أنه وإن شابَهُ شيءٌ من القصور وحاقت ببعض جوانبه الفجوات، يظلّ يتطور ليصبح أداةً تساهم بقدرٍ بيّنٍ في تقليل الفساد المؤسسي بتسهيل سبل رصده والإبلاغ عنه، لا وشايةً بالمعنى التقليدي بل ضمن إطارٍ قانونيٍ حامٍ.
وتنسجم النتيجة السلبية المترتبة على قانون الإفصاح المحميّ في جنوب إفريقيا مع الدراسات الإدارية، بالعودة إلى نموذج "التعقيب بزاوية 360 درجة" يُعاب هذا النهج بأنه يفتح الباب لتحيزاتٍ اجتماعيةٍ وتقييماتٍ غير موضوعية. لذلك يعدّ معيار المساءلة واحداً من المعايير الأساس لإنجاح عملية تقييم الأداء الشاملة، إذ يجب أن يكون مدوّن الملاحظات مسؤولاً عنها. وهذا ما صنعَتْه جنوب إفريقيا استجابةً للآثار السلبية للقانون، فعدّلَتْه بإضافة مادّةٍ تنصّ على أن الموظف يرتكب جريمةً إذا تقدّم عمداً بإفصاحٍ زائفٍ وهو يعلم أن المعلومات خاطئةٌ، أو كان حريّاً علمُه بزيفِها، وكان مبيّتاً النيّةَ لإلحاق الضرر بالمبلّغ عنه الذي تضرر فعلاً نتيجة الإفصاح. وإذا ثبتت الإدانة، فقد يواجه الموظف غرامةً أو السجنَ لمدّةٍ تصل إلى سنتين أو كليهما.
فقد كان عبد الحميد مديراً لما لا يقلّ عن مئتين وخمسين موظفاً في إحدى المؤسسات المهنية الحكومية في عهد نظام الأسد. يقول للفِراتْس إنه حارب الوشايات الكاذبة عبر التحقق الدقيق من البلاغات حرصاً على عدم ظلم الموظفين، إضافةً لتعزيز فكرة أنّ "الولاء بالوشاية" لا يمكن أن يثمر عن أيّ امتيازاتٍ في مؤسسته، ليقطع بذلك الطريق أمام الوشاة. وبذلك تكون العدالة التنظيمية متمماً أساساً لجميع القواعد المكتوبة وصمام الأمان لبيئات عملٍ صحيةٍ، وتحقيق الإنصاف في ظل قصور القوانين ومحدوديتها. ففي قصة المعلمات، المشكلة لم تكن فقط في ضعف التشريعات التي تجرّم الوشايات الكيدية، بل في غياب منظومة عدالةٍ داخليةٍ كان يمكن أن تعالج الموقف في بدايته، وتمنع تطوّره إلى قرار فصلٍ تعسفيّ.