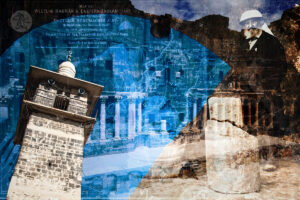غير أنّ تصوف الرومي والتبريزي، وغيرهما من المتفلسفة في الروحانيات، ليس سوى وجهٍ من وجوه التصوف. وقد ظهر منذ القرن الثالث عشر نمطٌ آخَر هو الطرق والزوايا، التي تحول فيها التصوف حركةً اجتماعيةً، فيها شيخٌ وأتباعٌ ومؤسساتٌ وأموالٌ وأنشطةٌ متعددة. واشتبكت هذه الطرق الصوفية الناشئة بالسلطة والحكم ولم تزل مستمرةً إلى الآن.
سرعان ما انتشرت الطرق الصوفية في شمال إفريقيا، حتى صارت شكلَ التديّنِ المهيمِنَ في ربوع المغرب الكبير. ومع صعود الدولة القومية بعد الاستقلال، دخلت المغرب والجزائر سباقاً على الزعامة الإقليمية، فسخَّرتا الرموزَ الدينية والزوايا الصوفية سلاحاً دبلوماسياً موازياً. وبهذا تحوّل التصوف، الذي عرف رموزاً نَأَت بنفسها عن السياسة في بداياته، إلى إحدى جبهات الصراع المستمر بين البلدين حتى اليوم.
لكن هذا الطابع الروحاني الخالص لم يلبث أن تطوّر إلى بنيةٍ مؤسسية. إذ بدأت الزوايا تعليمَ القرآن والفقه، وصار لها أوقافٌ وأراضٍ ومحلاتٌ تجاريةٌ تموّل نشاطها، وتحمّلت مسؤولية تأمين القوافل والقبائل، حسب ما جاء في كتاب "مؤسسة الزوايا" للكاتب المغربي محمد ضريف، المنشور سنة 1994. ومع أفول سلطة الدول المركزية في المغرب الكبير، مثل المرينيين والوطاسيين في المغرب وبني زيان في الجزائر بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر، تمددت الزوايا الصوفية لتملأ الفراغ السياسي والاجتماعي. وأضحت تؤدي أدواراً متزايدةً في الوساطة بين القبائل، ونشر التعليم الديني، وتقديم الخدمات والإعانات للفقراء والمسافرين.
تعاظم نفوذ الزوايا حتى صارت كياناتٍ سياسيةً قائمةً بذاتها. ففي المغرب، نافست الزاويتان الجزولية والدلائية سلطةَ المخزن، حسب ما ذكره الكاتب محمد حجي في كتابه "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي" المنشور سنة 1988. وفي الجزائر، لعبت الزاويتان التيجانية والرحمانية أدواراً محوريةً في ضبط القبائل وتنظيم ولاءاتها وفي حلّ النزاعات وتقديم الخدمات استناداً للشرعية الروحية التي تتمتعان بها، حسب ما جاء في أطروحة الماجستير المعنونة "الزوايا والطرق الصوفية ودورها في مواجهة الاستعمار الفرنسي بالجزائر خلال القرن العشرين – الطريقة الرحمانية أنموذجاً" التي قدّمتها الطالبتان بشرى ومريم شابو إلى قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجزائر سنة 2020.
استمرت الزوايا الصوفية في شمال إفريقيا قروناً تؤدي دوراً حيوياً، يحافظ على استقرار المجتمع والحكم جميعاً. في الجزائر مثلاً، دعمت الزوايا الزيانيين في مواجهة الإسبان والبرتغاليين حين هجموا على السواحل الأطلسية في بدايات القرن السادس عشر . وجاء في بحث "ذا ستاتس آند رول أوف ذا ماراباوت إن بريبروتكتوريت موروكو" (مكانة الزاوية ودورها في المغرب قبل عهد الحماية) الذي كتبته الأمريكية إلين سي هاغوبيان سنة 1964 أن "الوحدات السياسية الأقوى والأكبر، التي كان يقودها الأولياء [المرابطون أو الزوايا] استخدمت الجهاد لمواجهة التوغلات البرتغالية والإسبانية". وفي المغرب، دعمت الزوايا والطرق الحكامَ الوطاسيين ضدّ الأيبيريين في منتصف القرن السادس عشر. لكن هذا لم يكن دعماً مطلقاً للحكام. بل تمرّدت الطرق والزوايا عليهم عند خروجهم عن قواعد العدل، على نحوٍ تجلّى في تمرّد بعض الطرق على الحكم العثماني في الجزائر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
تغيّرت أوضاع الطرق الصوفية خلال الحقبة الاستعمارية. بدأ الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 واستمر حتى الاستقلال سنة 1962. أما المغرب ففرضت عليه الحماية الفرنسية والإسبانية بموجب اتفاقية فاس سنة 1912، وحصل على استقلاله سنة 1956. خلال فترة الاستعمار في البلدين، تسارع التحضّر والهجرة إلى المدن، بعيداً عن أماكن نفوذ الطرق والزوايا التقليدية في القرى والبوادي، وبرزت في الحواضر تياراتٌ إصلاحيةٌ عزّزت التعليم النظامي وانتقدت كثيراً من ممارسات الزوايا وعدّتها بدعاً وخرافات. أدّى هذا لتراجع نفوذها التقليدي نسبياً لصالح أنماطٍ حضريةٍ من التدين والتنظيم الديني. ومع ذلك، أعادت بعض الطرق تموضعها في الفضاء الحضري وواصلت تأثيرها بوسائط جديدة.
في بداياته في منطقة شمال إفريقيا، أدّى التصوف دوراً مهماً في تعزيز الروابط بين المغرب والجزائر، مستنداً إلى الجذور المشتركة للطرق الصوفية في البلدين. يورد الباحث محمد الصالح طيباوي، في أطروحته "الزوايا والطرق الصوفية وأثرها في العلاقات بين الجزائر والمغرب الأقصى خلال عهد الدايات (1671 – 1830م)" المنشورة سنة 2024، نماذج تاريخيةً توضح هذا الدور. أبرزها الطريقة التيجانية التي تأسست في الجزائر أواخر القرن الثامن عشر، وأسهمت في توطيد العلاقات الثنائية عبر الصلة الوثيقة التي نشأت بين مؤسسها الجزائري أحمد التيجاني وسلطان المغرب المولى سليمان في بدايات القرن التاسع عشر.
أدرك السلطان، المعروف بموقفه الحازم ضد ما عدّه بدع بعض الممارسات الصوفية ومواسمها، الأهمية السياسية للطريقة التيجانية. يقول الكاتب فينسنت ج كورنيل في كتابه "ريلم أوف ذا ساينت: باور آند أوثورِتي إن موروكن صوفيزم" (سلطان الوليّ: القوة والسلطة في التصوف المغربي) المنشور سنة 1998، إن "المولى سليمان كان حريصاً على تنقية الممارسات الدينية من البدع، لكنه مع ذلك حافظ على علاقاتٍ سياسيةٍ مع كبار الشخصيات الصوفية، وعلى رأسهم أحمد التيجاني". بعدها وصل مؤسس الطريقة التيجانية من الجزائر التي كانت آنذاك إيالةً عثمانيةً إلى المغرب.
هذا التقارب بين السلطان المغربي والشيخ التيجاني أثار قلق حكام الجزائر العثمانيين، الذين رأوا فيه مؤامرةً سياسيةً تُدبَّر ضدهم من جانب المغرب، فشدّدوا الرقابة على أتباع الطريقة التيجانية وعدّوا حركتها أكبر التهديدات لوجودهم في الجزائر. يقول جون هنوِك جون في "إنترودكشن: إسلاميك أفريكا آند ذا ستدي أوف إسلاميك سوسايتيز ساوث أوف ذا سهارا" (مقدمة: إفريقيا الإسلامية ودراسة المجتمعات الإسلامية في ما وراء الصحراء الكبرى)، المنشورة سنة 1999 في مجلة "إسلاميك أفريكا" (إفريقيا الإسلامية) إن "ولاء الطريقة التيجانية للسلطة المغربية أثار قلق حكام الجزائر العثمانيين، الذين رأوا فيها أداةً محتملةً لتأثير المغرب السياسي".
لم يدم هذا النموذج الذي يجسّد توظيف الزوايا أداةً للتقارب المغاربي. فبعد استقلال البلدين عن الاستعمار الفرنسي تغيّر المشهد، ونظر البلدان إلى التصوف باعتباره أداةً فكريةً لمدّ نفوذ الدولة خارج حدودها، والتوسع في مجالاتها الحيوية. فقد أسهم التصوف المغاربي تاريخياً في نشر الإسلام بإفريقيا جنوب الصحراء، مما مكّن المغرب والجزائر من مدّ نفوذهما الروحي والسياسي إلى ما وراء الصحراء الكبرى بالاستناد لهذه الطرق.
دخل الإسلام إلى غرب إفريقيا عبر المغاربيين بحكم روابط الجوار والتواصل المستمر. كذلك فإن موقع المغرب الأقصى، قطباً تجارياً ومحطةً رئيسةً للقوافل العابرة نحو إفريقيا، أسهم في ترسيخ حضوره الديني والثقافي جنوب الصحراء. وهكذا نشأ الإسلام الإفريقي متأثراً بنظيره المغاربي، الذي كان بدوره مشبعاً بالتصوف. وتبنّت مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء طرق أهل المغرب من خلال تلاميذ عبد السلام بن مشيش وأبي الحسن الشاذلي، فانتشرت الرباطات والزوايا في السنغال ومالي ونيجيريا وتشاد والسودان، وجذبت أعداداً كبيرةً من الأتباع.
ويشير استطلاعٌ أجراه مركز "بيو" للأبحاث سنة 2012 إلى قوة الحضور الصوفي في إفريقيا جنوب الصحراء. ففي السنغال مثلاً يصرّح نحو 92 بالمئة من المسلمين بالانتساب إلى طريقةٍ صوفية. ولا يختلف الوضع في البلدان المجاورة، إذ ينتمي نحو 35 بالمئة من مسلمي تشاد ونحو 34 بالمئة من مسلمي النيجر إلى طرقٍ صوفية.
ينتمي معظم مسلمي هذه البلدان لثلاث طرقٍ كبرى هي القادرية والتيجانية والمريدية. وتتوسع عالمة الإناسة فابيان سمسون في هذا التقسيم، في مقالٍ لها بعنوان "لوسوفيزم أون أفريك دولويست" (الصوفية في غرب إفريقيا) نشر سنة 2017. إذ تشير إلى أنّ الطريقة القادرية، التي تأسست في القرن الحادي عشر ببغداد، كانت من أوائل الطرق الصوفية التي رسخت حضورها في غرب إفريقيا. غير أن الطريقة التيجانية، التي نشأت في المغرب العربي خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هي التي أدّت الدور الأبرز في القرن التاسع عشر إذ رافقت عملية التحول الجماعي للأفارقة إلى الإسلام، لتصبح لاحقاً من أكثر الطرق الصوفية انتشاراً في العالم. وبحسب استطلاع مركز بيو سالف الذكر، ينتمي نحو 51 بالمئة من منتسبي الطرق في السنغال للتيجانية.
أما في الجزائر، استخدم الرئيس أحمد بن بلّة، أول رئيسٍ للجزائر بعد الاستقلال والذي حكم بين سنتَيْ 1963 و1965، وخلفه الهواري بومدين الذي حكم بين سنتَيْ 1965 و1978 الزوايا لدعم مشروع الدولة في مواجهة بعض التيارات الإسلامية المنافِسة. ولعبت الزوايا دوراً في دعم خطاب الدولة في الجزائر ضدّ الجماعات المسلحة خلال ما عرف باسم "العشرية السوداء" التي شهدت مواجهاتٍ مسلحةً بين الدولة والإسلاميين في أعقاب فوزِ جبهة الإنقاذ الإسلامية بالانتخابات التشريعية سنة 1992 وحلِّ البرلمان. ومنح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي رأس الجزائر بين سنتَيْ 1999 و2019، مكانةً خاصةً للزوايا، ودعا شيوخَها علناً مقابل دعمهم سياساته الانتخابية. يقول الكاتب عبد القادر جغلول في كتابه "لي زوايا أون ألجيري" (الزوايا في الجزائر) المنشور سنة 2014 أنه "في عهد بوتفليقة، أعيد الاعتبار للزوايا بوصفها شريكاً سياسياً للسلطة، وعُبّئت لدعم الانتخابات وسياسة المصالحة الوطنية".
ولم يلبث أن تحول التصوف من فضاءٍ للتقارب بين المغرب والجزائر إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للتنافس بين دولتين تريد كلٌّ منهما تمثيل التصوف المغاربي وتوظيفه في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. ويقول المحلل السياسي الجزائري بلغربي عبد الملك في حديث مع الفِراتْس، إن سنة 1999 كانت سنةً فاصلةً في هذا الإطار إذ وصل بوتفليقة للحكم في هذه السنة. ومع انتهاء "العشرية السوداء"، وجد نفسه في محيطٍ إقليميٍ وقارّيٍ مضطربٍ، تحيط به جماعاتٌ إسلاميةٌ مسلّحةٌ ومتشدّدة ورأى في التصوف أداةً إستراتيجيةً للحدّ من تمدّد هذه الجماعات. وظّفت الجزائر الزوايا لتعزيز حضورها في محيطها الإفريقي، باعتبارها حواضن روحيةً واجتماعيةً يمكن أن توازن خطاب التطرف وتحصّن المجتمعات المحلية منه. وفي المغرب، تولّى الملك محمد السادس السلطة خلفاً لأبيه الحسن الثاني بعد وفاته سنة 1999. فوضع الزعيمان الجديدان إفريقيا في قلب سياستهما الخارجية. وسعى كلّ طرفٍ لكسب تأييد الدول الإفريقية في النزاع على الصحراء الغربية. وبينما هيمن المحدد الأمني على السياسة الإفريقية للجزائر، طغى نزاع الصحراء على سياسة المغرب الإفريقية.
اختلفت الأدوات التي استعملها كلّ بلدٍ في تحقيق أهدافه. يقول بلغربي إن الجزائر مالت في أول الأمر لتوظيف الوسائل الدبلوماسية السلمية، مثل الوساطة في حلّ النزاعات، مع تبنّي موقفٍ صارمٍ من دفع الفدية للجماعات المسلحة. واعتمدت أيضاً آلياتٍ اقتصاديةً وتنمويةً مثل مبادرة "النيباد" (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا) التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2001. في المقابل، اعتمدت المملكة المغربية مقاربةً تمزج الحضور العسكري عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام أو النزاعات الإفريقية، وتوسيع الاستثمارات والتجارة، إلى جانب إيلاء مكانةٍ خاصةٍ لتفعيل دور الزوايا والطرق الصوفية في القارة.
سرعان ما أدركت الجزائر جدوى ما يسمى "الدبلوماسية الدينية" أو "دبلوماسية الزوايا"، فزاحمت المغرب عليها. يقول بلغربي إن الجزائر وظّفت تاريخها باعتبارها مهد الطرق الصوفية الكبرى. فالطريقة التيجانية مثلاً انطلقت من عين ماضي قرب الأغواط في الجزائر، حيث وُلد مؤسسها الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني، قبل أن تنتشر في أنحاء واسعةٍ من إفريقيا. وبحسب بلغربي، تحاول الجزائر إحياء الطقوس التيجانية، على نحوٍ تجلّى في تنظيمها مؤتمراً دولياً في 2006، جمعت فيه الإخوان التيجانيين من كلّ أنحاء العالم باستثناء المغرب. سلّط هذا الموقف الضوءَ على الأدوار الدينية والدبلوماسية للتيجانيين المغاربة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
سعت الجزائر منذ بداية الثمانينات إلى تنظيم الملتقى الدولي الأول للتيجانيين. غير أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني أرسل وزيره للأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري في جولةٍ إفريقيةٍ دامت شهراً، حثّ خلالها شيوخَ الطريقة في البلدان المختلفة على مقاطعة الملتقى الجزائري. نجح الملك في مقصده، ثم ما لبث أن دعا المنتسبين للتيجانية إلى ملتقىً دوليٍ سنة 1986 في فاس، حيث ضريح مؤسس الطريقة. وفي الملتقى، ضغط على مشايخ التيجانية للاعتراف بمغربية الصحراء وإدانة موقف الجزائر منها. ونجح المغرب في سعيه.
لم تستسلم الجزائر لهيمنة المغرب على التيجانية، وواصلت محاولاتها لجمع أتباع الطريقة. ومع تولي بوتفليقة الرئاسة، زاد توظيف الصوفية، والطريقة التيجانية خاصة. دعم بوتفليقة الزاويا والطرق وقدم لها المساعدات المالية، محاولاً كسب تأييد ملايين المنتسبين للطريقة حول العالم، الذين يدينون بالولاء التامّ للخليفة العامّ للطريقة التيجانية الشيخ علي التيجاني.
مثلاً، استضاف المغرب في سنة 2023 واحداً وعشرين ألف طالبٍ إفريقيٍ، منهم ستة آلافٍ من دول الساحل. ويدعم المغرب الطرق الصوفية والمؤسسات الدينية من خلال "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة"، التي توزع المصاحف وتبني المساجد. ويساهم تنظيم المغرب برامج تبادل الأئمة مع دولٍ إفريقيةٍ متعددةٍ في تعزيز التقارب الدبلوماسي. وقد أكّد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لسنة 2022 على الدور الذي يؤديه معهد محمد السادس لتكوين الأئمة في نبذ التطرف.
تستند هذه الخطط للرمزية الدينية لمؤسسة الحكم في المغرب. فبالإضافة إلى الطابع الدبلوماسي والاقتصادي للزيارات الملكية إلى البلدان الإفريقية، تكتسب هذه الزيارات رمزيةً دينيةً خاصة. إذ يتحرك الملك لا بوصفه رأساً للدولة أو ملكاً فحسب، وإنما بصفته أميراً للمؤمنين. ويرافقه في الزيارات غالباً وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويرصد المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية ثمانياً وأربعين زيارةً للملك إلى الدول الإفريقية في خلال ثمانية عشر عاماً، تركزت بالأساس في غرب القارة. وفي هذه الزيارات، يلتقي الملك بعض مشايخ الطرق الصوفية، ويهديهم نسخاً من المصحف الشريف، ويرعى ترميم بعض المساجد وتدشين أخرى.
تحصد المغرب ثمار هذه المشروعات تأييداً من الطرق الصوفية والزوايا. وفي البلدان المختلفة، تشكل هذه المجموعات الصوفية جماعات ضغطٍ لفائدة المغرب في القضايا السياسية الكبرى، لاسيما قضية الصحراء الغربية. فكلّما تغير موقفٌ من المواقف لدى بعض الدول الإفريقية من هذه القضية لفائدة الجزائر أو جبهة البوليساريو كانت الجماعات الصوفية تتدخل بالضغط على حكوماتها لمراجعة موقفها ومناصرة المغرب. مثلاً، بعد سنتين من انسحاب المغرب من الإتحاد الإفريقي سنة 1986 بسبب نزاع الصحراء، نظمت وزارة الأوقاف بفاس ندوة الطرق الصوفية، وأنشأت "رابطة علماء المغرب والسينغال"، والتي ساهمت في كسر عزلة المغرب على المستوى القاري وإنعاش القنوات السياسية والدبلوماسية المنسدّة وجرّ اعترافاتٍ بموقف الصحراء.
يستند التفوق المغربي لانسجام النظام السياسي مع الدبلوماسية الدينية والروحية. فالملك، بنصّ الدستور المغربي، "أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين". وهو وريث عرشٍ يستمد شرعيته من البيعة. وبالتالي فهو مرتبطٌ بعلاقةٍ دينيةٍ وثيقةٍ مع عددٍ من الطرق والزوايا الصوفية بالمغرب وإفريقيا منذ زمنٍ طويل. في المقابل، تأسست في الجزائر بعد التحرير دولة قُطرية لم تعتمد الدِين أساساً في سياساتها الخارجية. بل اعتمدت "دبلوماسية البترول" لزيادة نفوذها، وانشغلت بدعم حركات التحرر الوطني، بلا تركيز على دور الروابط الدينية في السياسة الخارجية. ولم يتغير هذا الوضع إلا في القرن الحادي والعشرين بعد "العشرية السوداء" التي شهدت صداماً مسلحاً مع الإسلاميين. التفتت الحكومة الجزائرية حينها لأهمية الزوايا والطرق في مواجهة التيار الإسلامي الحركي.
تبوّأ المغرب مكانةً متميزةً لدى الشعوب الإفريقية بفضل نموذجه الديني الذي يجمع بين المذهب السنّي المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك الصوفي الجنيدي، كما يخلص بلغربي: "حتى أصبح حضور المغرب في بعض البلدان الإفريقية مرتبطاً بالمحدد الديني أكثر من أيّ محددٍ آخر". وتوضح الحالة المغربية لدارسي تنظيم الحقل الديني الظروف التي يمكن في ظلّها تحويل الطرق الدينية المصممة لإدارة الدين المحلي إلى الخارج، وتوظيفها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.