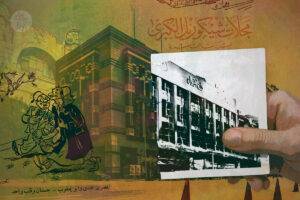عايشَت سوريا بين سنتَيْ 1980 و2025 موجات جفافٍ عدّة، لكن الموجة الحالية تبدو أشدَّها بأساً. فقد كان الجفاف في السابق موسمياً ومتقطعاً زمانياً ومكانياً، ولكن موجات الجفاف الأخيرة أضحت متواترةً وشاملةً المحافظاتِ السورية. ونُسب هذا إلى التغير المناخي، الذي جعل درجات الحرارة العالية أكثر شيوعاً واستمراريةً مقارنةً بالعقود الماضية. ومع تصاعد درجات الحرارة، زادت نِسَب تبخّر المياه السطحية وما نتج عنها من فاقدٍ مائيٍ ملحوظٍ، طال أغلب الأنهار والسدود على الأرض السورية.
وخلف نقاشات التغير المناخي وإحصائياته، باتت آثارُه الفعلية على الأرض معيشةً ضنكاً لكثيرٍ من الناس. إذ تلقي موجة الجفاف في سوريا اليوم بظلالها على الفلاحين ومالكي المواشي. وإن اختار بعضهم التكيّف مع الأزمة والبحث عن حلولٍ ولو كانت غير مستدامةٍ، وصل الأمر ببعضهم الآخَر حدّ الاستسلام لسطوة الطبيعة. تهدد هذه الأزمة الأمن الغذائي والاقتصاد السوري، وتؤثر سلباً على استقرار المجتمعات المحلية التي يعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية المواشي. وتتجلّى الكارثة مع أرقام العجز والتراجع المستمرة في الأمن المائي والغذائي والثروة الحيوانية، وتتعزز مع ضعف الدعم والاستجابة الحكومية أمام الأزمة الحالية، وعجز ميزانيتها عن تغطية آثار الدمار الممتدّ طيلة السنوات السابقة.
وحسب الدراسات المناخية، ومنها "دراوت فلنربلتي إن ذي أراب ريجن" ( قابلية الجفاف في المنطقة العربية) الصادرة سنة 2011، يقسَّم الجفاف إلى ثلاثة مستويات. الأول جفافٌ مناخيٌ، بمعنى كمّيات هطولاتٍ مطريةٍ أقلّ من المعدّلات الطبيعية. وقد انخفض معدّل الهطولات المطرية لموسم 2024 - 2025 مسجلاً أشدّ المواسم جفافاً منذ موسم 1958 - 1959، حسب ما أعلنت وزارة الزراعة السورية في مايو 2025. وتتضح قابلية سوريا للتعرض لأضرار الجفاف بسبب نقص الهطولات المطرية إذ علمنا أن المساحات الزراعية البعليَّة، أي المعتمدة حصراً على الأمطار، تقارب ثلاثة أضعاف المساحات الزراعية المروية. كذلك تمثل الهطولات المطرية الموردَ الرئيسَ من مصادر المياه المتاحة، ما يؤثر في وفرة سائر الموارد المائية الأخرى.
المستوى الثاني جفافٌ زراعيٌ مرتبطٌ برطوبة التربة اللازمة للزراعة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتبخر المياه واستنزاف التربة. وفي هذا السياق ذكرت مديرية الأرصاد الجويّة السورية في أبريل 2025 أن موسم 2025 يأتي في المرتبة الثالثة بعد موسمَيْ جفاف 2008 و2020 من حيث قلّة الغطاء النباتي، وهذا اعتماداً على مؤشر الاختلاف المعياري للغطاء النباتي. ويستخدم المؤشر لتحليل بيانات الاستشعار عن بعد، لا سيما التي تلتقطها الأقمار الصناعية، لتقييم حالة الغطاء النباتي وصحّته وكثافته في منطقةٍ ما.
أما المستوى الثالث فهو جفاف الموارد المائية على المدى الطويل، أو ما يعرف بالجفاف الهيدرولوجي. وينجم عن انخفاض الاحتياطات المائية الجوفية والسطحية إلى أقلّ من المتوسط الإحصائي. ساهم في ذلك ضخُّ السوريين حوالي 1.2 مليار قدمٍ مكعبٍ (34 مليون متر مكعب) من المياه الجوفية سنوياً، بمعدلٍ يتجاوز الكمية التي يمكن تجديدها، حسب تقريرٍ بعنوان "سيريا هاز أ واتر كرايسس" (أزمةٌ مائيةٌ في سوريا) للباحثَيْن أورورا سوتيمانو ونبيل سمّان، والذي نشره المجلس الأطلسي للبحوث سنة 2022. وقد تحدّث مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة السورية، سعيد إبراهيم، في مايو 2025 عن هذا الخطر، مشيراً إلى فقدان بعض المناطق نحو 70 بالمئة من مخزونها من المياه الجوفية.
اتبعت حكومات البعث المتتالية منذ توليها حكم سوريا في الستينيات سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والشعير والقطن والذرة وبنجر السكّر (الشمندر السكري). وتختلف تأويلات محركات هذه السياسة، إن كانت مدفوعةً بأسبابٍ عقديةٍ مرتبطةٍ بفكر البعث وقاعدته الريفية، أم لغاياتٍ اقتصاديةٍ بغية تأمين النقد الأجنبي أو توفيره. وكانت العاقبة أن استُنزِفت الموارد المائية السطحية والجوفية بفعل أساليب الريّ غير الفعالة والتوسع غير المدروس في المساحات الزراعية المروية.
زادت هذه المساحة من 625 ألف هكتارٍ سنة 1985 إلى مليونٍ وستمئة ألف هكتارٍ سنة 2010، حسب دراسة الباحث الاقتصادي السوري جوزيف ضاهر بعنوان "ندرة المياه وسوء الإدارة والتلوث في سوريا" التي صدرت سنة 2022. وفي الوقت نفسه لم ترْقَ السياسات الحكومية في عهد نظام الأسد إلى مستوى الاستجابة الفعالة للتحديات المرتبطة بالجفاف. فكانت خططاً طموحةً تفتقر للتمويل، كما في خطّتَيْ تحديث البنية التحتية للريّ سنة 2006 وبناء حوالي ثلاثمئةٍ وخمسين محطةً لمعالجة مياه الصرف الصحّي بين سنتَيْ 2010 و2015، بتكلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت ثلاثة مليارات دولارٍ أمريكي. ولم تجد تلك السياسات طريقها للتنفيذ، كما تشير دراسة ضاهر، بسبب تعدد الأطر المؤسساتية المسؤولة عن قطاع المياه والري والصرف الصحي، وغياب التنسيق بينها.
ولا ينتهي الأمر عند هذا، إذ تعاني سوريا من انكشاف أمنها المائي في ظلّ ارتفاع مؤشر التبعية المائية لديها مسجِّلاً 72.4 بالمئة. ويقيس هذا المؤشر نسبة الموارد المائية المتجددة النابعة من خارج البلد. على سبيل المثال، يعدّ نهر الفرات أهمَّ عصبٍ مائيٍ للبلاد، إذ يمثل حوالي 40 بالمئة من مجمل الموارد المائية السورية. ومع أن اتفاقية 1987 تنصّ على توفير تركيا، حيث منبع الفرات، ما لا يقلّ عن خمسمئة مترٍ مكعبٍ في الثانية من مياه الفرات للجانب السوري، لكن الكميات الفعلية المتدفقة في السنوات الأخيرة كانت أقلّ من نصف تلك الكمية المتفق عليها. ويبدو أن النهر سيبقى مساحةً للتفاوض أو مصدراً للنزاع، ما بين الادعاء بتقييد تركيا حصصَ جيرانها قصداً، والادعاء المضادّ أن انخفاض الكميات المتدفقة سببه الجفاف وانخفاض الهطولات المطرية، إلى جانب سوء الإدارة وأساليب الريّ القديمة.
ولم يسلم قطاع المياه والريّ والصرف الصحّي في سوريا من الدمار والتخريب عقب سنة 2011. إذ قدّر النظام السابق الخسائرَ بأكثر من مليار دولارٍ أمريكيٍ سنة 2023. هذا بالإضافة لتضرّر أكثر من 50 بالمئة من محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحّي، حسب ما ورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2025 بعنوان "ذي إمباكت أوف ذا كونفليكت إن سيريا" (أثر الصراع في سوريا). وهو ما يَحرم أكثرَ من نصف سكان سوريا من المياه.
في يناير 2025، قدّرت حكومة تصريف الأعمال السورية، التي شكّلتها المعارضة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حجمَ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه بمبلغٍ يتراوح بين خمسمئةٍ إلى سبعمئة مليون دولارٍ أمريكي. ولا يبدو أن هذا المبلغ متوفّرٌ لدى الحكومة السورية الحالية.
ومن منظورٍ أوسع، تُصنّف سوريا ضمن فئة الدول التي تعاني عجزاً مائياً، بسبب قصور الموارد المائية المتاحة. وفي دراسةٍ بعنوان "دراسة تحليلية لأسباب الاختلال في المسألة المائية السورية" نشرت سنة 2015، قدّر الباحثان حبيب محمود وكارول الصايغ العجز المائي في سوريا بين سنتَيْ 1992 و2012 بحوالي 1.256 مليار مترٍ مكعبٍ من المياه. سجّل العجز بعدها اتجاهاً تصاعدياً. وفي يونيو 2022 قدّر معاون وزير الزراعة في النظام السوري حينها أحمد قاديش العجزَ السنوي بحوالي ثلاثة مليارات مترٍ مكعبٍ من المياه.
ساهم ما سبق في انخفاضٍ حادٍّ في حصة الفرد السوري السنوية من الموارد المائية المتجددة. وبدءاً من سنة 2002 أمست سوريا من الدول التي تعاني الندرة المائية مع انخفاض حصة الفرد من المياه إلى أقل من ألف مترٍ مكعبٍ سنوياً. وفي يناير 2025، قال وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال السورية أسامة أبو زيد إن حصة الفرد من المياه بلغت نحو ستمئةٍ وثمانين متراً مكعباً فقط.
أتت موجة الجفاف الأخيرة وتزايد عدد السوريين العائدين بعد سقوط النظام السابق، لتضيف عبئاً آخَر يهدد الأمن المائي والغذائي في سوريا، إلى جانب الضغط على البنية التحتية المدمّرة. ولكن التأثير الأشدّ كان على العاملين في قطاع الزراعة وتربية المواشي.
أمّا من قرّر التكيّف، فقد تبنّى طيفاً من الخيارات والبدائل في التعامل مع موجة الجفاف، بعضها مستمدٌ من تجاربهم السابقة، والأخرى حصلوا عليها بما تيسر لهم من دعم المنظمات غير الحكومية. وقد التقى فريق الفِراتس رجالَ أعمالٍ ومزارعين ومربّي مواشٍ لاستكشاف طرقهم في مواجهة الأزمة.
يواصل عبد الرحمن، المزارع من جنوب إدلب، عملَه في الزراعة متّكئاً على دعمٍ وفّرته إحدى المنظمات غير الحكومية، ومكّنته من تخفيض النفقات بنسبة 30 بالمئة إثر توظيف تقنيات الطاقة البديلة والريّ الحديث. ومع ذلك لا يزال التحدي قائماً، فهو يضطرّ للحفر إلى عمقٍ يتجاوز خمسمئة مترٍ لضمان الوصول للمياه اللازمة لزراعته. ومع تراجع منسوب المياه الجوفية سيكون الوضع أعقد وأصعب للاستمرار، كما أشار.
لجأ بعض المزارعين إلى "تضمين" المحصول لأصحاب المواشي، ويعني ذلك السماحَ لأصحاب المواشي كي يُسِيموا مواشيهم في الأرض فترعى المحصولَ مقابل ثمنٍ مادّي. اختار هؤلاء المزارعون ترك الزراعة مؤقتاً لحين تحسّن الظروف المناخية أو توفّر الدعم اللازم، خصوصاً في مناطق مثل السهول الساحلية والهضبة الشرقية، وهي التي تقل فيها معدلات الأمطار عن مئتين وخمسين ميلمتراً سنوياً.
من هؤلاء المزارعين عبد الله، من الرقة، الذي لجأ إلى تضمين محصوله من القمح البعلي علفاً لمربّي المواشي مقابل عشرين دولاراً للدونم الواحد (الذي يساوي ألف متر مربع في بلاد الشام). في حين فضّل المزارع سعد في ريف إدلب الشرقي تركَ الزراعة مؤقتاً، فالموسم "مَحْلٌ لا خير فيه"، بعد خسارته ما يزيد عن أربعين مليون ليرةٍ سوريةٍ (نحو أربعة آلاف دولار أمريكي).
في المقابل لجأ المزارع حيّان من ريف حلب إلى زراعة مواسم متتاليةٍ على مدار السنة، بعد أن كان يزرع نصف أرضه ويترك الآخَر قبل سنة 2011. كانت هذه وسيلته للتكيّف وتعويض الخسائر التي قد تطال أحد المحاصيل. ومع أهمية تحليل التربة لمعرفة احتياجاتها وقدرتها على تحمل هذا النمط من الزراعة المكثفة، إلّا أنه لم يجد وحداتٍ إرشاديةً زراعيةً أو منشآتٍ تعمل على تحليل التربة، ولا قدرة مالية لديه لعمل هذه التحليلات بدون دعم. وما يشغل باله هو النجاة ولو آنيّاً من الجفاف، إذ يقول: "أنا مهتمٌ بتقليل خسائري لهذا الموسم، وغداً يفرجها الله".
لجأ بعض المزارعين كذلك إلى الاستدانة لتأمين مستلزمات محاصيلهم الزراعية على أمل إنقاذ مشاريعهم الزراعية الكبيرة، كما أخبرنا أحمد ريان من ريف حلب الجنوبي عن تجربته. قال أحمد "كنت أمام خيارَيْن، إما خسارة المحصول أو الاستدانة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصول القمح المرويّ. كانت الاستدانة خياري لتأمين ما بين مرّتين إلى ثلاث مرّاتٍ من ريّ محصول القمح، بينما يحتاج ستَّ إلى سبع ريّاتٍ كيْ يعطي الهكتار [عشرة آلاف متر مربع] أفضلَ إنتاجية. ومع ذلك لم يكن الإنتاج على مستوى المأمول هذا العام".
كان خيار آخَرين تغيير نوعية المحاصيل الزراعية، كما فعل المزارع عبد الرحمن في إدلب. إذ لجأ إلى زراعة الكمّون عوضاً عن القمح، باعتباره أقلّ استهلاكاً للمياه، وإن لم يُدِرّ ربحاً فعلى الأقلّ يغطي تكاليفه، كما قال.
أمّا مربّو المواشي فكانت قدرتهم على التكيّف أقلّ. فقد أدّى انخفاض الغطاء النباتي الذي يُستخدم مراعيَ طبيعيةً، إلى ازدياد اعتمادهم على الأعلاف الصناعية مرتفعة الأسعار. ومع ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية الضرورية، كانوا أمام المفاضلة بين خسارة القطيع كاملاً أو بيع الجزء الأكبر منه لتأمين نفقات ما تبقّى من القطيع. قال لنا فراس المحمد، أحد مربّي الماشية في ريف إدلب، إنه لم يقدر على توفير احتياجات قطيعه البالغ ألفاً وخمسمئة رأسٍ من الغنم: "اضطررتُ إلى بيع ثلثي القطيع بسعرٍ منخفضٍ، أيْ مئتي دولارٍ للرأس الواحد، لتوفير رأسمالٍ كافٍ لتأمين مستلزمات الثلث المتبقي". علماً بأن معدّل سعر الخروف الواحد في السوق كان مئتين وخمسين دولاراً حينئذ.
فرضت موجة الجفاف نفسها على المجتمعات الرعوية التي تكافح ما أمكنها للنجاة من الكارثة. يضطر الرعاة للتنقل مسافاتٍ بعيدةً بحثاً عن مراعٍ لمواشيهم. ومع انتشار مخلفات الحرب والألغام، ناهيك عن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في منطقة البادية، أصبحت مهنة رعي الأغنام شاقّةً ومحفوفةً بالمخاطر. قال لنا الراعي عيسى الغنام من بادية البوحمد في ريف الرقة الشمالي: "لا نملك بدائل إلا البحث عن مراعٍ جديدةٍ، مع الخطر العالي لذلك".
اتجه آخرون للعمل في قطاع التشييد والبناء أو افتتاح أعمالٍ خاصةٍ أو العمل في المؤسسات الحكومية بحثاً عن راتبٍ قليلٍ لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكنه الخيار الأخير المتاح. قال لنا المزارع أحمد من منطقة جبل الزاوية في إدلب، "مع صعوبة الزراعة وضعف جدواها الاقتصادية، لجأ الكثير من أبناء منطقتي في جبل الزاوية إلى العمل في المؤسسات الحكومية، وخصوصاً قوات الأمن العام".
أدّى ترك كثيرٍ من المزارعين العملَ في قطاع الزراعة إلى زيادة الأعباء على الأفراد العاملين فيها، فضلاً عن تغيّر أنماط العمل داخل الأسرة مع اضطرار النساء للعمل إلى جانب أزواجهن لتأمين مصاريف العائلة، أو الاعتماد على أفرادٍ آخرين من العائلة. قال لنا موظفٌ في منظمةٍ غير حكوميةٍ في الشمال السوري فضّل عدم ذكر اسمه: "أصبحتُ المعيلَ لعائلة والديّ إلى جانب أسرتي، بعد فشل الموسم الزراعي لأهلي. لا أعلم مدى قدرتي على الاستمرار في هذه النفقات المضاعفة".
كانت المدن الكبرى وجهة الباحثين عن فرصٍ أفضل بعد فشل مواسم الزراعة والرعي. تذكّر محمد من ريف الحسكة الجنوبي مشهد نزوح الآلاف من منطقته إلى المدن الكبرى خلال موجة الجفاف السابقة بين سنتي 2006 و2010، بعد أن اضطر إلى النزوح مع عائلته هذه السنة. قال محمد "يبدو أننا تُركنا نواجِه مصيرَنا وحدَنا مرّةً أخرى، ربما أجد فرصة عملٍ في حلب، أما في منطقتي فلَم يبْقَ سوى الفقر".
وكما فعل مربّي الماشية من إدلب، فراس المحمد، فضّل بعض مربّي المواشي بيع أبقارهم وأغنامهم كلّها بسعرٍ أقلّ، مع ارتفاع أسعار العلف إلى حدٍّ غير مسبوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر طنّ التبن من ستمئة ألف ليرةٍ سوريةٍ (نحو أربعين دولاراً) في صيف سنة 2024 ليصل إلى ثلاثة ملايين ليرةٍ سورية (نحو ثلاثمئة دولار) في ربيع سنة 2025. قال لنا عبد العزيز، أحد مربّي الأغنام في المنطقة الشرقية: "أصبحت تربية الأغنام خاسرةً، لم يعد بإمكاني تحمّل المزيد من الديون في مهنةٍ لم تعد مربحةً كما كانت".
لا تقتصر تداعيات ترك هؤلاء المزارعين ومربّي المواشي أعمالَهم على اقتصادهم الفردي والعائلي، فهي تؤثّر أيضاً على الأمن الغذائي في سوريا، وعلى استقرار المجتمعات المحلية المعتمدة على الاقتصاد الزراعي والحيواني.
تُبرِز هذه الأرقام حجمَ أزمة القطاع الزراعي، نتيجة قصور الاستجابة الحكومية، وانسحاب الدولة التدريجي من دعم هذا القطاع وما طاله من دمارٍ منذ سنة 2011. لتزيد موجات الجفاف المتلاحقة تحدّياتِ إنعاش الأمن الغذائي وصيانته في سوريا.
تحولت سوريا من دولةٍ مكتفيةٍ ومصدّرةٍ لعددٍ من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القمح، إلى دولةٍ مستوردةٍ تواجه مخاطر حدوث مجاعة. ففي يونيو 2025 قالت الفاو إن عجز سوريا في إنتاج القمح بلغ 2.73 مليون طنٍّ، أيْ ما يعادل الاحتياجات الغذائية السنوية لنحو 16.25 مليون شخص. تعزّز المعطيات المتاحة التحذيراتِ التي أطلقتها المنظمة، إذ بلغت كميات القمح المحلية المسلَّمة للمؤسسة السورية للحبوب 372084 طناً لغاية نهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 674976 طناً في السنة السابقة. أي بانخفاض أكثر من 50 بالمئة. يزداد المشهد قتامةً في ظلّ تراجع الثروة الحيوانية الحادّ، إذ تراجعت أعداد الأغنام والأبقار والدجاج بنسبة 50 بالمئة تقريباً بين سنتَيْ 2011 و2016، بحسب المنظمة الأممية.
لا تقتصر المسألة على الأمن الغذائي السوري، بل تتعدّاها للتأثير سلباً على الناتج المحلّي الإجمالي والانزياح السكاني والاستقرار السياسي. فقد أشارت دراسةٌ مشتركةٌ بعنوان "دراوتس إن سيريا" (موجات الجفاف في سوريا) نشرت في المجلة الزراعية الدولية سنة 2012، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية خلال سنوات الجفاف مقارنة بغيرها. كما ترتفع نسبة الفقر على المستوى الوطني بمقدار 0.64 نقطة مئوية خلال هذه السنوات، وهذه الأرقام أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. وإذا ما كانت هذه الأرقام في سوريا قبل سنة 2011، فإن الواقع سيكون أسوأ بعدها، في ظلّ الخسائر الكبيرة التي حاقت بالاقتصاد السوري، فقد انخفض الناتج المحلّي السوري من نحو أربعةٍ وثلاثين مليار دولارٍ سنة 2010 إلى أقلّ من ستة عشر ملياراً سنة 2023، بحسب بيانات البنك الدولي.
وللجفاف أثرٌ محفّزٌ للانزياحات السكانية أيضاً، إذ نزح داخلياً 1.5 مليون شخصٍ خلال أزمة الجفاف بين سنتي 2007 و2011. وكان للاستياء الذي ولّدته أزمة الجفاف تجاه الحكومة، مصحوبةً بمستوياتٍ مرتفعةٍ من الفقر والبطالة وتزايد الضغط على المدن الكبرى، أثرٌ محفّزٌ لاندلاع الثورة السورية سنة 2011. وهو الاستنتاج الذي خلصت له دراسةٌ سنة 2023 عنوانها "سيريان فارمرز إن ذا ميدست أوف دراوت أند كونفليكت" (المزارعون السوريون في خضمّ الجفاف والصراع)، نفّذها الباحثان لينا إكلوند وبينار دينك. لكن البعض ينتقد اعتبار الجفاف سبباً مباشراً لاندلاع الثورة السورية، ويربطها بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أوسع أخرى.
قابلَت الفراتس الخبيرَ الزراعي منذر درويش، العامل في منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، والذي انتقد عدم استجابة وزارة الزراعة لمقترحٍ مفصّلٍ قدّمه متخصصون سوريون مع منظماتٍ دوليةٍ يتضمّن إستراتيجيةً لقطاع الزراعة السوري والتعامل مع أزمة الجفاف. يقول درويش إن الحكومة لم تعلن إستراتيجيةً وطنيةً لمواجهة أزمة الجفاف، مع عدم وضوح الأطر المؤسساتية المسؤولة عنها. فقد أعلن في يوليو 2025 عن اجتماعٍ تنسيقيٍ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا. أوحى ذلك بأن الملفّ قد أصبح بعهدة وزارة الطوارئ، دون توضيح دور الهياكل التي كانت قائمةً للتعامل مع أزمة الجفاف سابقاً ومنها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة.
غياب الاستجابة الحكومية المعلَنة على مستوى الخطط أو المؤسسات المسؤولة أضاف عبئاً إضافياً على معاناة الفلاحين ومربي المواشي وترَكَهم مكشوفين أمام أزمة الجفاف، حسب درويش.