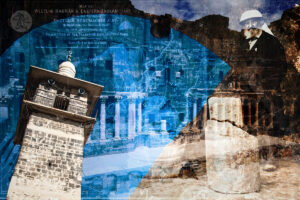عملت إسرائيل بعد نكسة 1967 على مَأْسَسة الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان معتمداً في أكثر من نصفه على الناتج الزراعي، بحيث يصبح تابعاً للدولة العبرية ويمنع انفكاكه في أيّ مرحلةٍ مستقبلية. سيطر الاحتلال على الموارد الطبيعية. وتحكّم بمنح تصاريح العمل والبناء والاستيراد والتصدير وعمل المنشآت التجارية. وبعد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل سنة 1993، وفيما بدا تمهيداً لإنشاء الدولة الفلسطينية، تعزّزت سيطرة إسرائيل على حركة الاقتصاد الفلسطيني مستفيدةً من اتفاقياتٍ اقتصاديةٍ ألحِقت بأوسلو. حصلت إسرائيل بها، وبحكم سيطرتها على المعابر الحدودية، على صلاحياتٍ واسعةٍ في إدارة الجمارك والضرائب على البضائع الواردة والخارجة من المناطق الفلسطينية.
والأهمّ، ظلّ الاعتماد الفلسطيني على الشيكل الإسرائيلي عملةً أساساً. وهو ما منح إسرائيل تحكّماً شبه مطلقٍ في التدفقات والنظام الماليّ الفلسطينيَّيْن.
واليوم يبدو أن النظام الماليّ الفلسطيني أكثر حرجاً في تبعيته لإسرائيل. فقد تكدّس الشيكل في مصارفه وبات التكديس مشكلةً ملحّةً تعرقل التزامات السلطة الفلسطينية وتقيّد فرص النموّ الاقتصادي.
لهذا أعلنَت سلطة النقد الفلسطينية في بيانٍ صادرٍ بتاريخ 29 مايو 2025، عدم قدرتِها على استقبال المزيد من الودائع بالشيكل الإسرائيلي، بعد أن تجاوزت الحدّ الأقصى المسموح به. ودفع هذا القرار البنوكَ العاملةَ في فلسطين إلى رفض استقبال المزيد من الودائع بالشيكل. وأصدرت تعليماتٍ داخليةً بتحديد سقفٍ شهريٍ للإيداع يتراوح ما بين خمسةٍ إلى سبعة آلاف شيكل (الدولار يساوي تقريباً 3.5 شيكل)، مع أن سقف الإيداع السائد كان يتجاوز عشرين ألف شيكل يومياً. وأثار القرار حالةً من القلق والارتباك بين المواطنين الفلسطينيين، الذين تكبّدوا خسارة جزءٍ من أموالهم بعدما اضطرّوا إلى صرفها بعملاتٍ أخرى، مثل الدولار الأمريكي والدينار الأردني، من أجل إيداعها في البنوك التي بات لديها فائضٌ من الشيكل ولم تعُد تقبل به إيداعاً.
تُعرف هذه الحالة في الكتابات الاقتصادية الفلسطينية بِاسم أزمة تكدّس الشيكل، إذ تراكمت كمّياتٌ كبيرةٌ من العملة الإسرائيلية في خزائن البنوك الفلسطينية نتيجة إحجام البنوك الإسرائيلية في مرّاتٍ عدّةٍ، ومن دون مبرّراتٍ تقنيةٍ، عن استقبالها وتحويلها إلى عملاتٍ أخرى لإتمام عمليات الشراء والبيع بين فلسطين وإسرائيل وبقية دول العالم. وهذا يخالف ما نصّ عليه اتفاق باريس الاقتصادي سنة 1994، الإطار القانوني المُتّبَع في اتفاقية أوسلو لنَظْم المعاملات المالية بين الجانبين. ويحوّل هذا الإجراء الفوائضَ النقدية إلى عبءٍ يفاقم التضخم نتيجة عجز المصارف الفلسطينية عن تصريف العملة الإسرائيلية. وبهذه السياسة، تستخدم إسرائيل النقدَ أداةَ ضغطٍ وابتزازٍ سياسيٍ على الضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه رهينةً لقراراتها المالية.
ولضبط البعد الاقتصادي في مناطق الحكم الذاتي الجديدة وتنظيم علاقة السلطة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل اقتصادياً، أُقِرّ في بداية الاتفاق تشكيل لجنة تعاونٍ اقتصاديةٍ فلسطينيةٍ إسرائيليةٍ لتطوير الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة. تلا ذلك بعدّة شهورٍ، تحديداً في 29 أبريل سنة 1994، توقيع ما عرف بِاسم اتفاق باريس الاقتصادي. استهدف الاتفاق إنشاء إطارٍ ناظمٍ للعلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين – تحت مسمّى "اللجنة الاقتصادية المشتركة" – خلال مدّة خمس سنواتٍ، وهي عمر المرحلة الانتقالية التي انتهت فعلياً في 1999.
لم تجتمع هذه اللجنة سوى مرّاتٍ قليلةٍ، قبل أن تجمّدها تل أبيب عقب اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) في نهاية سبتمبر سنة 2000، بعد انهيار محادثات كامب ديفيد بين ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك.
يتناول اتفاق باريس مختلف الجوانب الاقتصادية والمسائل المالية والنقدية ويشمل التفاصيلَ المتعلقة بتنظيم القطاع المالي والمصرفي بين الجانبين. أهمّ بنود الاتفاق تضمن الاعتراف بسلطة النقد الفلسطينية لتكون بمثابة المعتمَد الماليّ الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العامّ محلياً ودولياً. ويشمل الاتفاق أيضاً الاعتراف بأنها المشرفة على عمل البنوك وترخيصها وتنظيم قطاع الصرافة المالية، والمسؤولة عن عقد الاجتماعات مع البنوك الإسرائيلية. أي أن دورها يوازي دور البنك المركزي، لكن دون امتلاكها صلاحيات طباعة العملة، إذ تتفرّد بها إسرائيل.
ويقضي اتفاق باريس بالاعتماد على الشيكل الإسرائيلي عملةً رئيسةً للتداول والدفع لكلّ الأغراض، بما فيها الصفقات المالية الرسمية. ويمنح الاتفاق سلطةَ النقد الفلسطينية الحقَّ في تحويل فائض الشيكل إلى عملاتٍ أجنبيةٍ ضمن سقفٍ ماليٍّ يُحدَّد دورياً بعملية مقاصّةٍ مع البنوك الإسرائيلية. لذا يحدّد المبلغ من الشيكل، الذي يمكن تصريفه إلى عملاتٍ أجنبيةٍ، باجتماعٍ سنويٍّ يُعقد بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل. وعند الحاجة، تعقد اجتماعاتٌ نصف سنويةٍ لمراجعة الكمّيات وتعديلها إذا تطلّب الأمر.
يُلزِم الاتفاق بأن تجرى عمليات تبادل العملة بين الشيكل والعملات الأجنبية عبر غرفة تعاملٍ تابعةٍ لبنك إسرائيل، مع التزام الأخير بتحويل ما يزيد على خُمس المبلغ المحدّد لكلّ نصف عامٍ خلال كلّ شهر.
بدأت سلطة النقد مهمّاتها رسمياً بعد ثلاث سنواتٍ من توقيع اتفاق باريس، وعقب أول انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ فلسطينيةٍ في يناير 1996، وفق القانون رقم 2 لسنة 1997، المعروف بِاسم "قانون سلطة النقد". ومنذئذٍ، اضطلعت بمهمّات الإشراف على القطاع المصرفي الفلسطيني، والذي يُعَدّ نسبياً صغيراً مقارنةً بنظرائه في المنطقة، بما في ذلك ترخيص البنوك ومراقبة أنشطتها، وتنظيم عمل قطاع الصرافة.
ويضمّ القطاع المصرفي اليوم ثلاثة عشر مصرفاً، سبعةٌ منها محلّيةٌ وستّةٌ أجنبية. وتبلغ إجمالي موجوداته 24.5 مليار دولار، وتشكّل ودائع العملاء الحصّةَ الأكبر فيها بقيمة 18.8 مليار دولار. أيْ إنّ ما يتجاوز 76 بالمئة من هذه الموجودات غالبيتها الساحقة في الضفة الغربية. وهذا وفقاً للتقرير السنوي لسلطة النقد الصادر في 2024، الذي يشير أيضاً إلى أن الشيكل يؤلّف ما نسبته 43.5 بالمئة من العملة المودَعة، في حين يؤلّف الدولار نسبة 37.5 بالمئة.
بهذا فرض اتفاق باريس قيوداً صارمةً على السيولة النقدية، أبرزها تحديد كمية الأوراق والقطع المعدنية التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك الفلسطينية في خزائنها بنسبةٍ لا تتجاوز 3 بالمئة من إجماليّ الودائع لكلّ عملةٍ، وعلى رأسها الشيكل. ويُقيّد هذا الشرط قدرةَ البنوك على تلبية طلبات السحب النقدي اليومية للعملاء، ويجعلها معتمدةً على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال أيّ كمّياتٍ إضافيةٍ من النقد. خصوصاً في الفترات التي يرتفع فيها الطلب، مثل الأعياد.
وقد فاقم التحكم الإسرائيلي في السيولة فائض الشيكل لدى المصارف الفلسطينية. إذ إنّ سقف الاحتفاظ بالعملة الإسرائيلية يجبر هذه المصارف على شحن أيّ كمّياتٍ زائدةٍ إلى البنوك الإسرائيلية. لكن القيود التي تفرضها إسرائيل على هذه العمليات، سواءً بالمنع أو التأخير، تؤدّي إلى تكدّس العملة في خزائن البنوك الفلسطينية. وهو ما يعرقل تغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية ويؤثّر سلباً على المعاملات التجارية بين الجانبين. ويُعرَّف فائض الشيكل أيضاً بأنه النقد المتوفِّر لدى البنوك الفلسطينية بما يتجاوز 6 بالمئة من إجماليّ الودائع، وهو الحدّ الذي يستوجب إعادته للبنوك الإسرائيلية باعتبارها الجهة المصدِّرة للعملة. هذا ما ترفضه إسرائيل في أكثر من مناسبةٍ دون مبرّرٍ تقنيّ.
ووفقاً لتقديرات سلطة النقد لسنة 2024، بلغ فائض الشيكل في خزائن المصارف الفلسطينية نحو ثمانية مليارات. ما يؤدّي إلى تضخّم قيمة العملة، وتحمل هذه المصارف تكاليف إضافيةً مثل التأمين لحماية النقد من المخاطر الأمنية أو الكوارث مثل الحرائق، بل وحتى السطو المسلح. فحسب تقرير فايننشال تايمز البريطانية، شهدت الضفة الغربية ثمانيَ عمليات سطوٍ مسلّحٍ على مصارف سنة 2023، وهو ضعف العدد المسجّل في العام الذي سبقه. إضافةً إلى ثلاث عملياتٍ حتى منتصف 2024.
وهذا الواقع الميداني يجسّد ما يُعرف بِاسم "الشيكل الخامل"، وهو الفائض النقدي داخل البنوك الفلسطينية الذي يزيد على حاجتها الفعلية وقدرتها على استيعابه أو تشغيله في الدورة الاقتصادية. أي أنها أموالٌ مكدسةٌ تمثّل عبئاً على الاقتصاد وتعرقل نموّه، بدل أن تكون رافعةً له.
أبرز مصدرٍ للمداخيل يأتي من أجور العمال الفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر، التي ضخّت بمعدل مليار وخمسمئة مليون شيكل شهرياً في الاقتصاد الفلسطيني. وكان عدد هؤلاء العمال قبل السابع من أكتوبر 2023 حوالي 165 ألفاً، بما فيهم آلافٌ عملوا بشكلٍ غير قانونيٍ وبلا تصاريح عمل. انخفضت النسبة لحوالي خمسة عشر ألفاً بعد السابع من أكتوبر. فيما تقدّر شبكة السياسات الفلسطينية العدد بحوالي مئة وأربعين ألفاً، ألغيت تصاريح الغالبية الساحقة منهم بعد بدء الحرب. وأما المصدر الثاني فيأتي من الواردات من إسرائيل، والتي تبلغ حوالي أحد عشر مليار شيكل سنوياً.
كذلك يوضح هذه الفجوةَ الميزان التجاري، الذي يمثّل الفرقَ بين الصادرات والواردات. فقد شكّلت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل سنة 2024 نحو 87 بالمئة من إجماليّ الصادرات الفلسطينية للخارج. فيما بلغت الواردات من إسرائيل للمناطق الفلسطينية حوالي 60 بالمئة من مجموع ما استُورِد. والعملة المستخدمة في كلتا العمليتين هي الشيكل الإسرائيلي.
ويشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة إجماليّ الواردات والصادرات الفلسطينية من إسرائيل انخفضت تدريجياً منذ سنة 1994، مع أن المبالغ المدفوعة زادت. فقد شكّلت الواردات سنة 1994 حوالي 86 بالمئة، بمقدار ثلاثة ملياراتٍ و184 مليون دولارٍ أمريكي. وإن انخفضت في 2024 إلى 60 بالمئة، فالمبلغ زاد إلى أربعة ملياراتٍ و815 مليون دولار. وعلى النمط نفسه، بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل سنة 1996 نحو 94 بالمئة من إجماليّ الصادرات بقيمة 730 مليون دولار، لتتراجع سنة 2024 إلى 87 بالمئة بقيمة مليارَيْن و 302 مليون دولارٍ أمريكي.
ويزيد من كمية الشيكل في الأراضي الفلسطينية ما يُهرّب من الداخل الإسرائيلي إلى الضفة الغربية. يضاف لذلك مشتريات فلسطينيّي الداخل والقدس من أسواق الضفة الغربية. وتتراوح قيمة هذه المشتريات بين 4.4 و5.1 مليار شيكل سنوياً، حسب ورقة سياساتٍ صدرت عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في أكتوبر 2024 بعنوان "تأثير العدوان والقيود المفروضة على تنقّل الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في انكماش الحركة التجارية والسيولة النقدية في شمال الضفة الغربية".
تعزّز العامل الأخير في السنوات الأخيرة بعدما حدّدت إسرائيل سقف التعامل النقدي داخلها للأفراد عند أحد عشر ألف شيكل. وأيّ مشترياتٍ تفوق هذه القيمة يجب أن تكون عبر أدوات الدفع الإلكتروني. ونتيجة ذلك فإن عدداً من فلسطينيّي الداخل، وحتى من إسرائيليين يهود، بدرجةٍ أقلّ، وجدوا في أسواق الضفة الغربية منفذاً لتلبية مشترياتهم لتجاوز هذه القيود، ومن ناحيةٍ أخرى الاستفادة من أسعارٍ أقلّ من نظيرتها داخل إسرائيل.
تنبثق عن هذه اللجنة لجنةٌ فرعيةٌ معنيةٌ بقضايا التنفيذ الماليّ والتحويلات النقدية، تجتمع مرّةً واحدةً سنوياً — عادةً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام — لتحديد السقف السنوي للتحويل. كذلك تُعقد اجتماعاتٌ نصف سنويةٍ لضبط هذا السقف وزيادة الكمّيات عند الحاجة حسب متطلّبات السوق.
منذ سنة 1994 وحتى 2008، لم تكن ثمّة سقوفٌ ثابتةٌ أو معلَنةٌ لتحويل فائض الشيكل. إلّا أن التحويلات كانت تتمّ ضمن حدودٍ مقبولةٍ شهرياً أو بإطارٍ ربع سنويٍ، بتنسيقٍ إداريٍ بين الجانبين. ومع مرور الوقت، برزت الحاجة إلى تحديد هذه السقوف تدريجياً وبانتظام.
بعدما صنّف الكابينيت الإسرائيلي (وهو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية) قطاعَ غزّة كياناً معادياً عقب سيطرة حركة حماس على غزّة في يوليو 2007، قرّرت تل أبيب قطع علاقاتها مع مصارف القطاع. وفي مطلع سنة 2009 توقّفت البنوك الإسرائيلية عن قبول النقد القادم من البنوك الفلسطينية. حينها برّرت بنوك المراسلة الإسرائيلية، وفي مقدمتها مصرفا هبوعليم وديساكونت، بأن هذا القرار نابعٌ من مخاوف أمنيّةٍ تتعلق بمصادر الأموال. هذا إلى جانب مزاعم بوجود مخاطر مرتبطةٍ بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حسب التعريف الإسرائيلي.
وبعد توقف البنوك الإسرائيلية عن قبول النقد الفلسطيني، قاد صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية جهوداً دوليةً لتحديد سقفٍ شهريٍ أوّليٍ بحوالي ثلاثمئة مليون شيكل شهرياً. وخلال فتراتٍ محدّدةٍ، أجِيزَت تحويلاتٌ إضافيةٌ استثنائيةٌ تتجاوز السقف المتّفَق عليه، كما حدث في الربع الرابع من سنة 2021 بتحويل 2.4 مليار شيكل. وبين سنتَيْ 2022 ومنتصف 2023، ورغم تحويل ما يقارب الحدّ السنوي المقرَّر — نحو ثمانية عشر مليار شيكل — ظلّ الفائض النقدي من الشيكل يتراوح بين خمسةٍ إلى ستّة مليارات شيكل. ترافق مع ذلك زيادةٌ في تعقيد إجراءات نقل الأموال وتحويلها.
تتطلب عملية نقل النقد إلى إسرائيل موافقة كلٍّ من فرع الاقتصاد وفرع العلاقات الدولية وقسم العمليات في وحدة منسّق الشؤون الإسرائيلية، إلى جانب فرع الاقتصاد في سلطة النقد الفلسطينية. وتُجرى العملية تحت إشراف مساعد المنسق. وتنقلها بالعادة شركتا برينكس وناتيكس المتخصصتان بنقل الأموال، بالإضافة لمكاتب التنسيق والارتباط.
فرضت إسرائيل منذ سنة 2007، لاسيما في حالة قطاع غزّة، موافقةً مسبقةً من وزير الدفاع على نقل الأموال النقدية من البنوك الفلسطينية إلى داخل إسرائيل. عُلّل السبب بكونه إجراءً أمنيّاً استثنائياً باعتبار أن غزّة "منطقة معادية" أو ذات "وضع أمنيّ خاص"، ما يجعل التعامل معها خاضعاً لاعتباراتٍ وإجراءاتٍ ذات طابعٍ عسكري.
ولم تنتهِ أدوات السيطرة على النقد عند هذا الحدّ، بل أضيفت إليها إجراءاتٌ كانت لتبدو حميدةً في وضعٍ عاديٍّ لا يخضع لتوازنِ قوىً مختلٍّ بين احتلالٍ وبين من يرزحون تحته. ومن هذه الإجراءات خطابات الضمان، وهي عبارةٌ عن حمايةٍ قانونيةٍ من وزارة المالية الإسرائيلية لتكون بمثابة "غطاء قانوني" لتفادي قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الدولية.
ففي 2006، وهي سنة فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وبداية دخول قطاع غزّة مرحلة الحصار الإسرائيلي، بدأت إسرائيل بتصنيف بعض المؤسسات المالية الفلسطينية تحت بند الارتباط بحركاتٍ فلسطينيةٍ تصنّفها إرهابيةً. رفع ذلك درجة الحذر لدى البنوك الإسرائيلية. وبين سنتَيْ 2007 و2008 طَلَبَ مصرفا هبوعليم وديسكاونت، من وزارة المالية الإسرائيلية خطاباتِ ضمانٍ بعدم المسؤولية القانونية عند التعامل مع البنوك الفلسطينية.
ولا عجب أنه في سنة 2009 حدثت أوّل أزمةٍ لتكدّس الشيكل، بعدما أوقفت البنوك الإسرائيلية استقبالَ فائض النقد من المصارف الفلسطينية بحجّة غياب الغطاء القانوني. وطالَبَت بضمانٍ خطّيٍ من وزارة المالية يعفيها من المسؤولية في حال خرق القوانين الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب. بعدها أصبحت وزارة المالية تصدر ضماناً سنوياً يُجدَّد أو يعدَّل وفق تقييمٍ أمنيّ.
تعقدت الأمور أكثر سنة 2018 بعدما دخل قانون مكافحة الإرهاب في إسرائيل حيّز التنفيذ، وأصبح التعامل مع مناطق مثل قطاع غزّة مشروطاً بموافقةٍ أمنيّةٍ صارمة. كذلك باتت الضمانات مفصّلةً وموقّعةً من جهاتٍ عدّةٍ مثل وزير المالية ومكتب المنسّق وجهاز الأمن العامّ "الشاباك". وإلى غاية 2020 طالبت البنوك الإسرائيلية بتقارير دوريةٍ من سلطة النقد الفلسطينية عن البنوك العاملة في غزّة والضفة، قبل الموافقة على نقل فائض النقد من الشيكل.
أمّا في أعقاب الحرب على غزّة في مايو 2021، التي أسمتها حركة حماس معركةَ سيف القدس، أصبحت الموافقة الأمنية شرطاً أساساً. وباتت الضمانات تصدر غالباً بتنسيقٍ بين وزارة المالية والشاباك ومكتب المنسّق. ثمّ بين سنتّيْ 2023 و2025 عادت البنوك الإسرائيلية لرفض استلام النقد بحجّة تأخّر خطابات الضمان من وزير المالية. كذلك شدّدت شروطَها لاستلام النقد، فطالبت بتفصيلٍ يتضمّن طبيعة الأموال المنقولة وتأكيد إشراف سلطة النقد عليها.
إلّا أنه في اليوم الأخير من يونيو 2024، والذي يمثّل تاريخ انتهاء خطاب الحصانة السابق الذي كان ساريَ المفعول لمدّة ثلاثة أشهرٍ فقط، قرّر سموتريش فجأةً تجديدَ خطاب الحصانة أربعةَ أشهرٍ إضافية. ما أضاف حالةً من عدم اليقين إلى العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وإن سمح ذلك باستمرار التعاون المصرفي.
جاء التجديد ضمن صفقةٍ داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي تضمّنت عدمَ تنفيذ عقوباتٍ ماليّةٍ على السلطة والإفراجَ عن أموال المقاصّة، مقابل توسيع الاستيطان وفرض قيودٍ إضافيةٍ على بناء الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأموال المقاصّة هي الضرائب التي تجبيَها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وتشمل الرسومَ الجمركية وضرائبَ المشتريات وضريبةَ القيمة المضافة على الواردات من إسرائيل وبلدانٍ أخرى، حسب ما تنصّ عليه اتفاقية باريس الاقتصادية. وتحصل إسرائيل على ما قيمته 2.5 بالمئة عمولةً لها.
حينئذٍ، كان مقدار الفائض من الشيكل الذي طالَبَ الفلسطينيون بإرساله للبنوك الإسرائيلية وتبديله بعملاتٍ أخرى ستّة مليارات شيكل، مقسّمةً على 4.5 مليار شيكل عن الربع الأول من سنة 2024، و1.5 مليار عن شهر مايو من العام ذاته.
عادت الأزمة من جديدٍ وتعمّقت في منتصف 2025. فقد رفض سموتريش منح خطاب الضمان لبنوك المراسلة الإسرائيلية مع انتهاء الربع الأول لهذا العام. كذلك رفضت الشركات الناقلة مثل برينكس التعاملَ بدون تغطيةٍ تأمينيةٍ وضماناتٍ قانونية.
وبعد جهودٍ دوليةٍ ووساطاتٍ قادها حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت سلطة النقد في الثالث من يوليو 2025 عن استئناف تحويل فائض الشيكل للبنوك الإسرائيلية ضمن الدفعة الثالثة من السنة، بمقدار أربعة مليار وخمسمئة مليون شيكل جزءاً من حصّتها السنوية البالغة ثمانية عشرة مليار شيكل. على إثر ذلك، عاد شحن ما يقارب الحصة ربع السنوية المتّفَق عليها تدريجياً، بصيغة استثناءٍ مؤقتٍ ضمن إطار الضغط المستمرّ على رفع سقف التحويل السنويّ من ثمانية عشر إلى خمسةٍ وعشرين مليار شيكل.
بدوره يشير المتخصص بالشأن الاقتصادي وعضو الاتحاد العامّ للاقتصاديين الفلسطينيين، ثابت أبو الروس، في حديثٍ للفراتس إنه قبل الحرب الجارية على غزّة منذ أكتوبر 2023، كان هناك تقدّمٌ بطيءٌ في إيجاد آليّاتٍ جديدةٍ لإدارة العلاقة بين المصارف في فلسطين مع بنوك المراسلة الإسرائيلية السائدة منذ سنة 2007. وفي بداية 2023 وافقت الحكومة الإسرائيلية مبدئياً على تولّي شركة مراسلةٍ إسرائيليةٍ جديدةٍ خاصةٍ تقدّم خدمات المقاصّة والتسوية مع جميع البنوك المرخّصة من سلطة النقد الفلسطينية.
وكشف أن هذه الشركة، بدأت فعلاً في تطوير الأسس اللازمة لعملها. لكن الفجوة في التشريعات الإسرائيلية لتحديد صلاحيات هذه الشركة وطبيعة علاقاتها مع بنك إسرائيل والبنوك الفلسطينية وتأمين وصولها غير المقيّد لغرف المقاصّة الإسرائيلية حال دون ذلك. كما يعتمد ذلك على التشريعات من الكنيست، ما جعل المهمة غايةً في الصعوبة.
وهذا ما حذّر منه أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة النجاح في نابلس، نائل موسى، في حديثٍ للفراتس. فقد أكّد أن تكدّس الشيكل يتجاوز بتأثيره السلبي البعدَ النقدي، فهو ينذر بتداعياتٍ هيكليةٍ على الاقتصاد الفلسطيني كلّه. ويشير موسى إلى أن عدم قدرة الفلسطينيين على تصريف الفائض، قد يقود إلى اختلالاتٍ في دورة السيولة وانكماشٍ في الإقراض والتمويل ما يُضعِف دورَ البنوك وسيطاً مالياً ويقلّص قدرتَها على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وأضاف موسى أن مخاطر فقدان ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي يعود إلى تكرار أزمة تكدّس الشيكل. فمن شأن ذلك أن يدفع الشريحة الأوسع من المواطنين، للّجوء إلى الاقتصاد الموازي البعيد عن سيطرة ورقابة الحكومة. ومن ناحيةٍ أخرى قد نشهد تقلّصاً في نشاط المصارف الائتماني، وتقلّص دورِها في الأراضي الفلسطينية عامّة.
ويرى المتخصص الفلسطيني بأنه يفترَض نظرياً أن يضمن اتفاق باريس حريةَ حركة الأموال، لكن العراقيل المتكررة تُحوِّله إلى أداة ضغطٍ سياسي. ويفرض هذا الأمر على السلطة الفلسطينية البحثَ عن بدائل نقديةٍ وإجرائيةٍ تقلّل من ارتهان المنظومة المصرفية المحلّية للإجراءات الإسرائيلية.
وبخصوص البدائل يقول ثابت أبو الروس: "طرحنا [خبراء اقتصاد فلسطينيين] مجموعةً من الخيارات لمعالجة الأزمة، عبر تدويل القضية ومتابعتها على مستوى المحاكم الدولية، باعتبار أن ما يجري ليس مجرّد اعتداءٍ اقتصاديٍ، بل سياسةً تدميريةً ممنهَجةً تستهدف الفلسطينيين واقتصادهم الوطني". وحسب تعبيره: "لم يغيّر هذا للأسف من السياسات الإسرائيلية".
وأضاف أن ما يعزّز المشكلةَ اعتمادُ غالبية الفلسطينيين على وسائل الدفع التقليدية بعيداً عن الدفع الإلكتروني. ويتطلّب تشغيل هذا النظام موافقةَ إسرائيل لتفعيل تقنيات الجيل الرابع والخامس من الاتصالات.
وبالبحث عن بدائل تحرّرها من هيمنة المنظومة المالية الإسرائيلية، تدرس سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً آليّاتٍ تجنّبها الاعتمادَ الكامل على الشيكل، ومنها التحوّل للعملات الرقمية. ولكن يبقى السؤال عن مدى واقعية هذا الطرح وإمكان تطبيقه في ظلّ الاحتلال. فظاهرة تكدّس الشيكل أصلاً واحدةٌ من إرهاصات هذا الاحتلال، وأحد أوجه التبعية الاقتصادية التي فرضها اتفاق باريس على الفلسطينيين، الطرف الأضعف في المعادلة أمام إسرائيل.
وبين قيود سقف السيولة وتعطيل التحويلات وإجراءات النقل المعقّدة، تبقى المصارف الفلسطينية عاجزةً عن إدارة مواردها بحرّيةٍ، ويظلّ الاقتصاد الفلسطيني رهينة قرارات صانعي القرار في تل أبيب ومصالحهم. هذا الواقع لا يفاقم الأعباء المالية فحسب، بل يُعمّق سيطرة إسرائيل على مفاصل الحياة للكلّ الفلسطينيّ، ويعزّز بالضرورة الاختلالاتِ البنيويةَ التي تمنع قيام اقتصادٍ وطنيٍ قادرٍ على النموّ والاستقلالية. وبلا اقتصادٍ مستقلٍّ قادرٍ على الحياة، فإمكانية قيام دولةٍ فلسطينيةٍ تصبح أكثر تعقيداً.