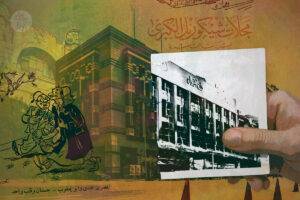بدا كل شيء مألوفاً على نحوٍ مربك: اللافتات والحافلات التي تُقل المتظاهرين من مناطق متفرقة والشعارات التي تلهب الحناجر وآلات التصوير والأمن تحيط بالمكان. رأيتُ هذا المشهد قبلاً وشاركت في بعضه منذ بداية ثورة 17 فبراير سنة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وكتبت عنه أكثر من مرة. وقد تكرر نفس الشعور بالألفة مع المظاهرات اللاحقة، سواء تلك المؤيدة حكومةَ الوحدة أو المعارضة في طرابلس وباقي المدن.
استعدت مشاهدَ من ثورة فبراير وما تلاها من زخمٍ في حراكٍ مدنيٍ. كانت الميادين المفتوحة والنقاشات السياسية والاجتماعية عن مستقبل البلد تدور في الجامعات والمقاهي والمنصات الإلكترونية. عكسَ ذلك ما بدا حالة الولادة الأولى لمجتمع مدني ناشئ، مرتبك لكنه حيّ.
أين ذهب كل ذلك؟ هل اندثر أم أعيد تدويره داخل منظومات جديدة تحتفظ بالشكل وتفرغ المضمون؟ من هنا بدأتُ محاولاً مساءلةَ صورة المجتمع المدني الراهنة كما تتجلى في الساحات وعبر المؤسسات في ليبيا، وفي عيون من بقوا داخل الميدان. وكوني شاهداً وفاعلاً سابقاً وباحثاً يحاول أن يفهم، فتشت في ذاكرة الحراك المدني عن لحظات قوّته وضعفه، وعن أوجه اختراقه وتشظّيه. وعن ما بقي منه أو ما يمكن إنقاذه في ظل واقع سياسي تحوّل فيه المجتمع المدني الليبي في حالات من وسيلة للمشاركة والمساءلة، إلى قناع ترتديه جماعات المصالح المسلحة. تستخدمه أداةً تضفي عليها شرعية مؤسساتية أو صوتاً شعبيّاً يمنحها قبولاً مجتمعياً.
بعدها بأشهر قليلة أهداني أبي كتاباً آخر للكاتب والأكاديمي الفلسطيني عزمي بشارة عنوانه "المجتمع المدني: دراسة نقدية"، بطبعةِ 2012. لم أفهم المغزى في لحظتها، لكن جملة قصيرة قالها لي أبي لاحقاً سترافقني سنواتٍ: "لقد انتهت الثورة الآن ويجيب أن تنتهي الحالة الثورية. ساهم في بناء الوطن من خلال المجتمع المدني أو الاتحادات الطلابية أو غير ذلك". كانت كلمات والدي نصيحة بعدم التفكير في الانخراط في أي من أشكال العمل المسلح، الذي كان جذاباً حينئذ بفعل المرتبات والمزايا. ناهيك عما ظهر عليه المجتمع الليبي من اتجاه نحو العسكرة.
في كتابه لا يعطي عزمي بشارة تعريفاً واحداً جامداً للمجتمع المدني. يراه مفهوماً يطرح وفق السياق السياسي وارتباطه بتطور مفاهيم سياسية أخرى تختلف من حالة لأخرى، مثل مفهوم الأمّة. ولكن بالمحصلة يعدُّ المجتمع المدني ركيزةً أساساً في التحول الديمقراطي وقيم المواطنة، وفضاءً مستقلاً نسبياً عن الدولة والسوق تمارَس فيه الحقوق وتُبنى فيه الروابط الطوعية بين أفراد أحرار ومتساوين.
وليس المجتمع المدني عند بشارة مجرد مؤسسات منفصلة عن الشأن السياسي وقضايا المجتمع، بل مجال نضالي يجسّد التفاعل بين المجتمع والدولة. وهو آلية لبناء عقد اجتماعي حديث يعيد التوازن بين الفرد والدولة، ويُسهم في بناء السيادة الشعبية وتحقيق الرقابة المجتمعية. ومؤسسات المجتمع المدني في نظره أدوات تنظيم وتمثيل وتثقيف، لذا يحذّر من اختراقِ الجماعات المسلحة أو المجموعات القائمة على العصبية لها، مما يُفرغها من مضمونها المدني والديمقراطي.
في الحالة الليبية، كان المجتمع المدني قد بدأ تعريف نفسه على عجل إبّان الثورة، مركزاً على أعمال الإغاثة والصمود أمام النظام في الميادين أثناء أحداث الثورة. ومنذ سقوط النظام وحتى بداية 2012، استعاد هذا المجتمع جزءاً من فضائه المفقود، فقد ظهرت عشرات الجمعيات المدنية التي حاولت ملء الفراغ الكبير الذي خلفته عقود من تجريف العمل المدني المستقل. وبهذا عادت النقابات إلى الواجهة بعد عقود من الإلغاء وإعادة الهيكلة القسرية التي بدأت مع انقلاب القذافي ورفاقه على المملكة الليبية في سبتمبر 1969. حينها ألغى ما عُرِفَ بمجلس قيادة ثورة الفاتح جميع النقابات العمالية والمهنية القائمة، ووضعها تحت سيطرة الدولة.
أُلحقت النقابات في السبعينيات بالاتحاد الاشتراكي العربي، وكان التنظيم الشعبي الوحيد في ليبيا. ثم حُوّلت مع إعلان السلطة الشعبية – تجسيداً لسلطة الشعب على أرضه وإعلان الجماهيرية – سنة 1977 إلى مؤتمرات مهنية أو إنتاجية بلا استقلالية فعلية. أصبحت النقابات بهذا أداة ضمن بنية النظام، مع غياب الدور التمثيلي والقدرة على التأثير في السياسات. ظل هذا الإطار المقيد قائماً حتى سقوط النظام في 2011، ليتيح الفرصة أمام النقابات لاستئناف نشاطها بحرية نسبية، وإن في بيئة انتقالية مليئة بالتحديات.
بالتوازي أعيدَ منذ نهاية 2011 تأسيس اتحادات طلابية جديدة على أنقاض "الروابط الطلابية". وهي الروابط التي تشكَّلت في السبعينيات بديلاً عن الاتحادات الطلابية التي حُلت وأعُدِم أو سُجِن بعض قياداتها أثناء ما يعرف بالثورة الطلابية أو ثورة "السابع من أبريل" سنة 1976، والتي خرج فيها طلاب الجامعات في مظاهرات احتجاجاً على انتهاك حقوق الإنسان والاستبداد في البلاد.
أصبحتْ الساحات بعد ثورة 2011 تضجّ بالحياة، من ميداني الشهداء والجزائر في طرابلس إلى ساحتي الكيش والمحكمة في بنغازي، وحتى ساحة الشهداء في مدينة الزاوية وجزيرة (دوّار) العلم بمصراتة، مروراً بالمراكز الثقافية والمعارض والندوات. عايشتُ تلك اللحظات مع أصدقاء في الحملة البيئية "كلين أب تريبولي" (لننظف طرابلس). وفرحت بمشاركتي في نوادي القراءة الجديدة التي انبثقت، مثل نادي نواة للقراءة ونادي الشجرة في كلية الطب البشري بجامعة طرابلس سنة 2012، ونادي جامعة طرابلس سنة 2013 الذي جاء بمبادرة اتحاد الطلبة لتشكيل أندية ترفيهية وثقافية للطلبة.
بل إنني أذكر "معرض الكتب المستعملة" الذي أشرفت عليه حركة "تنوير" الثقافية سنة 2013. وأذكر جهود حملة منظمة "إتش تو أو" (ماء) في توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية والتصويت. فقد جابت المدن لتوعية الناس بالتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني سنة 2012، وأقامت ورشات تدريب مراقبة الانتخابات، وأدارت حوارات مفتوحة عن الهوية والعدالة والدولة.
لم يكن المجتمع المدني يومها ناضجاً ولا محصّناً. وكانت هناك محاولة لصياغة حضور مدني يقابل السلطة ولا يماثلها، وليقف في المساحة بين الفوضى والدولة. تشكّل هذا الحضور من مبادرات الإغاثة إلى الورش الثقافية، ومن الاحتجاجات العفوية إلى الحملات الطلابية. كان ذلك المسار يماثل تعريفات عزمي بشارة إلى حد ما، إذ كان الحراك المدني يسعى نحو المزيد من الحكم الرشيد والشفافية والتداول السلمي للسلطة.
أوَّل العراقيل التي جابهت المجتمع المدني كانت غياب قوانين تفصيلية تنظم عمل مؤسساته. اكتفى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من أغسطس 2011 (السلطة التشريعية الانتقالية الأولى التي تولت الحكم في المناطق المحررة من القذافي، ثم في ليبيا كلها إلى حين انتخابات المؤتمر الوطني) بكفالة حق إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات وكذلك حق التظاهر. لم يعقب ذلك قوانين مفصلة تنظم كلاً منها وتكفل الحقوق والواجبات. وقد استمر الإهمال في إصدار هذه القوانين فترة وجود المؤتمر الوطني العام منذ 2012 (السلطة التشريعية الانتقالية الثانية)، وكذلك مجلس النواب الليبي منذ 2014 (السلطة التشريعية الانتقالية الثالثة).
على المستوى التنظيمي المؤسسي، اكتفتْ الدولة الجديدة بإنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني، حتى أعاد رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان تغيير اسمها سنة 2013 إلى "مفوضية المجتمع المدني". لتصير جهةً تنظيميةً تشرف على تسجيل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتجديد إشهارها. على ذلك ظلّت المفوضية حكراً على الحكومة، إذ ليس هناك في قوانينها التنظيمية ما يسمح لمؤسسات المجتمع المدني باختيار مجلس هذه المفوضية أو أن يكون لها أي دور تنظيمي فيها. ليكون هذا القصور في الإطار القانوني والمؤسسي في السنوات اللاحقة الثغرة التي تمكنت منها المؤسسات السياسية، مثل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية وحتى الأجهزة الأمنية من عرقلة المجتمع المدني والضغط عليه، بل واختراقه.
ومع كل ذلك، انطلق المجتمع المدني في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة محاولاً صنع شيء ما وسط بيئة صعبة جداً، وقد كان من شواهد محاولة صمود المجتمع المدني في تلك الفترة تأسيس الحراك الطلابي بجامعة طرابلس، حركةَ "سِلم". وقد خرجت في مظاهرات صيف 2013 مطالبة بالمسارعة في إعادة هيبة الدولة وإخراج التشكيلات المسلحة من مدينة طرابلس.
تكاثرت الأحداث وتسارعت، وكان أبرزها عندما طرحت مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني، وأغلبهم من الإسلاميين أو قيادات ثورة فبراير، مشروعَ قانون للعزل السياسي وعدم السماح بتقلد المناصب القيادية بحق من عمل في أي مناصب مهمة فترة النظام السابق. وفيما كان الجدل مستمراً في قاعة المؤتمر الوطني، اقتحمتْ مجموعات مؤيدة للقانون في أبريل 2013 (تتكون من من مجموعات من الإسلاميين وأخرى تنحدر من مدينة مصراتة تحديداً) مقرَّات حكومية وفرضت عليها حصاراً بالسلاح للضغط لإقرار مشروع القانون. أُقر القانون في أغسطس 2013. بدا السلاح وسيلة تحقيق المآرب، وتجلَّى ذلك بعد شهرين من إقرار القانون. إذ اختطف جهاز مكافحة الجريمة – إحدى المجموعات المحسوبة على كتائب الثورة القريبة من الإسلاميين – رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان. أُخذ زيدان من مقر إقامته بفندق كورنثيا في طرابلس، لكن أطلق سراحه بعد ساعات.
أما الحدث الثاني الكبير، فقد كان أثناء مظاهرات نظَّمها داعمون للنظام الفيدرالي (الذي كان مقرراً في بدايات المملكة الليبية منذ 1951 وحتى 1963) في برقة، وهو الاسم التاريخي لشرق ليبيا. طالب المتظاهرون في فبراير 2012 في بنغازي بفرض النظام الفيدرالي رافعين شعارات ضد التهميش والمركزية. لكن المظاهرات تحولت لاشتباك مع متظاهرين آخرين ضد هذا التوجه، وانتهت بمقتل أحد المتظاهرين.
لاحقاً تطوَّرت المطالبات بالفدرالية إلى إعلان إنشاء مجلس لإقليم برقة ترأسه أحمد الزبير السنوسي، أحد أقرباء العائلة الملكية في ليبيا. ثم أنشأ دعاة الفيدرالية في أكتوبر 2013 مكتباً سياسياً برئاسة إبراهيم الجضران، قائد قوات حرس النفط، وإعلان تشكيل حكومة لإقليم برقة برئاسة عبدربه البرعصي. استخدمت دعوات الفيدرالية ذرائعَ لإغلاق الحقول النفطية وموانئ التصدير في المنطقة الشرقية سنواتٍ طويلة. ما تسبب في خسائر مالية فادحة تجاوزت مئة مليار دولار أمريكي، كما أعلن صنع الله إبراهيم، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، في يوليو 2016.
أما الحدث الثالث فقد كان حدثاً مكرراً، عنوانه الاغتيالات التي استهدفت عسكريين وحقوقيين في مناطق شرق ليبيا وخاصة بنغازي. حدثت تلك الاغتيالات، بينما كانت مناطق السيطرة داخل بنغازي منقسمة بين مجموعات تنسب نفسها للثوار. وقد عملت هذه المجموعات تحت تشكيلات اعتمدتها وزارة الدفاع تحت اسم "درع ليبيا"، صحبة مجموعات إسلامية صُنِّف بعضها متطرفاً، مثل أنصار الشريعة، وبين مجموعات أخرى تحمل مسميات عسكريات تقليدية وتعمل تحت إمرة ضباط عسكريين.
اُتهمت كتائب الثوار وكتائب الإسلاميين بعمليات الاغتيال وغيرها من الأحداث الأمنية شرق ليبيا. أولى نتائج تلك الاتهامات كان خروج مظاهرات في منطقة الكويفية، إحدى ضواحي بنغازي، في يونيو 2013 أمام معسكر أحد كتائب قوات "درع ليبيا". طالب المتظاهرون بخروج تلك الكتيبة من المنطقة وحل التشكيل. أطلق الرصاص على المتظاهرين وقُتل اثنان وثلاثون شخصاً. اتُهمت كتيبة "درع ليبيا" بالمسؤولية عن قتل متظاهرين عُزّل، وردت الكتيبة بأن إطلاق الرصاص بدأ على عناصرها من المتظاهرين وأنهم ردَّوا على مصدر النيران.
كانت الاغتيالات وأحداث الكويفية مع بعض الدوافع الجهوية، إحدى أسباب المواجهات اللاحقة بين كتائب الصاعقة وكتائب درع ليبيا وأنصار الشريعة. وهي المواجهات التي مهَّدت الطريق لاحقاً لاطلاق عملية "الكرامة" التي قادها خليفة حفتر سنة 2014.
الحدث الرابع كان أحد أقوى الضربات التي أصابت الحراك المدني. فقد كانت العاصمة طرابلس تعاني من انفلات أمني ومن تعدد الأجهزة الأمنية والصراع على النفوذ. فتغلغلت المجموعات المسلحة التي كان بعضها يرتكب جرائمَ ضد المواطنين، وكان لها سجونٌ خاصة بها. كان أتباع الحراك المدني قد خرجوا في مظاهرات للمطالبة بإصلاح هذا الوضع. ولكن بلا نتائج فعلية رغم إصدار قرارات من الحكومة والمؤتمر الوطني تلزم المجموعات المسلحة بالخروج من العاصمة طرابلس، وأهمها القرار رقم 27 لسنة 2013.
ووسط غياب الحلول دعا السادات البدري، رئيس المجلس المحلي بطرابلس المركز، رفقة نشطاء في المدينة، إلى مظاهرات يوم 13 نوفمبر 2013. توجهت المظاهرات إلى مناطق مجموعات مسلحة بمنطقة غرغور، وقوبل المتظاهرون بإطلاق الرصاص. أسفرت الحادثة عن سقوط ثلاثةٍ وأربعين قتيلاً، وتسبب في تحشيدات أمنية كبيرة داخل العاصمة كادت أن تتحول إلى حرب جهوية ومناطقية.
لم يكن خروج المظاهرات بعد غرغور المحاولة الوحيدة لرفض ذلك الواقع. فقد ظنَّ جزء من الحراك المدني أن تغيير الواقع السياسي ربما يحسِّن من الوضع العام للبلاد، وأن الوقت قد حان لخروج المؤتمر الوطني العام من المشهد وانتخاب سلطة تشريعية جديدة. وحينئذ كان الجدل السياسي قائماً وسط المجتمع، فيما إذا كان وجود المؤتمر الوطني مرتبطاً بإطار زمني محدد أم بمنجزات محددة.
كان هناك اتفاق بين قيادات المجتمع المدني أن المؤتمر الوطني العام لم يحسن الأداء في قضايا مفصلية مثل الأمن والسلم المجتمعي. لذا قرر جزءٌ منهم في بداية 2014 إنشاء حراك يسمى باسم "لا للتمديد"، لدعوةِ المؤتمر الوطني للتخلي عن السلطة، ومطالبين بانتخابات لاختيار سلطة تشريعية مؤقَّتة جديدة. نجحت ضغوطات الحراك في دفعِ المؤتمر الوطني لتشكيل لجنة مستقلة تحت اسم "لجنة فبراير" في 11 فبراير 2014 لتعمل على مقترح للخروج من الأزمة السياسية. اقترحت اللجنة إقامة انتخابات تشريعية جديدة، وهو ما وافق عليه المؤتمر الوطني.
شهدت الفترة الفاصلة بين الموافقة على انتخابات جديدة وموعد إجرائها أحداثاً متسارعة. فقد حاول اللواء خليفة حفتر في 14 فبراير 2014 بداية انقلاب عسكري تلفزيوني من طرابلس، أعلن فيه تجميد الإعلان الدستوري والعمل الحزبي والتنظيمات السياسية. لكنه لم يجد أي استجابة على الأرض، فأصدرت الحكومة قراراً بالقبض عليه، قبل أن ينجح بالفرار إلى شرق ليبيا. وقد نجح في المنطقة الشرقية في مايو من ذات العام في إقناع مجموعة من الضباط وأبناء القبائل بضرورة إطلاق عملية عسكرية ضد من أسماهم الإسلاميين والمتطرفين في بنغازي، وأُطلق عليها بعد ذلك بأشهرٍ اسمَ عملية "الكرامة".
لاحقاً في ذات الشهر اقتحمت مجموعات مسلحة، هي الصواعق والقعقاع، مقر المؤتمر الوطني وأضرمت فيه النيران. وعندما حان يوم انتخابات مجلس النواب الليبي في يونيو 2014، كانت الاشتباكات مشتعلة في شرق ليبيا. فنتج عن ذلك مشاركة سياسية ضعيفة للناخبين وخسارة كبيرة للإسلاميين ولمن ينسبون أنفسهم للتيار الأشد تمسكاً بمبادئ ثورة فبراير.
سرعان ما أدَّتْ انتخابات مجلس النواب إلى انقسامٍ. إذ رفضَ التيار الثوري قبول وجود غطاء سياسي شرعي لأنصار عملية "الكرامة" في مجلس النواب. وهو ما دفعه لاحقاً للمضي في وسائل متعددة منها قانوني، لإلغاء شرعية انتخابات مجلس النواب.
تفاقمت الظروف السياسية والأمنية لتشتعل الحرب الأهلية في طرابلس في صيف 2014 بين قواتِ عملية "الكرامة" التي يقودها حفتر، وكان أغلبها من مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس، وقوات "فجر ليبيا"، التي كانت تقودها جماعات مسلَّحة من مصراتة. أدتْ تلك الحرب إلى خسائر جسيمة، كان أهم حدثٍ فيها هو حرق خزانات النفط في طريق المطار جنوب طرابلس، وحرق مطار طرابلس الدولي وتهديمه.
سدد الاحتراب الأهلي والانفلات الناتج عنه ضربات موجعة للمجتمع المدني. فقد اغتيلت عضوة المجلس الانتقالي السابق والناشطة الحقوقية سلوى أبوقعيقيص في بنغازي في يونيو 2014. واغتيلت بعدها عضوة المؤتمر الوطني العام فريحة البركاوي في مدينة درنة في يوليو من نفس العام. ولم يمر شهر حتى غُيِّبَ الناشط المدني عبدالمعز بانون في مدينة طرابلس.
اغتيلتْ كذلك قيادات شبابية مثل الناشط الحقوقي توفيق بن سعود ورفيقه سامي الكوافي في 19 سبتمبر 2014، عندما أطلق مسلحون الرصاص على سيارتهم وسط مدينة بنغازي. ليلحقوا بشخصيات مدنية أخرى اغتيلت قبل ذلك، كان أبرزها المحامي عبدالسلام المسماري، الذي اغتيل في يوليو 2013. وليصبح الاغتيال أو الخطف والإخفاء القسري مصير كثير ممن يعلو صوته في ليبيا.
باشرت السفارات في مغادرة ليبيا فور انطلاق عملية "فجر ليبيا" في يونيو 2014، بل وغادر بعضها قبل ذلك بناء على تقارير أمنية أنذرت بتدهور الأوضاع. وبالتبعية بدأت المنظمات الأجنبية والدولية في المغادرة بفعل توصيات عدم السفر إلى ليبيا وضرورة مغادرتها، والتي وُجهت للعاملين في البلاد. بهذا توقف التمويل الذي كان موجهاً لمنظمات المجتمع المدني. وأدت الحرب لتعطل الأحزاب السياسية، فقانون انتخابات مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 لم ينصَّ على تنافس على أساس القوائم، وبالتالي لم تكن هناك منافسة سياسية. فأدى تصدر العمل المسلح الواجهة لجعل كل أشكال العمل المدني غير مجدية، وكل ما تلا ذلك أصبح شكلاً جديداً ومختلفاً لطريقة عمل مؤسسات المجتمع المدني وحراك الشارع الليبي.
كنتُ ضمن من حاولوا إبقاء نشاطهم على قيد الحياة. فانضممتُ لحراك "من أجل طرابلس" الذي كان يدعو لإيقاف الحرب وينتقد عمليتي "الكرامة" و"فجر ليبيا". حركنا الميادين وحاولنا التواصل مع أطراف النزاع وطلب ممرات إنسانية للعالقين من المدنيين على الأقل. وصلنا إلى العالقين في مناطق الحرب لإيصال المساعدات وكدنا أن نموت بعدما وجِّهتْ صوبنا فوهات مضادات الطائرات، قبل أن يدرك المقاتلون أننا جئنا لإغاثة السكان.
وجدتُ نفسي أقف جنباً إلى جنب مع أشخاص كنت مختلفاً معهم ومع أفكارهم. كانوا يقدمون أنفسهم على أنّهم ليبراليون علمانيون، وكنت أقدم نفسي إسلامياً. اكتشفنا معاً أنّ ما كان مهدَّدَاً في ذلك الوقت هو أمننا وسلامتنا ومستقبل أبنائنا ووطننا معاً. لقد كانت أفكارنا وطموحاتنا أقرب مما كنا نعتقد وكان ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. وفي تلك المرحلة جمعنا هدف العودة إلى نقطة ما قبل الحرب والأمل في ليبيا واحدة تعيش سلاماً وعدلاً وحرية وتنمية.
الأول أفول نشاط منظمات المجتمع المدني وخاصة التنموي في ظل غياب التمويل والأمن. ففي سبتمبر سنة 2016 قدتُ مشروعاً بحثياً مع منظمة "ممكن للتوعية والإعلام"، تحت اسم "منظمات المجتمع المدني في ليبيا: الأداء التحديات والمستقبل". كان الغرض من البحث دراسة وضعية منظمات المجتمع المدني وتأثير الحرب الأهلية عليها. وتمكنَّا من الوصول إلى أربعمئة وعشر منظمات فقط من أصل أكثر من ألفين وسبعمئة منظمة مسجلة لدى مفوضية المجتمع المدني.
وجدنا في الدراسة أنّ نسبة 60 بالمئة من تلك المنظمات ما زالت تعمل شكلياً، لكن 90 بالمئة من هذه النسبة لم يكن يملك أي تمويل مستمر أو مقر ثابت، ولم تقم بأي نشاط لمدة تتراوح بين العام والعامين. أثبتت النتائج افتراضنا أن المؤسسات التنموية بالذات تأثرتْ مباشرةً وبسرعة بالوضع الأمني، وبسبب مغادرة المنظمات الدولية والسفارات البلاد مع صعوبة الوصول إلى التمويل المحلي. بينما كان الوضع أفضل قليلاً للمؤسسات الإنسانية والإغاثية التي كان بإمكانها الصمود نتيجة إمكانية حصولها على التمويل المحلي والتبرعات من المواطنين لأنها مقبولة أكثر مجتمعياً. فضلاً عن عمل بعض هذه المؤسسات مع بعض المنظمات الدولية والأممية الإنسانية على ملفات الهجرة والنزوح التي كانت في أوجها في تلك الفترة. وأذكر من تلك المنظمات مؤسسة "الشيخ الطاهر الزاوي" ومؤسسة "كفاءة" وقد تعاملت مع كلتيْهما.
أما الاتجاه الثاني الذي رصدتُه تلك الفترة، فكان غياب تنوع الحراك المدني في الشارع وانحصاره على لون واحد أو غيابه بالكامل في مناطق أخرى. ففي طرابلس، كانت السيطرة في ميدان الشهداء لصالح أنصار عملية "فجر ليبيا" وما يمكن أن يطلق عليه التيار الإسلامي. كنت أشاهد باستمرار بعض الشخصيات التي زاملتها في الجامعة أو في العمل السياسي الحزبي وتنتمي للتيار الإسلامي في الميدان. كانت المظاهرات ضد عملية "الكرامة" أو للتعبير عن قضايا ومواقف مختلفة لهذا التيار. بينما اختفى الحراك المدني بالكامل تقريباً شرق البلاد في ظل استمرار الحرب في بنغازي ودرنة بالجبل الأخضر.
وبعد سيطرة حكومة الوفاق، شهدت البلاد تغيّرات كبيرة في القوى المؤثرة في الحكم وطريقة إدارته. أثرت تلك التغييرات هيكلياً على العمل المدني حراكاً ومؤسسات. ففي سنة 2017 سيطرت قوات حفتر التي تسُمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" على بنغازي بالكامل، وتوقفت الحرب في المنطقة الشرقية. وتوسعت رقعة تأثير نفوذ حفتر ومناطقه منذ 2016 حتى 2019 عندما سيطر على الجنوب الليبي.
أثناء هذه الفترة فرض حفتر قبضته الأمنية وبدأ عملية تدريجية لكنها سريعة لقمع الأصوات المعارضة لحكمه. استمر حفتر في شدِّ القبضة الأمنية إلى وقت نشر هذا المقال في أغسطس 2025. قمَعَتْ قواته الأمنية أي حراكٍ أو صوتٍ سياسي، وسقط ضحية ذلك أشخاص مثل الناشط سراج دغمان الذي اعتُقل في الأول من أكتوبر 2021 بعد مشاركته في ندوة عن تداعيات انهيار سد درنة في سبتمبر من ذات العام إثر الطوفان الذي سببه إعصار دانيال. وقد أعلنت أسرته وفاته بعد سبعة أشهر من الاحتجاز لدى الأمن الداخلي ببنغازي.
أعتُقل أربعة أشخاص آخرين أيضاً في ذات الشهر، هم المحامي وعضو المجلس الوطني الانتقالي السابق فتحي البعجة والناشطَين السياسيَين طارق بشارة وسالم عريبي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي. وُجهت لهم تهم "التخطيط لإسقاط الجيش".
بهذا اختفى الحراك المدني من الشارع في بنغازي، وسيطر حفتر على مفوضية المجتمع المدني في المدينة بعد اعتقال المدير التنفيذي إبراهيم المقصبي، ولاحقاً مدير إدارة التسجيل والفروع سالم المعداني في 18 و21 ديسمبر 2022 على التوالي. أُجْبِرَ المسؤولان على ترك منصبيهما فور إطلاق سراحهما.
وفي ظل الترتيبات الجديدة سُمِحَ لمنظمات قليلة في الشرقِ الليبي بالعمل في قطاعات محددة، على ألا تمارس أي أنشطة لا تتفق مع توجهات حكم عائلة حفتر. اشتُرط عليها الابتعاد عن أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تدعو للديمقراطية، وعن كل الأنشطة التي من شأنها أن تعارض نظام الحكم الذي ثُبت في شرق البلاد.
وقيدت سلطات شرق ليبيا العمل الإنساني وأعمال الإغاثة، لاسيما أثناء أحداث فيضانات درنة في سبتمبر 2023 وبعدها. إذ فرضت مفوضية المجتمع المدني في شرق البلاد موافقات أمنية للتجول لتوزيع المساعدات. وقد عايشتُ جزءاً من الصعوبات التي فرضتْها هذه الإجراءات أثناء إرسالنا المساعدات في أحداث الفيضانات، ولاحقا أثناء عملي سنتيْ 2023 و2024 في منظمة "العمل ضد الجوع".
هذا الصعود لم يكن تغييراً في السيطرة الأمنية على المناطق أو ممارسة نفوذ على مؤسسة واحدة، بل بدأت معه رسمياً عملية تحوّل المجموعات المسلحة إلى تنظيمات موازية تخترق الدولة الليبية. فالسلاح يوفر أمن بعض السياسيين والمسؤولين ومعه يصل قادة المجموعات المسلحة بسهولة إلى الموارد المالية، وتفرضُ به المجموعات المسلحة شخصيات بعينها في بعض المناصب. ومن يرفض من الوزراء والمسؤولين يُختطف أو يُهدد أو يُعتدى عليه.
ضغطت تلك المجموعات مثلاً لتعيين بعض السفراء والقناصل، مثل تعيين السيد محمد المرداس قنصلاً في تونس سنة 2017. واختطفت المجموعات المسلحة وزير الأوقاف في حكومة الوفاق عباس القاضي في أغسطس 2018، بغرض التأثير على ترتيبات إدارة ملف الحج الذي يحقق مكاسب مادية كبيرة.
كذلك استحوذت هذه المجموعات على المال وبدأت عبره بشراء السلاح وتجنيد المقاتلين، وشراء ذمم بعض المسؤولين. أسس هذا الأسلوب شكلاً من أشكال الدولة "الكليبتوقراطية"، وهو "نظام سياسي تُهيمن فيه نخبة حاكمة على مؤسسات الدولة، وتستغل سلطتها لنهب الموارد العامة"، كما جاء في كتاب الباحثة روز أكرمان "الفساد والحكومة" المنشور سنة 1999. وقد كانت النخبة في الحالة الليبية تحالفاً بين السياسيين والمجموعات المسلحة.
تطورُ طريقة عمل المجموعات المسلحة في هذا الإطار وصلَ ذروتَه منذ سنة 2021، في ظل سكوت الحكومة أو رضاها. وهو تطور دفع هذه المجموعات لاستراتيجيتيْن رئيستين. الأولى سعيها لتأمين نفسها قانونياً، فقد وجدت في اختراقها الأجهزةَ الأمنية التقليدية مثل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الداخلي وجهاز المخابرات أو الكتائب العسكرية أو تشكيل أجهزة أمنية وفق أطر قانونية، وسيلةَ حماية لها. والاستراتيجية الثانية الانفتاح على وسائل أخرى تعزز نفوذها وحكمها، وعلى رأسها العمل الإعلامي ثم اختراق العمل المدني والشعبي.
بدأ الأمر مع الأندية الرياضية. اخترق قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري سنة 2017 نادي الاتحاد بالدعم المادي. وفي سنة 2022 اخترق قادة "جهاز دعم الاستقرار"، سيف الككلي وعمه عبد الغني الككلي وأسامة طليش، مجموعة من الأندية أهمها نادي أهلي طرابلس. وهو سلوك مشترك مع قيادات المنطقة الشرقية، إذ ظهر خالد حفتر، نجل خليفة حفتر، وهو يدعم الكثير من الأندية الليبية. فضلاً عن قيادة بعض المقربين من عائلة حفتر بعضَ الأندية مثل نادي هلال بنغازي، الذي يقوده صهرهم علي الشريف منذ سنة 2022.
ولإحكام مزيدٍ من سيطرتها على أوجه أخرى من الحياة المدنية، اخترقت المجموعات المسلحة الاتحادات الطلابية، وأصبح اتحاد طلبة جامعة طرابلس، خاضعاً لأحد قادة المجموعات المسلحة القوية في المدينة منذ نوفمبر 2021. جاء ذلك بعد اعتقال محمد القبلاوي، رئيس اتحاديْ جامعة طرابلس واتحاد طلبة ليبيا، وصاحب التأثير القوي على الاتحاد الطلابي بفعل علاقاته السياسية والأمنية. أُطلق سراحه بعد سبعة أشهر دون إجراء قضائي محدد، وبالتالي بدا الاعتقال محاولةً لإزاحته من المشهد.
لم تتوانَ المجموعات المسلحة في غرب البلاد وشرقها كذلك عن اختراق العديد من مجالس الحكماء والأعيان وشراء ولائهم، ومجالس الحكماء هي التي تنسِّق مع الجهات المعنية في الدولة لتحقیق تواصلٍ محليٍّ ودوليٍّ. أسست هذه المجموعات أيضاً مجلس أعيان ومؤسسات مجتمع مدني جديدة. أسست المجموعات المسلحة حراكاً سياسياً ساهم في دعم موقف بعض المجموعات المسلحة ضد حكومة الدبيبة في أحداث مايو 2025.
أصبحت جماهير الأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني والحراك السياسي والاجتماعي، الذي رعته أو أسسته المجموعات المسلحة، وسيلةً للدفاع عنها وحمايتها في بعض الأحيان. فقد رفضت بعض مجموعات الأعيان في مدينة الزاوية غرب طرابلس العمليات الأمنية الموجهة ضد بعض العصابات الخارجة عن القانون بالمدينة. وكذلك دعمت مجالس القبائل والأعيان في شرق ليبيا العملية العسكرية التي أطلقها حفتر للسيطرة على طرابلس سنة 2019. وأحدثُ هذه الأمثلة الحملة الإعلامية التي رُصدت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت فيها جماهير نادي أهلي طرابلس في مايو 2025 للهجوم على حكومة الوحدة الوطنية التي تبنت عملية مقتل عبد الغني الككلي وإنهاء نفوذه في طرابلس.
وهكذا أصبحَ المجتمع المدني وسيلةً من وسائلِ المجموعات المسلحة والأطراف السياسية المتنازعة، لفرضِ نفوذها أو تحقيق شرعيةٍ لها في الشارع.
كان التقييم في كل عام يكون بجمع عشرة خبراء في المجتمع المدني على الأقل، وله أسس سبعة. الأساس الأول الإطار القانوني ثم الاستدامة المالية فالقدرات التنظيمية فتقديم الخدمات فالبنية التحتية القطاعية ثم المناصرة والصورة العامة، أي كيف ينظر المواطنون للمجتمع المدني. في السنوات الأربع كانت التقييمات تصنّف مؤسسات المجتمع المدني أنها تواجه "استدامة معاقة"، وهو أسوأ تصنيف تقريباً.
شمل التصنيف السلبي كل قسم من أقسام التقييم، باستثناء المناصرة نظراً لنجاح بعض المؤسسات في الدفع نحو بعض المطالب بفعل حملات المناصرة التي نظمتها. مثلاً، نجحت حملة المناصرة والتواصل لحراك "الاستفتاء أولاً" سنة 2017 في الضغطِ على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لتقليص سن الترشح للرئاسة إلى خمسة وثلاثين بدلاً من أربعين عاماً.
وأظهر ذلك التقييم أن أحد أوجه الإعاقة هو عدم وجود قانون لمنظمات المجتمع المدني، ما أدى إلى خلافٍ قانونيٍ حول اللوائح المنظمة. وهذا التحدي تسبب في إيقاف عمل الكثير من المؤسسات وتجميد حسابات أخرى ومنح الأجهزة الأمنية مساحة غير مقننة لتأويل القانون، ومنه بررتْ جزءاً من تقييدها المجتمعَ المدني.
أظهر التقييم أيضاً أن النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية تسببت في عرقلة مسار تطور مؤسسات المجتمع المدني. فقد توقف نشاط المؤسسات هذه أثناء الحرب، وقطع عنها التمويل في الحالات التي غادرت فيها المؤسسات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية سنة 2014. أضف على ذلك الصورة العامة السيئة لمؤسسات المجتمع المدني لدى كثيرٍ من المواطنين الليبيين والمسؤولين، الذين يجهلون أهميتها لغياب الذاكرة المؤسسية للمجتمع المدني في الفضاء العام قبل الثورة، مع استثناءات قليلة.
ازدادتْ منذ 2019 حملات خطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ نشطتْ بعض الصفحات في شيطنةِ مؤسسات المجتمع المدني، وكان من بين تلك الصفحات صفحاتٌ لأجهزة أمنية، مثل جهاز الأمن الداخلي. بل ساهمت مفوضية المجتمع المدني عبر رئيستها انتصار القليب، خاصةً في طرابلس، في تأليب الرأي العام المجتمعي ضد مؤسسات المجتمع المدني. هكذا شُكك في نوايا كل حملات مناصرة التظاهر أو الدعوات له، وانتهى الحال بكل حراكٍ يدعو للنزول للشارع إلى الأفول سريعاً. إذ لم يعرف كثيرٌ من القائمين على هذه المظاهرات الطرق التي تمكِّنهم من تحويل المطالب إلى حملات مناصرة منظمة، والتحول من التظاهر إلى التفاوض والضغط على السلطات.
ترافقتْ تجربتي البحثية الثانية مع مشاهد مظاهرات مايو 2025 ضد حكومة الوحدة الوطنية. كنتُ أعمل على بحث داخلي مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (وهي دراسة داخلية غير منشورة بعد) عن الدور المجتمعي في تعزيز الأمن والسلام في منطقة الساحل الغربي، الممتدة من غرب طرابلس وحتى الحدود التونسية. وهي منطقة تشهد نفوذاً وسيطرةً للجماعات المسلحة وصراعاً بينها على خطوط التهريب والنفوذ تحت غطاء مؤسسات أمنية مشرعة من الدولة.
كان من أبرز التصريحات التي تحصلتُ عليها من الذين قابلتهم لغرض الدراسة، أن نفوذ الجماعات المسلحة وقدراتها المالية أصبحت كافيةً لأن توفر حماية اجتماعية لها. فالمجالس الاجتماعية ومجالس الشيوخ والأعيان أصبحت تدافع عن أبنائها المنضمين لهذه المجموعات وترفض أي عمل ضدها بحجة الدعوة إلى أن يكون العمل ضد كل المجموعات في آن واحد. بينما تستميلُ هذه المجموعات نشطاءَ ومؤسسات في المجتمع المدني، لتبييض صورتها أو حتى للنزول للشارع متى طلب منها ذلك والمطالبة بمطالب تقف وراءها المجموعات المسلحة. عادةً تكون تنظيمات إجرامية منظمة لها واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية. إذ تختلطُ مطالبها التي ترتبط بمصالح ضيقة بمطالب الشعب في الكثير من الأحيان، كما هو الحال في بعض مناطق مدينة الزاوية.