لم تشهد قاعة الجمعية العامة تساؤلاتٍ موجّهة إلى نتنياهو أو حليفه الأمريكي بشأن الملف النووي الإسرائيلي، ولا عن عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها تل أبيب، أو عن التوسعات الملحوظة في محيط مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية – المعروف بِاسم "مفاعل ديمونا". فمنذ أن رفعت واشنطن سنة 2020 القيود على بيع صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي تطال الأرض الإسرائيلية، باتت الشركات التجارية قادرةً على نشر لقطاتٍ تكشف عن تفاصيل دقيقةٍ لمنشآتٍ حساسة. تمخّض هذا عن ظهور صور أعمال بناءٍ ضخمةٍ متعددة الطوابق قرب ديمونا، يُرجّح أن تكون مفاعلاً إضافياً أو منشأةً لتجميع الرؤوس النووية.
بينما ترفع إسرائيل لواء التحذير من "الخطر النووي الإيراني"، فإنها تملك برنامجاً نووياً غامضاً ظلّ بعيداً عن أيّ مساءلةٍ دوليةٍ منذ عقودٍ، في حين فتحت جبهات صراعٍ ممتدّةً على أكثر من ساحةٍ إقليمية. غير أن الصورة بدأت تتضح أكثر مع توالي التسريبات ورفع السرّية عن وثائق استخباراتيةٍ أمريكيةٍ مؤخراً، فضلاً عن دور صور الأقمار الاصطناعية المتزايد في كشف المستور. بهذا يبرز الحديث عن البرنامج النووي الإسرائيلي، بما يحيط به من غموضٍ منذ الستينيات، والملابسات التي رافقت نشأته واستمراره وتوسّعه وسط تفاهماتٍ سرّيةٍ مع واشنطن وصمتٍ دوليٍ ربما كان متعمّداً.
التقط فعنونو، الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، نحو ستّين صورةً لمناطق شديدة الحساسية داخل المنشأة. وكشف عن وجود مرفقٍ تحت الأرض مخصصٍ لإنتاج الرؤوس النووية، ودلائل على تصنيع البلوتونيوم والتريتيوم. البلوتونيوم عنصرٌ فلزّيٌ مشعٌّ ينتج في المفاعلات النووية، ويصلح وقوداً انشطارياً ويستخدم في الأسلحة النووية والمفاعلات. أما التريتيوم فنظيرٌ مشعٌّ للهيدروجين يستخدم في تفاعلات الاندماج النووي والأسلحة الهيدروجينية والأجهزة المضيئة. بل التقط فعنونو مؤشراتٍ على قدراتٍ حراريةٍ نيترونيةٍ قد تمهّد لإنتاج أسلحةٍ معزّزةٍ وربما حرارية. وقدّر التحقيق الترسانةَ حينها بما بين مئةٍ ومئتَي رأسٍ نووي. أما فعنونو فبرّر خطوته بأنها محاولةٌ لدقّ ناقوس الخطر والكشف عن "البرميل المتفجر" في قلب الشرق الأوسط.
ما كشف عنه العالِم النووي الإسرائيلي لا يزال حتى اليوم أوفى روايةٍ علنيةٍ عن القدرات النووية الإسرائيلية. فقد أوضح أن منشأة ديمونا كانت قادرةً على إنتاج نحو 1.2 كيلوغرامٍ من البلوتونيوم أسبوعياً، أي ما يكفي لصناعة نحو اثني عشر رأساً نووياً سنوياً. ووصف فعنونو المنشأة بأنها تضمّ طابقين فوق الأرض وستّة مستوياتٍ سرّيةٍ تحتها تُعرف بِاسم "مخون 2"، حيث يُفصل البلوتونيوم عن اليورانيوم. وتضمّنت الصور التي التقطها أدلّةً على عملياتٍ نشطةٍ لإنتاج البلوتونيوم ونماذج لقنابل نيوترونية. والقنبلة النيوترونية أقلّ قدرةً تفجيريةً من القنبلة الذرّية التقليدية، ولكنها تنفث درجاتٍ عاليةً من الإشعاع القاتل.

بذلت صحيفة الصنداي تايمز وقتاً وجهداً استثنائيَّيْن للتحقق من صحّة شهادة فعنونو. إذ سافر الصحفي بيتر هونام، الحاصل على شهادةٍ في الفيزياء، إلى أستراليا لمقابلة فعنونو واستمع إلى وصفٍ تفصيليٍ لمهامّه في المفاعل. بالتوازي، انتقل الصحفي ماكس برانغنيل إلى إسرائيل للتحقق من هوية فعنونو، فتواصل مع جامعة بن غوريون حيث درس فعنونو، واستقصى من جيرانه للتأكد من عمله في المفاعل. أما المحرّر بيتر ويلشر، فدقّق في جميع التفاصيل بحثاً عن أيّ تناقضاتٍ محتملة.
استعانت الصحيفة أيضاً بخبراء بارزين في واشنطن. منهم الفيزيائي الأمريكي ثيودور تايلور، أحد أبرز مصمّمي الأسلحة النووية وتلميذ الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، مدير "مشروع مانهاتن" لإنتاج السلاح النووي أثناء الحرب العالمية الثانية، والمعروف بلقب "أبو القنبلة الذرّية". ترأس تايلور لاحقاً برنامج البنتاغون لاختبار الأسلحة الذرّية. وبعد اطّلاعه على صور فعنونو وشهادته قال تايلور: "لم يعد هناك شكٌّ في أن إسرائيل دولةٌ نوويةٌ مكتملة الأركان منذ ما لا يقلّ عن عقدٍ من الزمن، وأن برنامجها متقدّمٌ جدّاً أكثر مما أشارت إليه أيّ تقارير أو تكهناتٍ سابقة".
وقبل نشر التحقيق، نجحت عميلةٌ إسرائيليةٌ في استدراج فعنونو إلى روما في سبتمبر 1986. ومن ثمّ اختطفه عملاء الموساد في شقّةٍ أُعدّت مسبقاً، وحقنوه بمادةٍ مخدّرةٍ ثم نقل سرّاً إلى إسرائيل على متن سفينة شحنٍ إسرائيلية.
وبعد نشر صحيفة صنداي تايمز البريطانية تفاصيل البرنامج النووي الإسرائيلي بناءً على معلومات فعنونو، أنكرت إسرائيل علاقتها باختفاء فعنونو في روما. لكن بعد أيامٍ قليلةٍ، ظهر فعنونو فجأةً في إسرائيل، في مشهدٍ التقطته كاميرات الصحافة صدفةً عندما كان يُنقَل إلى المحكمة. أثناء نقله من السجن إلى المحكمة، كان فعنونو محاطاً برجال أمنٍ إسرائيليين ولم يسمح له بالكلام. ولكنه كتب على راحة يده وعلى ذراعه بقلم حبرٍ أزرق جملتَيْن بالإنجليزية: "مردخاي فعنونو اختُطف في روما في 30 سبتمبر 1986 على يد جواسيس إسرائيليين" وعَرَضَها مِن على نافذة سيارة الشرطة، ما سمح للصحفيين بتصوير الرسالة رغم منعه من التواصل مع الإعلام.
حوكِم فعنونو محاكمةً سرّيةً، وحكم عليه بالسجن ثمانية عشر عاماً. وبعد الإفراج عنه في أبريل 2004 فُرضت عليه قيودٌ صارمةٌ، بينها منعه من الحديث مع الأجانب أو مغادرة البلاد. ومع اعتناقه المسيحية وتقديمه طلباً للتخلّي عن الجنسية الإسرائيلية والسفر، إلّا أنه ما زال يعيش في عزلةٍ تامةٍ ولا يظهر في الإعلام إلا نادراً. آخِر ظهورٍ له كان في سبتمبر 2015 على القناة الثانية الإسرائيلية، إذ قال: "كان ينبغي للعالم أن يعلم بوجود البراميل المتفجرة"، مشيراً بهذا إلى قنابل إسرائيل النووية.
بعد عودة ديفيد بن غوريون إلى رئاسة الحكومة سنة 1955، بعد استقالته منها العام السابق، أطلق مبادرةً سرّيةً لإجراء دراسة جدوى تهدف إلى تقييم إمكانية بناء بنيةٍ تحتيةٍ نوويةٍ تدعم برنامجاً يستهدف إنتاج متفجراتٍ نوويةٍ، والسبيل لتحقيق ذلك. فوّض بن غوريون هذه المهمة إلى شمعون بيريز، الذي كان يشغل آنذاك منصب المدير العام لوزارة الدفاع. وبين سنتَيْ 1955 و1958، نجح بيريز في تحويل فكرة البرنامج من رؤيةٍ مستقبليةٍ غامضةٍ إلى مشروعٍ تقنيٍ عملي.
جاءت مبادرة بن غوريون ردّاً على صفقة التسليح المصرية التشيكوسلوفاكية سنة 1955، التي حصلت مصر بموجبها على طائراتٍ ودباباتٍ ومدفعيةٍ ومركباتٍ مصفّحةٍ بقيمة ثمانين مليون دولارٍ من الاتحاد السوفييتي. عدّت إسرائيل الصفقةَ تحولاً استراتيجياً قد يغيّر ميزان القوى التقليدية في المنطقة، وذلك وفقاً لما أورده الصحفي المصري محمد حسنين هيكل في كتابه سنة 1973 بعنوان "وثائق القاهرة [. . .]".
وبخلاف رأي رئيس لجنة الطاقة الذرّية الإسرائيلية، ديفيد إرنست بيرغمان، الذي كان يدعو إلى الاعتماد على الذات، رأى بيريز أن إسرائيل لا يمكنها ولا ينبغي لها إعادة اختراع كلّ شيء. ولذلك كان ضرورياً العثور على مورّدٍ أجنبيٍ قادرٍ على تزويدها بحزمةٍ تقنيةٍ شاملةٍ يمكن أن يعاد توجيهها لتستخدَم عسكرياً.
بحسب المؤرخ الأمريكي الإسرائيلي المختصّ في دراسات الحدّ من الانتشار النووي، أفنِر كوهين، في كتابه الصادر سنة 1998 بعنوان "إزرايل آند ذا بمب" (إسرائيل والقنبلة)، فقد تبلورت بحلول أواخر الخمسينيات خطة المشروعِ الدولية الرئيسة. وفق الخطة تكون فرنسا المورّد الأساس للتقنية، وتساهم دولٌ أخرى من بينها النرويج بمكوناتٍ مثل الماء الثقيل، في حين تقدّم الولايات المتحدة مساعداتٍ مدنيةً تحت مظلّة مبادراتٍ مثل "ذرّات من أجل السلام"، التي بدت غطاءً سياسياً لتخفيف الشبهات حول المشروع الحقيقي.
أثّرت عوامل سياسيةٌ وأمنيةٌ داخليةٌ وإقليميةٌ في تسريع تنفيذ المشروع. فبحسب ما أورده شمعون بيريز في مذكراته الصادرة سنة 1995 بعنوان "باتلينغ فور بيس" (النضال من أجل السلام)، فإن صعود الرئيس المصري جمال عبد الناصر وتحالفه مع الاتحاد السوفييتي، إلى جانب تداعيات حرب السويس سنة 1956 عندما شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجوماً عسكرياً على مصر إثر تأميم قناة السويس، زاد من مخاوف إسرائيل من تعاظم التهديدات الإقليمية. وأدّت الضغوط الدولية والتهديدات المتبادلة أثناء الأزمة إلى توثيق الروابط العسكرية بين إسرائيل وفرنسا، ما شجّع جهاتٍ فرنسيةً على الموافقة على تزويد إسرائيل بمفاعل أبحاثٍ أكبر من ذلك الذي كان معروضاً في البداية.
وفي خريف 1956، رُقيّت خطط المفاعل التجريبي الصغير إلى مشروع مُفاعلٍ أكبر لإنتاج البلوتونيوم، فصُمّم على غرار مفاعلاتٍ فرنسيةٍ مثل مفاعل ماركول. وبعد مفاوضاتٍ مطوّلةٍ، وقّع شمعون بيريز في 30 أكتوبر 1957 اتفاقاً لتوريد حزمةٍ تقنيةٍ وماديةٍ عُرفت لاحقاً بِاسم "حزمة ديمونا".
تشير وثائق استخباراتيةٌ أمريكيةٌ، رُفعت عنها السرّية في الفترة من أبريل 2015 إلى يونيو 2025، إلى أن بناء المفاعل بدأ في أواخر الخمسينيات، وتقدّم العمل بسرعةٍ ليكتمل بحلول أوائل الستينيات. وقد بدأ تشغيله بين عامَيْ 1962 و1963. ولحجم المشروع والسرّية المحيطة به، أنشأت إسرائيل وكالة استخباراتٍ جديدةً بِاسم "مكتب الارتباطات العلمية" (ليكِم) لتوفير الأمن والمعلومات الاستخباراتية لمشروع ديمونا. وفي ذروة أعمال البناء، عمل في المشروع نحو ألفٍ وخمسمئة شخصٍ، معظمهم من الإسرائيليين إلى جانب عددٍ من الفنّيين الفرنسيين.
كانت السرّية المحيطة بمفاعل ديمونا ضروريةً لحمايته في مراحله الأولى، وهدفت خصوصاً إلى إخفاء جوانب المشروع العسكرية عن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة منذ تقديمها "خطّة باروخ"سنة 1946 (نسبةً إلى الأمريكي برنارد باروخ) للأمم المتحدة للسيطرة على التسلح النووي، من أبرز الداعين إلى فرض رقابةٍ دوليةٍ على الطاقة النووية. ومن المؤسِّسين لاحقاً لهيئاتٍ رقابيةٍ مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرّية المدشّنة سنة 1957، ونظام ضماناتها.
ففي الأشهر الأخيرة من سنة 1960، ومع اقتراب نهاية رئاسة دوايت آيزنهاور، اكتشفت الحكومة الأمريكية أن إسرائيل تبني بمساعدةٍ فرنسيةٍ مفاعلاً نووياً سرّياً بالقرب من مدينة ديمونا في صحراء النقب قد يؤهلها لإنتاج أسلحةٍ نووية. أثار هذا الاكتشاف قلقاً داخل إدارة آيزنهاور، إذ تصاعدت المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وانتشار الأسلحة النووية. وزاد الانزعاج بسبب مراوغة المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يقدّموا إجاباتٍ موثوقةً عن طبيعة المشروع.
جرت إحدى الحوادث التي عمّقت الشكوك حين كان السفير الأمريكي في تل أبيب أوغدن ريد في رحلةٍ بطائرة مروحيةٍ في سبتمبر 1960، فسأل ريد مضيفَه الإسرائيليَّ والمسؤولَ الكبيرَ في وزارة الخزانة آدي كوهين عن طبيعة منشأة البناء الضخمة التي مرّوا فوقها. أجابه كوهين بأنها "مصنع نسيج".
وفي ديسمبر من العام نفسه أعلن ديفيد بن غوريون أمام الكنيست الإسرائيلي أن مفاعل ديمونا مشروعٌ علميٌّ مدنيٌّ بحتٌ لتدريب العلماء الإسرائيليين على استخدام الطاقة النووية لأغراض التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه "مخصصٌ للأغراض السلمية فقط". تشير الوثائق إلى أنه في مراسلاته الخاصة مع الولايات المتحدة، قدّم بن غوريون تفاصيل إضافيةً تتماشى تماماً مع روايته العلنية. وكأن إستراتيجية الغموض والخداع المحدود مفيدةٌ لامتصاص الغضب الأمريكي وتجنّب مواجهةٍ علنيةٍ مع أمريكا، مع الحفاظ على الهدوء الداخلي والإقليمي.
لم تُبدِ إدارة آيزنهاور رغبةً في الكشف عن خداع بن غوريون علناً أو سرّاً. ولم يكن الرئيس وهو في الأيام الأخيرة من ولايته مهتماً بإثارة أزمةٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل التي كانت تحظى بدعمٍ قويٍ داخل الولايات المتحدة. لذلك تُرك الملف لوزارة الخارجية بهدف احتواء الأزمة دبلوماسياً إلى حين تسلّم إدارة جون كينيدي السلطة.
في أبريل 2016 نشرت وثائق تعود إلى عهد إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي تظهر أنه تعامل مع مفاعل ديمونا تهديداً مباشراً لسياسة منع الانتشار النووي. رأى الرئيس الأمريكي أن الغموض الإسرائيلي يفتح الباب أمام سباق تسلّحٍ نوويٍ في الشرق الأوسط. لذلك ضغط على بن غوريون للسماح بعمليات تفتيشٍ متكررةٍ، بل سعى لإشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في مراقبة المفاعل.
غير أن الزيارات الأمريكية المحدودة في 1961 و1962 لم تقنع وكالة الاستخبارات المركزية بسلمية البرنامج النووي الإسرائيلي حسب ادعاءات بن غوريون. وخلصت إلى أن إسرائيل تعمل على وضع نفسها في موقعٍ يسمح لها بإنتاج قنابل نوويةٍ في سنوات قليلة.
وظهر كشفٌ آخَر في دفعة الوثائق المنشورة في ديسمبر 2024 التي تضمّنت وثيقةً مؤرخةً في الثاني من ديسمبر سنة 1960 صادرةً عن اللجنة المشتركة للاستخبارات الذرّية الأمريكية (جايك). خلصت اللجنة إلى أن المشروع النووي الإسرائيلي في النقب الذي تشارك فيه فرنسا بتوريد موادّ ومعدّاتٍ وخبراء ليس مشروعاً تجريبياً صغيراً، بل منشأةً نوويةً صناعيةً كبيرةً قادرةً على تشغيل مفاعلٍ ينتج البلوتونيوم بكمّياتٍ كافيةٍ لإنتاج أسلحةٍ نووية. مع وجود منشأةٍ موازيةٍ لمعالجة البلوتونيوم قرب بئر السبع.
وبحسب جداول التنفيذ التي بدأت تحضيراتها سنة 1958 وتواصلت أعمال البناء فيها سنة 1959، رأت اللجنة أن إسرائيل قد تنتج نحو ثلاثين كيلوغراماً من البلوتونيوم بدرجةٍ تسليحيةٍ بحلول منتصف 1962، وربما ستّين كيلوغراماً سنوياً بحلول سنة 1963. وهو ما يضعها في موقعٍ يمكّنها من تصنيع سلاحٍ نوويٍ أو إجراء تجربةٍ ربما في موقعٍ فرنسي. فأوصت الوثيقة بإجراء دراسةٍ تفصيليةٍ سرّيةٍ، مشيرةً إلى حساسية التعاون الفرنسي الإسرائيلي ودوافعه الإستراتيجية.
في 25 يونيو 2025، وبعد ثلاثة أيامٍ فقط من الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، كشف الأرشيف الأمني القومي الأمريكي عن دفعةٍ جديدةٍ من وثائق البرنامج النووي الإسرائيلي. ففي حين كانت أمريكا تحاول منع إيران من تكرار "النموذج الإسرائيلي"، أظهرت الوثائق أن الإدارة الأمريكية كانت على علمٍ مبكرٍ بتفاصيل مشروع ديمونا.
إحدى الوثائق تضمّنت شهادة أستاذ الهندسة النووية في جامعة ميتشيغان، هنري غيه غومبيرغ، الذي زار إسرائيل سنة 1960 ضمن برنامجٍ تدريبيٍ في "معهد التخنيون" وهو معهد إسرائيل للتقنية في حيفا. وأثناء زيارته اكتشف أن الإسرائيليين يعملون على مشروعاتٍ لم يُسمح له بالاطلاع عليها. قبيل مغادرته، أبلغ غومبيرغ السفيرَ الأمريكيَّ أوغدن ريد وفريقَه بمخاوفه من أن العلماء الإسرائيليين يسعون لإنتاج كمّياتٍ من البلوتونيوم تكفي لتصنيع سلاحٍ نوويّ. ورجّح أن إسرائيل ستتمكن من امتلاك قنبلةٍ خلال أقلّ من عقد. ولم تمضِ سوى ستّ سنوات تقريباً، أي في نوفمبر 1966، حتى طوّرت إسرائيل أوّل قنبلةٍ نوويةٍ ممكنة الاستخدام.
الوثائق المفرج عنها في يونيو 2025 أظهرت أن الولايات المتحدة انتهجت سياسةً مزدوجةً حيال الانتشار النووي بين سنتَيْ 1969 و1977. فقد ضغطت ضغوطاً قصوى على دولٍ مثل الهند وكوريا الجنوبية، مقابل تجاهلٍ مقصودٍ للبرنامج الإسرائيلي. فبعد أن بلغ مفاعل ديمونا مرحلة إنتاج رؤوسٍ نوويةٍ، فضّلت أمريكا التعايش مع "الغموض النووي الإسرائيلي" بدلاً من مواجهةٍ علنيةٍ، معتبرةً أن موقع إسرائيل الإقليمي يجعل احتواءها سياسياً أجدى من معاقبتها.
تبلور هذا الموقف الأمريكي في خريف 1969 عندما التقت رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير بالرئيس ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض. وقد تمخّض اللقاء عن "تفاهمٍ نووي" سرّيٍ غير مكتوبٍ يقضي بالتزام إسرائيل بعدم الإعلان عن امتلاكها السلاحَ النووي أو إجراء تجارب نوويةٍ، مقابل تجاهل أمريكا الأمرَ. ما يعني، وفقاً لأفنر كوهين في حوارٍ مع صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية في يوليو 2025، أن الولايات المتحدة تعاملت مع إسرائيل "دولةً نوويةً من نوعٍ خاص".
تعرّض هذا التفاهم لهزّةٍ في سبتمبر 1979 عندما رَصَدَ قمرٌ اصطناعيٌ أمريكيٌ من طراز "فيلا" ومضةً مزدوجةً فوق جنوب الأطلسي، فُسّرت بأنها إشارةٌ إلى اختبارٍ نوويٍ جوّيٍ منخفض العائد. وفي حين خلصت لجنةٌ من العلماء شكّلها البيت الأبيض في أكتوبر 1979 إلى أن فرضية الاختبار النووي غير مرجّحةٍ، ظهرت سنة 1980 أدلّةٌ إضافيةٌ شكّكت في نتائج اللجنة. استشهد جاك فارونا، المسؤول الكبير في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، ببياناتٍ صوتيةٍ مائيةٍ تشير إلى حدث تفجيرٍ نوويٍ تحت سطح المحيط. واعتبر فارونا أن تقرير لجنة البيت الأبيض كان تستّراً سياسياً لتجنّب أزمةٍ دبلوماسية. فيما رجّحت الاستخبارات الأمريكية أن يكون القمر الاصطناعي فيلا قد رصد تجربةً نوويةً إسرائيليةً بمساعدة جنوب إفريقيا.
الرئيس جيمي كارتر بدا متوجساً من احتمال خرق إسرائيل تفاهمَ "الغموض النووي". ففي يومياته كتب أن الاحتمال يدور بين "انفجارٍ نوويٍ في منطقة جنوب إفريقيا، إمّا من جنوب إفريقيا أو من إسرائيل، أو لا شيء". لكنه عاد في فبراير 1980 ليسجّل أن هناك "اعتقاداً متزايداً بين علمائنا بأن الإسرائيليين أجروا فعلاً تجربةً نوويةً قرب جنوب إفريقيا".
غير أن اعتبارات السياسة الخارجية حالت دون إعلان موقفٍ رسميٍ، إذ كان تأكيد مسؤولية إسرائيل سيهدّد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الوليدة. كذلك كان سيفرض على واشنطن فرض عقوباتٍ ملزمةً على إسرائيل وفق قوانين منع الانتشار النووي. لذلك تجاهلت الإدارة الأمريكية تقرير فارونا، في خطوةٍ وصفت لاحقاً بأنها "تبييضٌ سياسيّ" لتفادي أزمة. وقد أقرّ مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ستانسفيلد تيرنر في التسعينيات أنه ظلّ مقتنعاً بأن الوميض كان اختباراً نووياً إسرائيلياً حقيقياً.
وراء هذه الموادّ تقف شبكةٌ من الحكومات والشركات والوسطاء التجاريين الذين استخدموا وسائل قانونيةً وأخرى سرّيةً لتأمين كلّ ما يلزم لتشغيل مفاعل ديمونا.
كان لفرنسا دورٌ مهمٌّ في تأسيس البنية التحتية التي مكّنت إسرائيل من الانطلاق نحو برنامجٍ نوويٍ مستقلّ. بدأ الدور الفرنسي في الاتفاق السرّي من أواخر الخمسينيات ما أدّى إلى تزويد إسرائيل بمفاعل ديمونا الكبير وبناء منشأةٍ تحت أرضيةٍ متكاملة. ثمّ واصلت تزويدها بشحناتٍ أوّليةٍ من وقود المفاعل ومخططاتٍ فنّيةٍ لعمليات إعادة المعالجة.
وللحفاظ على السرّية أثناء نقل هذه المواد لإسرائيل، أُبلغ مسؤولو الجمارك الفرنسيون بأن أكبر مكونات المفاعل، مثل خزّان المفاعل، أجزاءٌ من محطةٍ لتحلية المياه متجهةٍ إلى أمريكا اللاتينية. وخرقت القوات الجوية الفرنسية الاتفاق مع النرويج الذي نصّ على عدم نقل الماء الثقيل إلى طرفٍ ثالثٍ، بنقل ما يصل إلى أربعة أطنانٍ من هذه المادّة إلى إسرائيل سرّاً. وقد زوّدت فرنسا إسرائيل بمفاعلٍ ذي قدرةٍ مُعلَنةٍ تراوحت من أربعةٍ وعشرين إلى ستّةٍ وعشرين ميغاواط. لكن إسرائيل زادت قدرته سرّاً، وفق تقديراتٍ بحثيةٍ، فوصل إلى نحو سبعين ميغاواط ثمّ إلى مستوياتٍ أعلى تختلف التقديرات بشأنها.
اعترف فرانسيس بيرين، المفوّض السامي للطاقة الذرّية في فرنسا، في أكتوبر 1986 عقب تسريبات مردخاي فعنونو أن فرنسا لم تكتفِ بتزويد إسرائيل بمفاعل ديمونا وحسب، بل ساعدتها كذلك في بناء منشأةٍ تحت الأرض لاستخلاص البلوتونيوم. مع إقراره بأن الجانب الفرنسي كان على علمٍ بإمكانية استخدام البلوتونيوم لأغراضٍ عسكرية.
ومع أن باريس غيّرت نهجها سنة 1965 بقرارٍ من شارل ديغول لتقليص التعاون العسكري المباشر مع إسرائيل، إلّا أن المرحلة المبكرة بين أواخر الخمسينيات وبدايات الستينيات شكّلت دفعةً قويةً للمشروع النووي الإسرائيلي. فقد أتاح الدعم الفرنسي الوثائقي والفنّي والتقني لإسرائيل أن تراكِمَ تدريجياً خبراتِها العلميةَ والهندسيةَ، إلى أن تمكّنت في سبعينيات القرن العشرين من إنشاء قدرةٍ محليةٍ أوليةٍ على إعادة إنتاج المواد الانشطارية.
تورّطت مع فرنسا كلٌّ من النرويج والمملكة المتحدة في تزويد مفاعل ديمونا بالماء الثقيل، المادّة الحيوية لتشغيله. تعود القصة إلى سنتَيْ 1959 و1960 عندما أبرمت شركة "نورأتوم" النرويجية صفقةً سرّيةً نقلت بموجبها نحو عشرين طنّاً من الماء الثقيل إلى إسرائيل. لم يكن البيع مباشراً، إذ مرّت الشحنة عبر بريطانيا التي سمحت بإعادة تصدير فائضٍ من مخزونها إلى النرويج، مع شكوكٍ دارت حول علمها بأن الوجهة النهائية ستكون المفاعل الإسرائيلي. أضيفت لاحقاً شحنةٌ صغيرةٌ من الولايات المتحدة بلغت نحو أربعة أطنانٍ، خضعت لشروط تفتيشٍ صارمةٍ من الجانب الأمريكي، في حين وُرِّدَ الماء الثقيل النرويجي البريطاني بلا قيودٍ رقابيةٍ، ما أتاح لإسرائيل تشغيل المفاعل وإنتاج البلوتونيوم بعيداً عن رقابةٍ دوليةٍ فعّالة.
في نوفمبر 1986، تزامناً مع تسريبات فعنونو، نشر مشروع ويسكونسن تقريراً بعنوان "ظلّ إسرائيل النووي" كشف عن تفاصيل الصفقة. وأشار إلى أن الماء الثقيل استخدمته إسرائيل لأغراضٍ عسكرية. وتحت ضغطٍ إعلاميٍ طالبت النرويج بإعادة الشحنات أو السماح بعمليات تفتيش. لكن إسرائيل رفضت بحجّة أن الماء الثقيل قد اختلط بموادّ أخرى، ما أشعل الجدل مجدداً عن شفافية برنامجها النووي.
وإلى جانب الماء الثقيل والمكونات التقنية الأخرى، كان الحصول على اليورانيوم الطبيعي شرطاً أساساً لاستدامة تشغيل مفاعل ديمونا وإنتاج البلوتونيوم. ففي مطلع الستينيات لجأت إسرائيل إلى صفقاتٍ سرّيةٍ مع دولٍ بعيدةٍ عن الرقابة النووية الصارمة. وكشفت وثائق أمريكيةٌ وبريطانيةٌ رُفع عنها الحظر أن إسرائيل اشترت سرّاً من الأرجنتين ما بين ثمانين إلى مئة طنٍّ من أكسيد اليورانيوم في سنتَيْ 1963 و1964، بعيداً عن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. وهو ما وفّر للمفاعل مخزوناً كافياً من الوقود الانشطاري.
ثمّ اتصلت قنوات التوريد مع جنوب إفريقيا التي زوّدت إسرائيل بكمّياتٍ من اليورانيوم الطبيعي منتصف الستينيات، قبل أن تتوسع المعاملات في السبعينيات والثمانينيات على هيئة تبادلاتٍ مادّيةٍ شملت اليورانيوم مقابل التريتيوم. وتشير وثائق وزارة الخارجية الأمريكية من تلك الحقبة بوضوحٍ إلى هذه التبادلات، فيما تضمّ ملفات أرشيف الأمن القومي الأمريكي شهاداتٍ عن شحناتٍ متعدّدةٍ من اليورانيوم الأصفر كان بعضها مخزّناً في إسرائيل. وبرز في تلك العمليات اسم الوسيط الجنوب إفريقي يوهان بلاو، العميد في جيش جنوب إفريقيا حينئذ.
غير أن السفينة "شيرسبيرغ أ"، التي أبحرت من ميناء أنتويرب البلجيكي لم تصل إلى وجهتها الإيطالية في ميناء جنوة، وإنما وصلت إلى ميناء إسكندرونة التركي دون حمولتها. وكان من الممكن تحويل اليورانيوم المنقول في البراميل إلى مادّةٍ خامٍ كافيةٍ لإنتاج عشرات القنابل النووية. بالنسبة إلى يوراتوم والأجهزة الأمنية الألمانية والإيطالية، فقد اختفت الشحنة عن وجه الأرض.
جاء طرف الخيط الذي كشف عن القصة مصادفةً، حين استجوبت الشرطة النرويجية مشتبهاً به في قضية مقتل نادلٍ من أصولٍ مغربيةٍ يدعى أحمد بوشيقي سنة 1973. استهدفت بوشيقي فرقة اغتيالاتٍ تابعةٌ للموساد ظنّاً منها أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة مسؤول مجموعة "أيلول الأسود" المتهم بالتخطيط لعملية ميونيخ التي طالت الوفد الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ في سبتمبر 1972. أثناء الاستجواب، فيما بات يُعرف بِاسم "قضية ليلهامر" (نسبةً للبلدة النرويجية التي قُتل فيها دوشيقي)، كشف المشتبه به أنه كان أحد أفراد "فرق الاغتيال" الإسرائيلية السرّية المكلَّفة بتصفية "الإرهابيين العرب". وتحدث أنه كان يمتلك سابقاً سفينة تدعى "شيرسبيرغ أ". كانت إسرائيل الوجهة المتوقعة لليورانيوم المفقود، إذ كانت من الدول القليلة التي تمتلك مفاعلاً نوويا قادراً على تحويل خام اليورانيوم إلى بلوتونيوم يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
وفي تقريرٍ نشرته مجلة "تايم" الأمريكية سنة 1977، تبيَّن أن الإسرائيليين اعتمدوا على ضماناتٍ غير رسميةٍ من الحكومة الائتلافية الألمانية الغربية برئاسة المستشار الديمقراطي المسيحي كورت جورج كيسنجر، سمحت لهم بإخفاء عملية الشراء تحت غطاء صفقةٍ تجاريةٍ خاصةٍ في ألمانيا الغربية.
في هذه القضية، كان لدى مهندس الإلكترونيات الأمريكي ريتشارد كيلي شركةٌ تصنّع رقاقات "كريبتون"، وهي رقاقاتٌ إلكترونيةٌ دقيقةٌ تستخدم لضبط التوقيت في تفجير الرؤوس النووية. وقد صدّر سميث نحو ثمانمئةٍ وخمسين رقاقة "كريبتون" إلى شركةٍ إسرائيليةٍ تدعى "هيلي تريدينغ". وكانت الشركة واجهةً لعملياتٍ سرّيةٍ مرتبطةٍ برجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلخان.
كشفت وسائل إعلامٍ أمريكيةٌ منها لوس أنجلوس تايمز عن تفاصيل القضية، مؤكدةً أن ميلخان – الذي عرف لاحقاً منتجاً سينمائياً في هوليوود – كان على صلةٍ بـمكتب الارتباطات العلمية (ليكم) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والمسؤول عن تأمين التقنية الأجنبية للبرنامج النووي. وأظهرت التحقيقات أن العملية كانت جزءاً من شبكة تهريبٍ منظمةٍ استغلت شركاتِ واجهةٍ وثغراتٍ في لوائح التصدير الأمريكية، إذ أزيلت الكريبتونات مؤقتاً من قائمة المواد المحظورة سنة 1980 قبل أن تعاد إليها سنة 1984 مع تشديد الرقابة.
وفي سنة 2002، وبعد سنواتٍ من فرار سميث إلى إسبانيا، أدين أمام محكمةٍ في لوس أنجلوس بتهم خرق قوانين تصدير الأسلحة والإدلاء بتصريحاتٍ كاذبة. وصدر بحقّه حكمٌ بالسجن أربعين شهراً وغرامةٍ قدرها عشرون ألف دولار.
ومع أن إسرائيل أعادت نحو خمسمئة جهازٍ من تلك الأجهزة، إلّا أن القضية مثّلت دليلاً على سعي إسرائيل المتواصل للحصول على تقنيةٍ نوويةٍ متقدمةٍ خارج الأطر الرسمية. وأبرزت مدى تشابك الصناعات الدفاعية الأمريكية الإسرائيلية في ظلّ سياسة "الغموض النووي" التي تتبعها إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي.
في البداية اعتمدت التقديرات على إفادات موردخاي فعنونو. إلّا أن دراساتٍ لاحقةً أعادت تقييم تلك الأرقام مستندةً إلى منهجياتٍ علميةٍ أكثر صرامةً، فقلّصت العدد المقدّر. تراوحت الأرقام المنشورة بين خمسةٍ وسبعين وأربعمئة رأسٍ نووي. إلّا أن التقدير الأوثق صدر في يناير 2022 ضمن سلسلة المفكرة النووية "نيوكلِيَر نوتبُوك" التي تصدرها مجلة نشرة علماء الذرّة "بُلِتِن أُف ذي أَتُومِك سايِنتِسْتس"، إذ قدّر الباحثان في المؤسسة هانز مولر كريستنسن ومات كوردا عددَ الرؤوس النووية الإسرائيلية بنحو تسعين رأساً فقط. ويُرجّح أن هذه الأسلحة تعتمد على قنابل انشطاريةٍ معزَّزةٍ، لا على قنابل هيدروجينيةٍ متطورةٍ ثنائية المرحلة.
يشير كريستنسن وكوردا إلى أن امتلاك إسرائيل مخزوناً من البلوتونيوم لا يعني بالضرورة وجود عددٍ مماثلٍ من الرؤوس الجاهزة. إذ إن جزءاً من البلوتونيوم يُخزّن أو يُعاد تدويره، فيما تستهلك عمليات المعالجة جزءاً من الكتلة المنتجة.
ثمّة دراسةٌ أخرى نُشرت في نوفمبر 2021، أعدّها الباحثان ألكسندر غلاسرو وجوليان دي لانفيرسين، حلّلت أداء مفاعل ديمونا منذ سنة 1964 حتى نهاية 2020. وقدّرت إنتاجه من البلوتونيوم من سبعمئةٍ وثلاثين إلى تسعمئةٍ وثلاثين كيلوغراماً، وهي كميةٌ تكفي لصنع مئةٍ وخمسين إلى مئةٍ وتسعين رأساً نووياً، لكنها لا تعني بالضرورة أن كلّ هذه المادة حُوّلت إلى أسلحة.
صِيغَ التعديل ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وحمل لاحقاً اسمَيْهما، ليُعرف بِاسم "تعديل كايل بينغمان". ومع أن النص بدا في ظاهره تقنياً وتنظيمياً، إلا أن خلفيته السياسية كانت حاضرة. إذ جاء ثمرةَ ضغوطٍ إسرائيليةٍ مكثفةٍ هدفت إلى منع الكشف عن منشآتٍ شديدة الحساسية، أبرزها مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب. وبموجب التعديل، تولّت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية مراقبة التراخيص الممنوحة للشركات الأمريكية الكبرى مثل ديجيتال غلوب وماكسار وبلانِت لابس، ما جعل إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي حظيت بحمايةٍ قانونيةٍ تمنع تصوير أراضيها بدقّةٍ عالية.
ظلّ هذا الحجب قائماً أكثرَ من عقدين، ما جعل مفاعل ديمونا وملحقاته بمنأىً عن أعين الباحثين والمنظمات الدولية والصحافة الاستقصائية، حتى كسرت هذه العزلة تدريجياً مع تصاعد المنافسة العالمية في صناعة الأقمار الاصطناعية ودخول شركاتٍ أوروبيةٍ وآسيويةٍ تقدّم صوراً بدقّةٍ تصل إلى أربعين سنتيمتراً لكلّ بكسل. ما أجبر واشنطن في نهاية المطاف على رفع القيود والرقابة التقنية في يوليو سنة 2020. فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عبر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن تعديلٍ يسمح للشركات الأمريكية ببيع صورٍ لإسرائيل بالدقة ذاتها التي تتيحها الشركات الأجنبية المنافسة.
رفع القيود شكّل نقطة تحوّلٍ في قدرة الباحثين والصحافة الاستقصائية على تتبّع التطورات داخل مجمع ديمونا. وفتح القرار البابَ أمام تدفّق صورٍ عالية الوضوح من شركاتٍ مثل ماكسار وبلانِت لابس، لتكشف تباعاً عن مشهدٍ جديدٍ داخل مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في ديمونا. أظهرت الصور الملتقطة منذ سنة 2021 أعمالَ حفرٍ وإنشاءٍ واسعةً في الجزء الجنوبي الغربي من المجمع، شملت بنيةً خرسانيةً ضخمةً متعددة الطوابق محاطةً بجدرانٍ ترابيةٍ واقية.


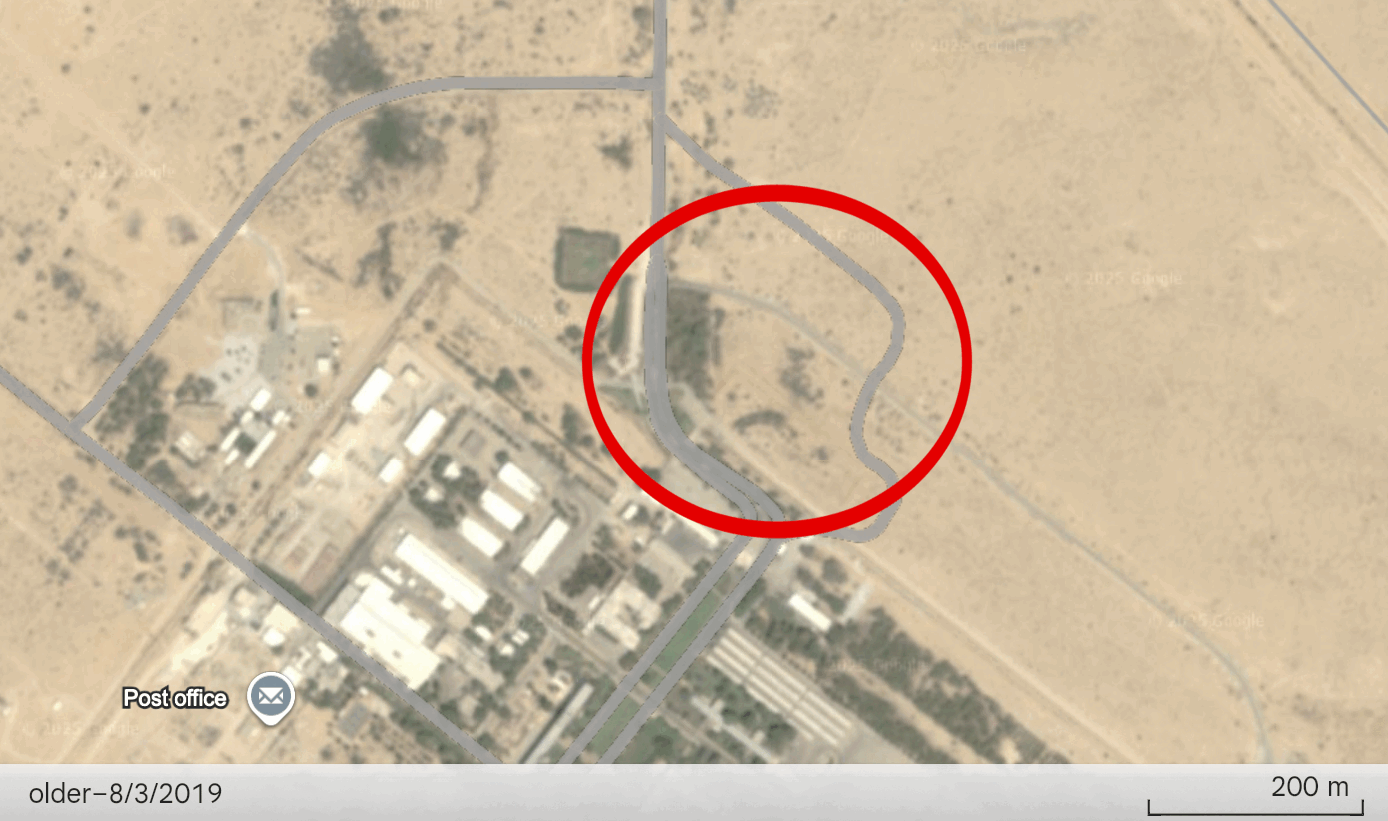
وباستخدام أدوات المصادر المفتوحة (أوسينت)، حلّلت الفراتس صورَ الأقمار الاصطناعية التي أتاحتها غوغل إيرث حتى نهاية سنة 2024. وأظهر التحليل أن مجمع مفاعل ديمونا (مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية) شهد تغييراتٍ لافتةً في الجزء الجنوبي الغربي منه. ففي أغسطس 2021، ظهرت أعمال حفرٍ بيّنةٌ في الموقع، وبرزت أساساتٌ إنشائيةٌ ضخمةٌ محاطةٌ بجدرانٍ ترابية. ومع مرور الوقت، ووفقاً لتتابع الصور، استمر العمل بوتيرةٍ بدت متصاعدةً في سنة 2023، حتى أخذ شكلَ مبنىً ضخمٍ متعدّد الطوابق.
أظهر الإطار الزمني حتى 28 ديسمبر 2024 أن المبنى وصل إلى مرحلةٍ شبه مكتملةٍ، إذ يمكن للمرء تمييز الهيكل العلوي بيسرٍ نسبيٍّ، ضمن محيطٍ هندسيٍّ منظمٍ يوحي بأن الموقع جزءٌ من توسعةٍ رئيسةٍ، وليست مجرد أعمال صيانةٍ أو إنشاءٍ ثانوي.
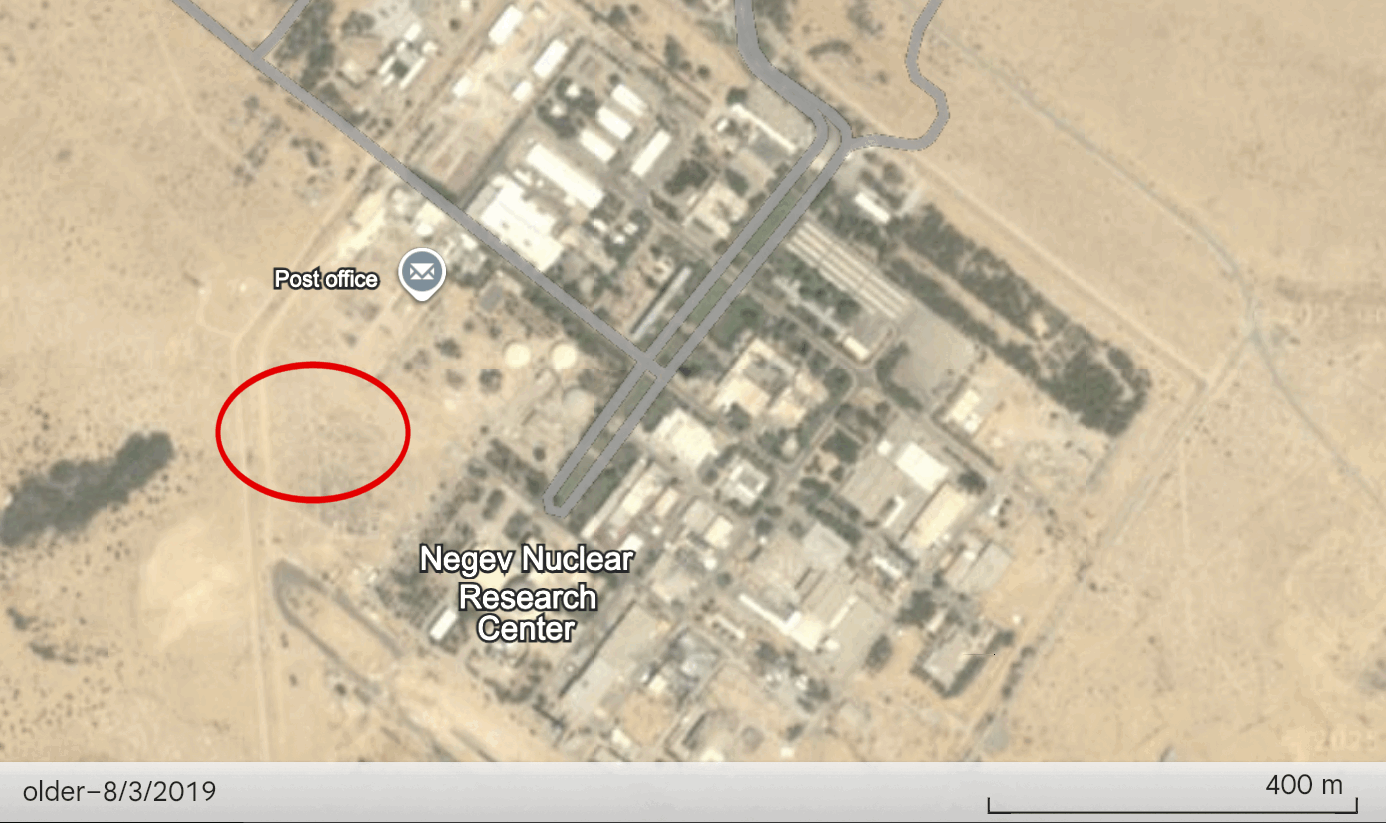

بالتوازي مع إنشاء المبنى الضخم ظهرت أيضاً أعمالٌ إنشائيةٌ إضافيةٌ، وإن كانت أصغر حجماً، قد تشير إلى عملية تطويرٍ متكاملةٍ للبنية التحتية داخل المجمع. ففي الجهة الشمالية الغربية من مركز شمعون بيريز رصدت منذ مطلع سنة 2021 أعمال توسعةٍ وتعبيد طرقٍ جديدةٍ استمرت حتى نهاية سنة 2024. إلى جانب مبنىً صغيرٍ شيّد بجوار المنشأة الأكبر حجماً التي برزت في الصور اللاحقة. قد تشير هذه التطورات إلى أن المشروع لا يقتصر على مبنىً واحدٍ، بل يمثّل جزءاً من خطة توسعةٍ شاملةٍ تهدف إلى إعادة تنظيم أجزاءٍ من المجمع وتعزيز قدراته التشغيلية.
وفيما بدا تعزيزاً لهذا التحليل، نشرت وكالة أسوشيتد برس في سبتمبر 2025 صوراً تجاريةً من شركة بلانِت لابس التقطت في يوليو من العام نفسه، حلّلها سبعة خبراء في شؤون الانتشار النووي. أجمع هؤلاء على أن المبنى الجديد يرتبط بالبرنامج النووي الإسرائيلي، بالنظر إلى موقعه داخل مجمعٍ مغلقٍ لا يضمّ أيّ منشأةٍ مدنيةٍ للطاقة.
لكن التباين ظهر في تفسير طبيعة المنشأة. فرأى ثلاثة خبراء منهم، وهم جيفري لويس وإدوين ليمان وداريل جي كيمبل، أنها مفاعل ماءٍ ثقيلٍ جديدٌ يمكنه إنتاج البلوتونيوم والمواد الانشطارية الأخرى. في حين رجّح الباقون أن تكون منشأةً لتجميع الرؤوس النووية أو لتحديثها. وفي كلا الاحتمالين، يرى لويس، من مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبيري، أن حجم المنشأة وموقعها "يجعلان من المنطقي افتراض ارتباطها المباشر بالبنية النووية الإسرائيلية"، مضيفاً أن "تاريخ ديمونا وحده كفيلٌ بأن يجعل أيّ بناءٍ جديدٍ هناك موضع تساؤلٍ إستراتيجي".
هذا التناقض لا يكرّس فقط واقعاً من التمييز النووي عالمياً، بل يعمّق أيضاً هشاشة منظومة الأمن الإقليمي. فحين تُعفى دولةٌ من القواعد ويُطالَب خصمها بالامتثال الصارم، تتحول السرّية ذاتها إلى مصدر خطرٍ دائم. وربما لم يكن موردخاي فعنونو مبالغاً حين وصف إسرائيل بأنها "تجلس فوق برميل متفجراتٍ في قلب الشرق الأوسط". برميلٌ لم ينفجر بعد، لكنه يظلّ وقوداً كامناً لكلّ توترٍ قادم في المنطقة.






