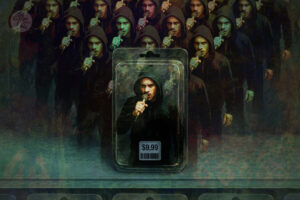يتوزع الحوار الخاطف بين شخوص المسرحية التي تدور حول ما شاعت تسميته "جرائم الشرف" التي تذهب ضحيتها نساءٌ كثيراتٌ في دول العالم العربي. تتناقش الشخصيات في قتل الزوجة "فرحة" الجالسة بلا حولٍ على الأرض. ينتهي الحوار بها ترفع رأسها وتغنّي "لا غرفة التوقيف باقية" المأخوذة عن قصيدةٍ لمحمود درويش. يتدخل "الجوكر" (منشّط الحوار) ليوقف العرض، ويدعو الجمهور لطرح الحلول.
اعتمدت مسرحيات عشتار على مشاهد قصيرةٍ تمثّل حالاتٍ مباشرةٍ ومضخّمةٍ من الاضطهاد، يبدو فيها المضطهَد ضحيةً مسكينةً واقعةً تحت قهرٍ بالغ. في المشهد السابق، تعاني المضطهَدة المقهورة (واسمها فرحة) من عدّة أشكالٍ من الاضطهاد. فتجبَر على الزواج برجلٍ مسنٍّ، ويسجن أبوها، ويعنّفها زوجها فيجبرها على العمل الشاقّ مقابل ألّا تُحرم من أطفالها. وبالمقابل نجد المضطهِد المتمثل في شخصيات العمّة وقيس والزوج، يمارسون القهر على شخصية فرحة، وصولاً إلى الشروع بقتلها. وقبل لحظة القتل يتدخل الجوكر ليدعو الجمهور للمشاركة في محاولةٍ لكسر الاضطهاد. تدخلات الجمهور تأتي إمّا عبر النقاش وإمّا بلعب دور إحدى الشخصيات المعنية بتغيير الواقع.
هذا الشكل من المسرح يطلق عليه "مسرح المنبر"، وهو أشهر أشكال مدرسة "مسرح المقهورين"، التي أسسها المخرج البرازيلي أوغوستو بوال. وتبنّاها مسرح عشتار سنة 1997 عبر سلسلة إنتاجاتٍ مسرحيةٍ بعنوان "شؤون أبو شاكر"، بعد سنواتٍ من تأسيسه في القدس سنة 1991 على يدِ الممثلَيْن والمخرجَيْن إدوار المعلم وإيمان عون.
منذ وضع المسرحي البرازيلي أوغستو بوال أسسَه النظرية من منفاه في الأرجنتين سنة 1973، وجد تيار مسرح المقهورين طريقَه إلى عديدٍ من الدول التي ترزح تحت الفقر أو الاستبداد أو الفساد أو الاستعمار. فمسرح المقهورين يفتح للمتفرج طريقاً للتعبير والمشاركة في مناخاتٍ سياسيةٍ ومجتمعيةٍ غالباً ما تحرمه من هذا الحق. ويتيح له التفاعلَ مع دائرته الاجتماعية التي تعاني المشكلات نفسها، ويشارك مع أفرادها في إيجاد الحلول.
ويمكننا النظر لمسرح المقهورين عبر تجربتين، إحداهما كينيةٌ نجحت في استخدام مبادئ منهج مسرح المقهورين وأفادت منها، وهي تجربة مسرح كاميريثو الكينية. وأخرى فلسطينيةٌ هي مسرح عشتار، التي تبنّت منهج مسرح المقهورين دون أن تأخذ في اعتبارها خصوصية الواقع الاستعماري المعقّد في فلسطين. وظلّت بعض عروض عشتار حبيسة الثنائية البسيطة بين قاهرٍ وضحيةٍ، تكتفي بمنح الجمهور متنفساً عاطفياً، أكثر مما تتيح له مساءلةً عميقةً للبنى الاستعمارية والسياسية التي تنتج الاضطهاد.
يقوم "التعليم البنكي" وفق فريري على قاعدة التلقين، ومفادها أنّ المعلّم يعرف والطّالب لا يعرف، وبالتالي فالصوت الوحيد في الفصل هو صوت المعلم. وطوّر فريري نظريته في تربية المقهورين على نقيض ذلك النظام، أيْ أن يكون التعلُّم بالتفاعل والحوار بين الطالب والمعلم. في المسرح الكلاسيكي، نجد العملية متشابهةً، بمعنى أنّ الممثل يعرض والجمهور يتلقّى. وهنا تأتي أهمية تجربة المسرحيّ أوغوستو بوال وتجديده.
إذا كان التعليم الحواري يقوم على حوار المعلم والطالب والمشاركة في التعلّم، فإنّ مسرح المقهورين يقوم بالدرجة الأولى على مبدأ الحوارية بين الممثل والمتفرج، ساعياً بالحوار إلى الخروج من الصوت الأحادي للعرض إلى تعدد الأصوات ليُسمع صوت الجمهور فيحرّرهم من الامتثال لرؤية العرض الأحادية.
كتبَ بوال وأخرجَ ونظّر للمسرح، وعملَ في مسرح أرينا (الساحة) في ساو باولو البرازيلية، وظلّ يديره ويخرج مسرحياته طيلة خمسة عشر عاماً. أسّس فيها مسرحَ المقهورين متأثراً بالواقع السياسي في أمريكا الجنوبية وإمساك الدكتاتورية العسكرية زمام الأمور.
لم يبتكر أوغستو بوال فكرة تفاعل الجمهور مع العرض، فهذه الفكرة شائعةٌ في تقاليد المسرح الشعبي حول العالم، كما في تقاليد "الفُرجة" الشعبية في مصر ومن أبرز أشكالها "الأراجوز" ومسرح المقهى. بنى بوال فكرته على تراكم تجارب سابقةٍ في المسرح المجتمعي والسياسي، وخاصةً تجربة الشاعر والمسرحيّ الألمانيّ برتولد بريخت الذي كتبَ وأخرجَ عديداً من المسرحيات، وخرج عن العلبة المسرحية التقليدية، (مسرح العلبة هو المسرح القائم على خشبة مسرحٍ وجمهورٍ وحائطٍ رابعٍ يفصل بين الخشبة والمتفرج).
بناءً على هذا التراث المسرحي، طوّر أوغستو بوال مسرحاً معارضاً للنظم والتوجهات اليمينية والرأسمالية في حينه. قامت تجربة بوال على تحفيز العقل النقدي لدى المتفرج بدلاً من التعاطف مع الشخصيات وتحريك الانفعالات تجاه الأحداث، بهدف الكشف عن القوى المحرّكة والمتحكمة في حياة الناس. ولم يكتفِ أوغستو بوال بإلغاء الحواجز بين الممثل والمتفرج، وإنّما أشركَ المتفرجَ في الحدث المسرحي.
في سبيل تطوير مسرح المقهورين، خاضَ بوال عدّة تجارب مسرحيةٍ طوّرها فيما بعد لتكون أشكالاً لمسرح المقهورين. فصَّل أوغستو بوال منهجه في عدّة كتبٍ أبرزها "ثيتر أوف ذي أوبريست" (مسرح المقهورين) المنشور سنة 1979.
تفرّع عن التيار الرئيس عدّة تياراتٍ، منها مثلاً "نيوزبيبر ثيتر" (مسرح الصحيفة) الذي يبدأ المشهد الارتجالي بخبرٍ من الصحيفة، وقد وظّفه أوغستو بوال لمعالجة القضايا المحلية التي تمسّ الناس مباشرة. ومنها أيضاً "إنفيزيبل ثيتر" (المسرح الخفيّ) الذي يعتمد على أداء مشهدٍ مسرحيٍ في مكانٍ عامٍّ، دون إخبار المتفرج مسبقاً أنه بصدد مشاهدة عرضٍ مسرحي. كأنْ يتحرّش شابٌّ بفتاةٍ داخل القطار، وتحدث مشكلةٌ بينهما ثمّ يتدخل الناس باعتبار أنّ ما يجري أمامهم واقعيّ. ومثّلت هذه العروض شكلاً من أشكال النشاط السياسي الاجتماعي.
لاحقاً أسّس بوال "لِجِسليتِف ثيتر" (المسرح التشريعي)، تزامناً مع انخراطه في البرلمان سنة 1993. ويختلف عن المنبر في كون الأخير يضع المتفرّج أمام صنّاع القرار ويضغط عليهم لتشريع قانونٍ ما.
لكن الشكل الأوسع انتشاراً لمسرح المقهورين هو "فورَم ثيتر" (مسرح المنبر) وهو الذي تستخدمه فرقة مسرح عشتار الفلسطينية. في هذا الشكل يشاهد الجمهور نموذجاً ما للاضطهاد في مشهدٍ مسرحيٍ يعرض مشكلةً أساسيةً يعاني منها البطل المقهور، ثمّ يوقف الجوكر (منشّط الحوار) المسرحيةَ ليناقش الجمهور ويدفعهم للتدخل في العرض عبر مواجهة المضطهِد ومن ثمّ مواجهة واقع الاضطهاد.
تتشابه الأنماط المذكورة من حيث زاوية النظر وإن اختلفت تقنياً، فكلّ المقهورين من جمهور تلك الأشكال المسرحية ينظرون إلى المسرح فضاءً للتغيير المجتمعي بالحوار بين العرض والجمهور، كما يقول أوغستو بوال في مقدمة كتابه "غيمز فور أكتورز آند نون-أكتورز" (ألعاب للممثلين وغير الممثلين) المنشور سنة 1992. ويشير في الكتاب إلى أن الجدل يحفّز ويعِدّ الجمهور للفعل في الحياة الواقعية.
فمسرح المقهورين تحريضيٌّ وسياسيّ. البعد السياسيّ فيه يكمن في نوعية العلاقة بين المتفرج والممثل، إذ أراد بوال أن يقدّم للمتفرّج تدريباً مسرحياً على الفعل الثوري. ولأجل هذا طوّر ما أسماه "ذا سبيكت-آكتور" وهي لفظةٌ تجمع بين "سبيكتيتور" أي المشاهد، و"آكتور" أي الممثل. وتعبّر تلك اللفظة عن أفراد الجمهور الذين يشاهدون العرض ويشاركون عبر تفاعلهم في صناعته.
العرض المكتمل في المسرح الكلاسيكي يعرف حدود عالمه ويعرف مبتغاه تماماً، ويقدم النص المسرحي لجمهورٍ على الجانب الآخر من الحائط الرابع، وهو حائطٌ وهميٌ يفصل خشبة المسرح عن الجمهور ويمنع الجمهور من المشاركة في اللعبة المسرحية. فتكون المسرحية أقرب للتعليم البنكي، عالمها معروفٌ ويحيط به صنّاعه كاملاً. أمّا المقهورون، فالعالم عندهم قيدَ التشكّل لذا فمسرحهم في حالة تجربةٍ دائمةٍ، كما يقول الكاتب الكيني، وأحد روّاد مسرح المقهورين، نغوغي واثيونغو في كتابه "ديكولونايزيشن أوف ذا مايند" (تصفية استعمار العقل) المنشور سنة 1986.
يقول واثيونغو في كتابه "تصفية استعمار العقل": "كاميريثو هي التي أرغمتني على التوجه إلى الكيكويو، ومنها ارتقيت إلى مستوى 'قطيعة معرفية' مع الماضي، وبخاصةٍ في ميدان المسرح [. . .] لكن كان لاستعمالنا الكيكويو نتائج أخرى ذات علاقةٍ بقضايا المسرح الأخرى. المضمون مثلاً، [و]الممثلين، فحص الأداء، والتدريبات، العروض، التلقي، [و]المسرح بوصفه لغة".
يتعامل المسرحي الكيني مع المسرح لغةً، فكان لا بدّ من استعادة لغة المسرح الإفريقية، كما يقول في الفصل الثاني من الكتاب نفسه. في مساعيه لاستعادة اللغة، بدأ واثيونغو بتفكيك المسرح الكلاسيكي "جزءاً من نظام التربية البرجوازي" العامّ، الذي رأى فيه عمليةً "تضعِف الناسَ وتجعل المعرفة غامضةً، وبالتالي الواقع نفسه يصبح غامضاً".
يرى واثيونغو أن الناس في هذا المسرح الكلاسيكي غرباء عن العرض، تنحصر علاقتهم الوحيدة به في المشاهدة والانبهار بما يرون دون مشاركةٍ، بالتالي "يُضعِف الناس وثقتهم بأنفسهم" ويزيد من عجزهم واغترابهم عن العرض، ويخفي داخله شروط إعادة إنتاج الواقع والظروف التي تتحكم في حياتهم.
تجربة واثيونغو وفريقه في كاميريثو كانت على الضدّ من المسرح الكلاسيكي الذي يعدّه "برجوازياً" أي تصنعه طبقة المتنفذين والمُلّاك. وانطلقت تجربتهم من مسرح المقهورين. يقول واثيونغو في كتابه إنّ العوامل التي أنتجت مسرح المقهورين يمكن إجمالها بعدّة نقاط: المحتوى المتطابق مع الناس، والقدرة على معرفة هذا المحتوى، والمشاركة في تطويره. وهي العوامل التي اعتمد عليها في تجربته المسرحية.
وعليه فإنّ شرط استعادة اللغة لديه كانت في جماعية العمل، لتمكين الجمهور من المشاركة في عملية المَسْرَحَة، لا في لحظة افتتاح العرض واكتماله وحسب. فتحوُّل فضاء المسرح إلى مساحةٍ مفتوحةٍ للناس، تسمح لهم بالمشاركة الجماعية في التجربة. من هذه النظرية، كوّنت تجربة مسرح كاميريثو لغةً مسرحيةً إفريقيةً، تهتم بالتعلُّم مفتاحاً لإزاحة الغموض عن المعرفة، ومن ثمّ الواقع.
ومن هنا كانت استعادة اللغة أولى الوسائل لمناقشة التاريخ، وخاصةً التاريخ الاستعماري. كان أعضاء فرقة كاميريثو يجلبون المواضيع واللغة التي تعبّر عنها من الحقول والمزارعين. ويذكر واثيونغو في كتابه أنّ اللغة الحقيقية لمسرحهم كان يُبحث عنها في نضالات المضطهدين. لذلك ساهمت تجربتهم في تشكيل حركةٍ مسرحيةٍ مركزها الشعب وحاجاته، فبزغت مهرجاناتٌ ثقافيةٌ ذات قاعدةٍ شعبيةٍ واسعةٍ في كينيا. ولم تكن المهرجانات نسخةً من تجربة كاميريثو، ولكنّها استهلمت منها الحاجة الملحّة لانبعاث الثقافة الكينية والتحرّر من لغة الاستعمار الإنجليزي.
لم تكن تجربة كاميريثو مجرد نسخةٍ من مسرح المقهورين، وإنما اتخذته منظوراً جمعياً وتحررياً. وإذا كان أوغستو بوال يهدف إلى مواجهة القمع والاستبداد والهيمنة الرأسمالية في البرازيل في السبعينيات، فإن واثيونغو يركّز على تصفية استعمار العقل عبر تحرير اللغة، وكلاهما يعتمدان على أدواتٍ شبيهةٍ تطوّرت وفق التجربة، كلٌّ من موقعه وسياقه.
كان مسرح عشتار أوّل فريقٍ مسرحيٍ يوظّف منهج مسرح المقهورين في فلسطين، وسعى لاحقاً لوضع منهجيةٍ وفقاً لتجربته. تأسس مسرح عشتار سنة 1991 في القدس. ولكن بسبب ضغوط سلطات الاحتلال انتقل مقرّه إلى رام الله عقب اتفاقيات أوسلو. وتبنّى منهجَ مسرح المقهورين سنة 1997، مع تخرّج طلاب الدراما المنخرطين في برنامج تدريب الدراما الذي ينفذه مسرح عشتار. جاء ذلك التحول استجابةً لاقتراح المخرج بيتر براشلار. وبراشلار مخرجٌ ومديرٌ فنّيٌّ لمسرح مارالام السويسري، الذي كان على شراكةٍ مع مسرح عشتار، كما ورد في جريدة الاتحاد في عددها الصادر في أول فبراير سنة 1999.
في أبريل 2025 أثناء إعدادي بحثاً عن مسرح المقهورين، قابلت إدوار المعلّم أحد مؤسّسي مسرح عشتار. أخبرني إدوار أنه وشريكته الكاتبة والمخرجة إيمان عون، تردّدا في تبنّي هذا الشكل خوفاً من عدم مشاركة الجمهور وتفاعلهم مع العرض. وبعد نقاشاتٍ مع براشلار، خاض مسرح عشتار التجربة. قدّم المسرح تمارين تقنيةً من مسرح المنبر، وتحديداً تقنيات الارتجال. وإلى جانب التمارين التقنية، خاض الطلاب مع فريق العمل نقاشاتٍ عن اهتماماتهم والمشاكل التي يودّون التعبير عنها، فعبّروا عن مشاكلهم مع أسرهم والفجوة بين الأجيال. بعد ذلك كتب الطلاب نصّاً مسرحياً بمتابعة المسرحيّ الفلسطيني سامح حجازي ومساعَدَته، وكان بعنوان "شؤون أبو شاكر 97". وتحوّل هذا النصّ لاحقاً إلى سلسلة عروضٍ تحمل الاسم نفسه، وصلت إلى ستّة إنتاجاتٍ مسرحية.
اتخذ مسرح عشتار عدّة مساراتٍ في بناء المحتوى وتأليف نصوص المضطهدين، ومنها نقاشات طلاب الدرام وما ارتكز على دراساتٍ وأبحاثٍ لمؤسساتٍ متخصصةٍ في مجالٍ ما. نجد ذلك في "شؤون أبو شاكر 98"، إذ اعتمد النصّ المسرحي الأوّلي على دراسةٍ ومعلوماتٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مشاكل المياه في إحدى قرى الضفة الغربية.
في أعمالٍ أخرى يذهب المسرح في زياراتٍ إلى قرىً فلسطينيةٍ ويخوض ورشاً مسرحيةً ونقاشاتٍ مع السكان الذين يساهمون في تكوين الأفكار وبناء محتوى النصوص. يعتمد عشتار على عدّة تمارين في هذه الورش، جَمَعَها إدوار المعلم وإيمان عون في كتاب "من الدائرة إلى الفراغ: رحلة نحو الإبداع" المنشور سنة 2004، إضافةً إلى التمارين الموجودة في كتاب "ألعاب للممثلين وغير الممثلين" لبوال. تفيد التمارين في بناء المحتوى وارتجال مواقف واستعراض المشاكل بطريقةٍ مسرحية.
بعد إتمام النصّ وإنجازه يعمل المسرح بطريقتين. في الأولى يؤدّي فريق مسرح عشتار مع ممثلين محترفين العرضَ أمام جمهور الموقع والمواقع والمسارح الأخرى. وفي الثانية يؤدّي أهل القرية العرضَ نفسه في أماكن وقاعاتٍ غير مجهّزةٍ للمسرح. بهذا تكون القرية وأيّ موضعٍ منها ساحة مسرحية، وسكانها شركاء في المحتوى وكتابة النصّ وعرضه والحوار بشأنه. وتتمثل شراكة مسرح عشتار في توفير تدريبات التمثيل والارتجال وإخراج العرض مسرحياً، إضافةً إلى مشاركة ممثلٍ أو اثنين محترفين في العمل. وفي الطريقتين تأتي تدخلات الجمهور بخوض النقاش مع الجوكر، إضافةً إلى لعب المتفرج دوراً يختاره ويواجه به شخصية المضطهِد.
في هذا الشكل من عروض مسرح المنبر، يضخّم عشتار القضيةَ التي يأخذها من الناس كي لا تمرّ أثناء العرض عاديّةً. ويساهم في إبراز المشكلة ودفع الجمهور للتدخل بإدارة الجوكر الذي تأخذ شخصيته على عاتقها إعطاء مقدمةٍ سريعةٍ عن مسرح المقهورين وآلية تدخلات الجمهور وما إلى ذلك.
عدا عن مسرح المنبر، خاض عشتار تجربة المسرح التشريعي، كما في مسرحية "حكاية منى" التي عرضت سنة 2005. قصة المسرحية عن طالبةٍ متفوقةٍ في المدرسة يجبرها عمّها على الزواج برجلٍ كبير السنّ ويحرمها من المدرسة، رغم ترشيحها لتمثّل فلسطين في مسابقةٍ دولية. يقتلها عمّها ثمّ يقول للقاضي، ويشهد معه أخوه، إنّهم قتلوها لأسبابٍ مرتبطةٍ بشرف العائلة فيُحكَم عليه بالسجن ستّة أشهرٍ فقط. تأتي تدخلات الجمهور ونقاشاته في هذا العرض ضمن سؤالَيْ جرائم "الشرف" والزواج المبكر، بهدف تشريع قوانين تحمي النساء في هذا الجانب. جرّب عشتار كذلك المسرح الخفيّ، ولكنّ معظم أعماله وورشه تأتي ضمن مسرح المنبر.
تعاون المسرح مع المؤسسة والتقى الفريق (المكون من ممثلٍ وممثلةٍ ومخرجٍ) بعشرين امرأة. لم تقدّم النساء أيّ معلوماتٍ أو قصص. انسحبَ الممثل والمخرج وانتهى اللقاء، وبقيت الممثلة مع النساء وحدها. وبعفويةٍ كشفت النساء عن كثيرٍ من قصص التحرش وسفاح القربى اللائي تعرّضن لها أو يعرفن عنها.
أثناء جولة العروض كان الجوكر يقول للجمهور إن المسرح حصل على القضايا المعروضة في جولته في قرىً ومواقع أخرى. ومع هذا نجد المتفرجين في عدّة مواقع يأخذون وضعيةً دفاعيةً متردّدين في النقاش. يؤكّد إدوار في هذا المجال على أهمية دور الجوكر وقدرته على استفزاز الجمهور للانخراط وإبداء آرائه وحلوله.
عدا عن دور الجوكر تحدّد طبيعة الجمهور شكلَ النقاش والتفاعل إذا كان العرض موجّهاً للرجال. وإذا وُجِّه للنساء كنّ يتدخّلن في النقاش، "لكنّه تدخلٌ لا يَفِي بالغرض" فالهدف أن تعبّر النساء عن مشاكلهن وقضاياهن بوجود الرجال. في العروض التي تقدَّم إلى جمهورٍ مختلطٍ عادةً يقول الرجال إنّ هذه المشاكل غير موجودةٍ، وفي المقابل تصمت النساء إمّا خجلاً أو خوفاً. وفي أحيانٍ قليلةٍ تتجرّأ بعض النساء على الحديث والتعبير عن مشاكلهنّ بوجود الرجال.
في عرض "حكاية منى" الذي عرضَ في مخيّم عسكر شمال الضفة الغربية، دفع الجوكر الجمهورَ للإدلاء بدلوهم حيال الواقع. من بين الجمهور كانت تجلس أرملة مقاومٍ قضى على يد الاحتلال وتستمع إلى مداخلات الرجال عن القضايا المطروحة على أنها تحدث في موقعٍ آخَر. تجرّأت الأرملة ووقفت تذكّر الرجال بقصّتها مع ابنتها الأولى التي اضطرّت إلى تزويجها وهي في الثالثة عشرة من عمرها، ثمّ طلبت من أهل قريتها (الجمهور) أن يكفّوا عن الضغط عليها لتزويج ابنتها الثانية. تمكّنت المرأة هنا من التعبير عن مشكلتها من خلال المشكلة المعروضة مسرحياً، وتمكّنت من مواجهة مجتمعها والدفاع عن ابنتها. والعرض وفق المؤسِّس بوال لا يطلب تغييراً فورياً للواقع وإنّما مواجهته على الأقل، والحوار الديموقراطي حوله.
تختلف تدخلات الجمهور وفق الجنس وموقع العرض إضافةً إلى قدرة الجوكر على استفزازهم. يشير إدوار إلى أهمية تدريب الجوكر على قيادة اللعبة المسرحية والحوار، والممثل على الارتجال. وعن الارتجال يستند عشتار على طريقة لبوال تدعى "خذ وأعطِ"، وتأتي أهميتها في اللحظة التي ينزل فيها المتفرج من مقعده إلى منطقة التمثيل لارتجال مشهدٍ حواريٍ مع الممثل.
في هذه اللحظة على الممثل أن يدرك قوة المتفرّج وحجّته في الدفاع عن المقهور في مواجهة المضطهِد. فإذا كان قوياً فعلى الممثل أن يكون أقوى منه، وإذا كان ضعيفاً أو خجولاً أو واهيَ الحجّة فعلى الممثل أن يعطيه قوّة. وذلك بأن يظهر على الممثل ضعفه مما يساعد على تقوية المتفرّج وتشجيعه. وحين يقوى المتفرّج ويتمكن من مواجهة الممثل المضطهِد، يعود هذا إلى قوّته ويحاول التفوّق على المتفرّج ويسعى لاستفزازه أكثر ليجبره على تقديم حلولٍ أعمق. على الممثل أن "يضغط" المتفرّج الذي يقف قبالته في المشهد ويرتجل معيقاتٍ أمام الحلول المقترحة، ويدفعه للتفكير أكثر ويصعّب عليه الطريق.
هذا يحتاج إلى تدريبٍ متواصلٍ ومنهجيٍّ على الارتجال المسرحي، لأن المسرح هنا لا يقدّم حلولاً وإنما يستفزّ الجمهور ليقدّم هو حلوله. فالمشاكل المعروضة هي مشاكل الجمهور وليست مشاكل فريق المسرح. حين يعجز الممثل أمام المتفرّج يتراجع الممثل ويتدخل الجوكر بإيقاف العرض، ثمّ يحاوِر الجمهور فيما حدث وكيف ضَعُفَ الممثل أمام حجّة المتفرّج. هنا يعود المتفرج وفي جعبته بعض الحلّ الذي قدّمه بنفسه.
عدا عن القرى والمواقع المختلفة، ينتج مسرح عشتار ويقدّم عروضَ مسرح المقهورين في المسرح التقليدي (مسرح العلبة). وعادةً فإن وجهة نظر الجمهور الذي يأتي عن رغبةٍ مسبقةٍ إلى المسرح تختلف عن الجمهور الذي يذهب إليه المسرح في مواقعه. ثمّة متفرّجون ممّن شاهدوا تلك العروض في المسرح التقليدي علَّقوا للفراتس بأنّهم وجدوا فرقة عشتار تقدّم رسائل مباشرةً وتعليمية. على حين يؤكد أوغستو بوال في كتابه "ألعاب للممثلين وغير الممثلين" على أنّ مسرحه تربويٌّ ولا يقدّم دعايةً أو رسائل تعليميةً مباشرة.
تأخذ معظم إنتاجات عشتار المؤطّرة داخل هذا المنهج المسرحي منحىً رسائليّاً، ما دفعني لاختيار مسرحيةٍ تعَدّ أجرأ من غيرها، وهي مسرحية "أبو سلمى"، أحدث إنتاجات مسرح المنبر لفرقة عشتار. سبّبت المسرحية مشكلاتٍ للفرقة المسرحية مع الأجهزة الأمنية في المهرجان المسرحي الذي تقيمه الفرقة على مسرحها سنة 2022. فقد جاء شابّان إلى المسرح يسألان عمّا يحدث، وكان واضحاً من أسئلتهما أنهما يعملان مع السلطة الفلسطينية. وفي اليوم التالي هجم شبابٌ على مسيرةٍ فنيةٍ لمسرح عشتار، يربطها طاقم العمل وكثيرون غيرهم بالصوت النقدي في عرض "أبو سلمى"، وهو استمرارٌ لواقع القمع والعنف السياسي الذي يمارسه الأمن.
تناقش مسرحية "أبو سلمى" موضوع التنمّر في شقَّيْه السياسي والاجتماعي، وتتكون من مشهدين منفصلين. الأوّل بعنوان "حكاية أمل" ويطرح قضية "التنمّر في العمل"، ومنه نتعرّف على مشاكل اضطهاد المرأة في بيئة العمل، وتعنيف الموظفين الرجال زميلاتِهم ممثَّلاتٍ في المرأة الشابة. والثاني بعنوان "حكاية أبو سلمى" ويناقش قضية "التنمر السياسي". ويطرح قضية شابٍّ بسيطٍ يتفاجأ بارتفاعٍ كبيرٍ في فاتورة الاتصالات، فيؤسس صفحةً بعنوان "بكفّي يا شركات الاتصالات". تنتشر الصفحة على نطاقٍ واسعٍ ثمّ يتعرّض أبو سلمى لتهديداتٍ كثيرةٍ من المسؤولين.
تحدّث للفراتس أحد الممثلين، ماهر (اسم مستعار) قائلاً: إنّ المسرحية تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، ولكنّها تظلّ في إطار الشعارات حول الاضطهاد، لا الاضطهاد نفسه. شعاراتٌ لا تأتي بمعنى الانفصال عن الواقع وإنما في تقديمه بعموميته، فالعرض يخاطب المؤسسات والمديرين والمسؤولين وليس الناس (المتفرجين). ويرى ماهر أنّ المسرح يتجاهل أسئلة الاضطهاد اليومية، ولا يهتمّ إلّا بالقضايا العامة أو الفضفاضة "التي تلائم رؤية الممولين والمؤسسات الشريكة".
يضيف مراد (اسم مستعار)، وهو أحد ممثّلي العرض، إنّ مشكلته الأساسية مع "أبو سلمى" وعروض المضطهدين في عشتار أنها مكرّرة. والتكرار (لا التراكم) بمعنى إعادة القضية والحوار والمشكلة نفسها، أمّا تدخلات الجمهور التي حدثت قبالته وهو ممثلٌ فلَم تكن جزءاً من العرض، بل كانت لحظاتٍ تسعِد الناس في مشاركتهم التمثيلية، وكلّ ما يفعلونه لا يتعدّى التفريغ حيال القضية المطروحة. وعن هذا يضيف أنه شارك في عرض "أبو سلمى" ثمانيَ ليالٍ مسرحيةٍ، ولا يتذكر اقتراحاً حقيقياً من الجمهور ساهم في حلّ القضية، وإنّما انحصرت التدخلات إجمالاً في إطار التفريغ.
أحد مشاهدي العرض الذي اختار أن يصرّح للفراتس تحت اسم "موسى"، لديه تفسيرٌ لافتقار جمهور عروض "أبو سلمى" إلى الفاعلية والتأثير. فهو يرى أن النصّ المسرحي الأساسي لا ينطلق من نقطة التساؤل والتشكيك والمسؤولية حيال القضايا المطروحة في العرض. يعتقد موسى أن العرض لم يَنتج عن بحثٍ ميدانيٍ حقيقيٍ، وإنما كتبه المشاركون في العمل وفق القضايا التي سمعوا عنها، في حين أنّ أصحاب القضية أنفسهم غائبون عن كتابة المحتوى. وعندما يأتون جمهوراً إلى العرض لا يناقشون القضية، فهي واضحةٌ ومباشرةٌ لا تحتمل النقاش. ويختم بأنّ إدماج الجمهور في العرض يجب أن يحدث أثناء الكتابة وليس فقط أثناء العرض.
يرفض إدوار المعلم هذا التفسير، ويؤكد للفراتس أنّ إنتاجات عشتار تُبنَى مع الناس. وكان يقصد العروض المجتمعية والمنبرية التي تنتَج وتعرَض في المواقع، أمّا هذا العرض وإن كان من أفكار طلاب الدراما ونقاشاتهم إلّا أنّه جاءَ من قصةٍ واقعيةٍ، وارتبط بأحداث القمع التي طالته على يد أمن السلطة الفلسطينية.
وفق أوغستو بوال يعجز المتفرج أو الممثل عن مواجهة المنظومة، فيلجأ للتفريغ. وعن هذا تقول رنا (اسم مستعار) للفراتس إنّها لم تخض نقاشاً واحداً في مسرحيات المضطهدين، ولم تشأ النزول إلى منطقة التمثيل وارتجال مشهدٍ يسعى لكسر الاضطهاد. لا ترغب في أن تكون "جزءاً من الفضفضة" بين جدران المسرح "في حين أنّنا قبل سنةٍ من العرض واجهنا عنفاً وقمعاً من السلطة خلال مظاهرات اغتيال نزار بنات" في يونيو 2021.
ما تقوله رنا لا يعني أنّ العرض منفصلٌ عن الواقع، وإنما يشكّل تفريغاً وتنفيساً عن مشاكلنا الواقعية. إشكالية هذا التفاعل لا ترتبط تقنياً بدور الجوكر. ففي العرض كانت دلال عودة (وهي جوكر العرض) تسعى بكلّ ما تستطيع لخلق النقاش.
حكاية أبو سلمى تعالج الخصخصة واحتكار رأس المال كما ذكر في موقع روزا لوكسمبورغ (شركاء الإنتاج ومموّلوه). ومع ذلك، على النقاش أن يكون عن المسؤولين وتنمّرهم على شخصية أبو سلمى، دون نقاش وجود الخصخصة نفسها رغم معالجة العرض لها، ولا مناقشة السلطة التي تتمظهر في العرض في تهديدات المسؤولين.
المتفرّج في هذه الحالة مضطرٌ إلى نقاش ما هو داخل حدود العرض والمشكلة المطروحة، مع القبول المسبق بالمباني والهيكليات التي تنتج المشكلة نفسها. بمعنى أنّ العرض لا يساهم في تفكيك المقولات المؤسِّسة للاضطهاد وإنما يقدّم الفعل نفسه، أي النتيجة، وعلى المتفرّج أن يناقشها. وفي الغالب يكون هناك اتفاقٌ ضمنيٌ على المشكلة. فالجمهور المسرحي يتفق مع العرض على رفض العنف السياسي أو اضطهاد المرأة أو القتل وما إلى ذلك. وعندما يبدأ النقاش (فيما هو متّفقٌ عليه) لن يخرج من إطار الفضفضة أو تفريغ الغضب بما يتناسب مع طاقة الجمهور وجرأتهم، ولكنّ العرض لا يسمح للمتفرّج بمواجهة المقولات المؤسِّسة للاضطهاد.
بالعودة إلى "حكاية منى" نجد أن المتفرجين ينحازون إلى المقهورة ويرفضون المضطهِد. ولكن تشكّل منى ضحيةً نموذجية. فعدا عن تفوّقها في دراستها وترشيحها لتمثّل فلسطين ثمّ حرمانها من التعليم وإجبارها على الزواج المبكر من مسنٍّ يعنّفها، فهي لم تفعل ما يندرج تحت ما يطلق عليه "الشرف". في المقابل نجد المشكلة الأساسية متعلقة بالقتل على "خلفية الشرف". سيقف المتفرجون إلى جانبها ويرفضون قتلها، حتّى لو كان من بين الجمهور المسرحي من يتبنّى جرائم "الشرف"، إلّا أنه سينحاز للمقهورة لأنّها ظلمت ولم ترتكب الفعل، لا لأنّه يعارض القضية نفسها والمقولات الذكورية المؤسِّسة.
العرض كما هو يخفي في داخله قبولاً (غير معلَنٍ وربّما غير مقصودٍ) لما يطلق عليه جرائم الشرف، فيجعلنا نتعامى عن حدود العالم ويظهره كأنّه غير قابل للتغيير. كأنّ جريمة الشرف أمرٌ مسلّمٌ به، أمّا النقاش فهو في عدم ظلم الفتاة التي لم ترتكبه. هذا الشكل من العروض يجعلنا نقبل الواقع القائم، ويروّضنا عليه مع إمكانية الحلول والتغيير داخل حدوده. وبهذا نظلّ في إطار "المسرح البرجوازي" كما يشرحه نغوغي واثيونغو وأوغوستو بوال وفريري. العرض يعرف وعلى الجمهور أن يعرف ما يعرفه العرض، أو في أحسن الأحوال يفرّغ غضبه وانفعالاته.
نجد الأمر ذاته في "أبو سلمى" فلن نجد اختلافاً بين المتفرجين والممثلين على عدائهم مع المسؤولين الفاسدين أو الموظفين الذكوريين. هذا الشكل من العروض يعفي الجمهور من مسؤوليته ويحصره في إطار التفريغ، ويغفل أنّ المقولات المؤسِّسة والنظم التربوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة بين الناس قد تكون سبباً في القضية المطروحة.
لو طرح عرض "حكاية منى" مثلاً علاقةً جنسيةً تؤدي إلى قتلها وإعفاء القاتل قانونياً بحجّة القتل على خلفية الشرف، لوجدَ نقاشٌ حقيقيّ. أمّا بتقديمها ضحيةً نموذجيةً أمام مضطهِدٍ مبالَغٌ فيه، فطبيعيٌ أن ينحاز المتفرجون لها، حتّى أولئك المدافعون عن القتل على خلفية الشرف. وعليه لا تُناقَش القضية الأساسية جدّياً، ولا تحقّق المسرحية غرضها.
تتفق القضية المطروحة بتركيبها مع جوهر مسرح المقهورين والتعليم الحواري. إذ يقومان على أنّ الطرفين لا يعرفان الإجابة، بينما يشكّل العرض أو التجربة مساحةً للتعلّم المشترك. ومن ثمّ فالسؤال يتجاوز الآراء المسبقة ويتقدّم نحو التساؤل معاً والتعلم معاً لفهم طبيعة المواجهة.
يعيدنا هذا إلى تجربة واثيونغو، فنجد أنّ الفرقة المسرحية وأهل القرية لهم كلمتهم المتمثّلة باللغة وتحرير العقل من الاستعمار. وعليه فالعمل المسرحي ينطلق من أساسٍ واضحٍ مشتركٍ، نجد بذرته في كاميريثو ويمكن تعميمها على كينيا. والحلول غير معروفةٍ مسبقاً، وإنما تتشكّل أثناء التجربة.
وإذا كان انفصال المسرح البرجوازي عن الناس وفق واثيونغو، يرتبط بنخبوية العرض وسحره. فإن الانفصال في مسرح المقهورين الذي يقدّمه عشتار يأتي من بُعد الجمهور المسرحي عن القضية، وفي تبسيط القضية ونفي المسؤولية حيالها، وطرح الأسئلة السهلة مسبقة الإجابة. هذه كلّها عوامل تدفع المتفرّج إلى أن يشارك الممثل في الحديث عمّا هو بعيدٌ عنه وبريءٌ منه.
لا ينطبق هذا تماماً على العروض المجتمعية التي تُكتَب وتنتَج وتعرَض في مواقعها ولجمهور الموقع. فسكان القرى والمواقع يعرفون القصص التي تختفي وراء القضية المطروحة مسرحياً، فيعبّرون ويتحاورون ويختلفون حيال المشكلة الواقعية ولكن تحت غطاء المشكلة المسرحية. هنا تبدو الهموم والمشاكل مشتركةً وتمسّهم جميعاً، لأنهم يعيشون في موقعٍ مشتركٍ وقصصٍ متشابهةٍ ومعروفةٍ لهم، حتّى لو كانت القضايا سياسيةً أو متعلقةً بالاستعمار.
أَنتج عشتار مسرحية "شؤون أبو شاكر 2001" عن إسقاط الفتيان في فخّ العمالة للاحتلال. ولم يضع العرض المتلقّيَ أمام حوارٍ مع المستعمِر. فلو عُرضَ بهذه الطريقة لظلّ في إطار التفريغ كما لاحظنا في مسرحية "أبو سلمى". أخذ عشتار العرضَ إلى الأسرة وناقشَ قضية إجبار الفتيان على العمل في سنٍّ مبكرةٍ، ليجد الفتى الذي يبيع "العلكة" نفسه مضطراً للتعامل مع عملاء بلا وعيٍ، وتدريجياً يستغلّه ضابطٌ إسرائيليٌ فيصبح واحداً من هؤلاء العملاء.
تأتي النقاشات في هذا السياق مع الأهل وتحديداً الآباء، لأن الأب هنا هو المضطهِد، ويرتبط النقاش في عمالة الأطفال وخطورتها، وكيف ينبغي لنا أن نحمي أطفالنا.
لا يمكن التغيير المجتمعي في عرضٍ واحدٍ، وإنما يحدث عبر تراكم العروض التي تواجه الاضطهاد كاملاً، دون فصله إلى مواضيعَ يحدّدها المموّلون أو غيرهم. بمعنى ألّا توضع قضايا الناس في خاناتٍ مثل المرأة أو الطفل أو الزواج المبكر أو أزمة المياه أو عنف الاحتلال، وإنما تُعرَض تمظهراتٍ لواقع اضطهادٍ ومنظومةٍ وقوى.
فرادة الوضع الفلسطيني تفرض أن تكون العروض المسرحية المبنية على مبادئ تربويةٍ، وعلى رأسها مسرح المقهورين، مراعيةً لهذه الفرادة وقادرةً على أن تقدم نصوصاً وتدير عروضاً تخاطب ذلك الواقع الفريد. وهذا ما يحتّم على القائمين على الفرق الفنية الفلسطينية المعنية باشتباك منتجها الفني مع الواقع، ولاسيما مسرح عشتار، أن ينظروا فيما يقدمون، وأن يكونوا عنصراً فعالاً في أن يكون المسرح نصاً ومشاهدةً، فعلاً ثورياً يعِين المجتمع على المواجهة.