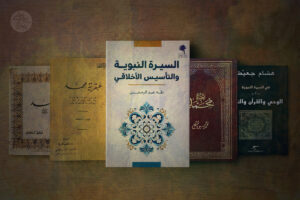كان قرار حل المجلس الأعلى لحظةً سابقة في تاريخ تونس الحديثة، وفصلاً جديداً في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. وعدَّه المعارضون انقلاباً على استقلالية القضاء، ورأت فيه منظماتٌ حقوقية "تدميراً لآخر حصون الفصل بين السلطات في تونس". في المقابل، برّر سعيّد خطوته بشعار "تطهير القضاء" من الفساد والفاسدين.
إلّا أن أزمة الرئيس التونسي مع القضاء لم تبدأ مع حلّ المجلس. بل تعود جذورها إلى الأيام الأولى من انتخابه رئيساً للبلاد، حين شكّك في نزاهة القضاة، وانتقد بطء البتّ في القضايا الكبرى، قبل أن ينطلق في تقليص دور السلطة القضائية تدريجياً، وتحويلها إلى مرفقٍ عموميٍ تابعٍ السلطةَ التنفيذية. منذئذٍ، غدا سعيّد المشرّعَ الوحيدَ في تونس، يصدر المراسيم الرئاسية المتتالية لإعادة تشكيل القضاء بما يناسب رؤيته. ومن ذلك إعفاء عشرات القضاة وسجن آخرين، والتحكّم في التعيينات والمنح والامتيازات. مشهدٌ غير مسبوقٍ في تاريخ تونس، لم يعرفه القضاء حتى في عهدَي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، اللذَيْن اكتفيا بمعاقبة القضاة المعارضين بالنقل وسحب الامتيازات، وهيمَنا على القضاة دون المساس بالبنية المؤسسية كما فعل الرئيس الحالي.
اتخذ التونسيون في سنوات ما بعد الثورة خطواتٍ لضمان استقلال القضاء، على ما شاب هذه الجهود من عقبات. ففي يناير 2014، اعتمدت الدولة التونسية دستوراً جديداً ينصّ على أن القضاء سلطةٌ مستقلة. وقد عزّز الدستور الجديد الاستقلالَ المؤسّسيَ للقضاء وأعضائه، وأُنشئ على الأثر مجلسٌ أعلى جديدٌ للقضاء مخوّلٌ بتعيين القضاة والإشراف على أدائهم الوظيفي. كذلك مُنح الجهاز القضائي حيزاً كبيراً لإدارة شؤونه الخاصة، في تحوّلٍ عن عهد زين العابدين بن علي، عندما كانت السلطة القضائية خاضعةً للسلطة التنفيذية.
أدّى قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري السابق، اليمين رئيساً لتونس في أكتوبر 2019، ليكون الرئيسَ الخامس منذ إزاحة بن علي. وإن سوّق نفسه أثناء الانتخابات الرئاسية قائداً نزيهاً ومنقذاً للشعب من الفساد والتجاذبات السياسية التي أرهقت البلاد، بدأ بُعَيْد تولّيه المنصبَ يستفرد بالسلطة. وفي يوليو 2021 أعلن سعيّد عن إجراءاتٍ استثنائيةٍ شملت تعليق معظم أحكام الدستور، وأعلن نفسه رئيساً للنيابة العامة. كذلك علّق عمل البرلمان وألغى الحصانة البرلمانية لأعضائه.
مع توسّع الإجراءات الاستثنائية، وجد قيس سعيّد في المراسيم الرئاسية أداةً لتركيز سلطته فحوّلها إلى وسيلةٍ لتغيير قواعد اللعبة داخل الدولة مُصْدِراً قوانين جديدةً لم تخضع لأيّ سلطةٍ تشريعية. منها المرسوم 117 الذي علّق مواد دستور 2014، وخوّل الرئيسَ صلاحيةَ إصدار مراسيم تشريعيةٍ غير قابلةٍ للطعن في جميع المجالات دون الرجوع إلى البرلمان. شيئاً فشيئاً، امتدت هذه المراسيم إلى المجال القضائي، إذ لم تعد تقتصر على تنظيم الشأن الإداري أو المالي، بل طالت موقع القضاء نفسه ودوره، وصولاً إلى لحظة حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإبداله بمجلسٍ مؤقتٍ يخضع لسلطته.
أصدر سعيّد أول مرسومٍ رئاسيٍ يستهدف القضاة في يناير 2022، ألغى بموجبه المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهو ما عدّه أعضاء المجلس حينها تدخلاً للسلطة التنفيذية بواسطة المراسيم في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء دون الرجوع إلى لجنة العدل التي شرّعت هذه الامتيازات في البرلمان.
وبعد حلّ المجلس، أصدر سعيّد مرسوماً جديداً رقمه 35، في الأول من يونيو سنة 2022، وأعطى الرئيسَ السلطةَ المطلقة لإعفاء القضاة والمدّعين العامّين. وهو المرسوم الذي استخدمه في زلزالٍ قضائيٍ يُعدّ سابقةً في تونس أعفى بموجبه القضاةَ السبعة والخمسين.
خلّف ذلك صدمةً عبّر عنها القضاة المُعفَوْن ببياناتٍ متتاليةٍ واحتجاجاتٍ، وعدّوا القرارَ لا يستهدف المعزولين وحدهم، بل يبعث رسائل تهديدٍ إلى كلّ من يزاول مهامّه. مفاد الرسالة أن الرئيس قادرٌ على استخدام سلاح العزل لتصفية خصومه السياسيين والمعارضين.
وصفت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، القرارَ في حديثها للفراتس بأن إجراءات العزل كانت "مجزرةً ومذبحةً قضائيةً، وأن القضاة باتوا تحت رحمة الرئيس، وحياتهم المهنية تحوّلت إلى 'فيلم رعب' يرغمهم على تطبيق القانون في ظلّ الخوف ومحاولة إرضاء السلطة".
وفي مواجهة قرارات الإعفاء، لجأ عددٌ من القضاة إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في ملفات التقاضي التي تكون فيها المؤسسات الحكومية طرفاً. وأصدرت إدارية تونس في أغسطس 2022 أحكاماً بإيقاف تنفيذ إعفاءات أغلبية القضاة الذين أُقصوا من مناصبهم، معتبرةً أنّ الإجراءات شابها تجاوزٌ للقانون ومساسٌ بمبدأ استقلال القضاء. غير أنّ وزارة العدل رفضت الامتثال لهذه الأحكام، وهو ما عمّق الأزمة، إذ تحوّلت قرارات المحكمة إلى شاهدٍ على محدودية سلطة القضاء الإداري أمام انفراد الرئيس بالقرار.
وتعليقاً على الأمر، صرّح للفراتس القاضي التونسي محمد عفيف الجعيدي، الذي عمل في مهنته أكثر من ثلاثين عاماً، بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية جاء بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق. وعليه فإن قرار وقف تنفيذ الإعفاءات نافذٌ وغير قابلٍ للطعن، لكن السلطة التنفيذية تجاهلت القرار ومضت في تنفيذ عزل القضاة.
وليست هذه المرّة الأولى التي ترفض فيها السلطة التنفيذية تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، التي كانت تفرض أحكامها حتى في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وكشف التقرير السنوي لجهاز الموفق الإداري (الأمبودسمان)، وهو مؤسسةٌ حكوميةٌ تتلقى شكاوى المواطنين، أنه من بين مئة وسبعة عشر حكماً ضد مؤسسات الدولة سنة 2020، لم ينفذ إلا ثلاثة عشر فقط. وهو أمرٌ مخالفٌ للدستور.
وإلى جانب ما أحدثه من احتجاجاتٍ داخل تونس، أثار قرار إعفاء القضاة ردود أفعالٍ خارجية. أبرزها مطالبة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ببطلان المرسوم 117. كذلك أمرت المحكمة بتعليق تطبيق المرسوم المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت ومرسوم عزل القضاة من جانبٍ واحدٍ، وعدّته مخالفاً مبادئَ دولة القانون واستقلال القضاء. وواجهت تونس قراراتِ المحكمة الإفريقية بسحب اعترافها بها.
يقول المحامي كريم المرزوقي للفراتس إن القرار التونسي يعدّ انتكاسةً جديدةً في مسار التخلّي عن التزامات تونس الدولية والقارية تجاه تدعيم الرقابة القضائية على احترام حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة "عدالة للجميع" الفرنسية السلطاتِ بتونس الامتثالَ لقرار المحكمة الإفريقية، محذرةً من "الوضع الخطير الذي آل إليه القضاء التونسي، خاصةً في ظلّ السيطرة الكاملة للرئيس على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتجميد المجلس المؤقت للقضاء بعدم سدّ الشغور في تركيبته منذ عامٍ كامل". وهو الفراغ الذي استغلّته وزارة العدل لإحداث نقلاتٍ وترقياتٍ وتعييناتٍ وتجريدٍ من مناصب عبر مذكرات عمل (قرارات وزارية).
وتعدّ قضية القاضي البشير العكرمي من أبرز الملفات التي صعّدت الصراع بين السلطة التنفيذية والقضاء بعد 2021. العكرمي الذي شغل منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أشرف على التحقيق في ملفات حساسة. أبرز هذه الملفات قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد سنة 2013، وهو الذي أدخلت قضيته تونس في أزمةٍ سياسيةٍ حينها وأسفرت عن استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وبعد عزل العكرمي واعتقاله في فبراير 2023، وُجّهت له تهمة التدليس. ووجّه العكرمي رسالةً من داخل سجنه حذّر فيها من خطورة الوضع الذي آل إليه القضاء، مطالباً بوضع حدٍّ لما وصفه بالظلم والتعسّف. وفي الشهر نفسه، صدر أمرٌ باعتقال القاضي الطيب راشد، الرئيس الأول سابقاً لمحكمة التعقيب، واتهمَ بالفساد المالي واستغلال النفوذ أثناء توليه المنصب، وحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر.
الاستهداف طال أيضاً القاضي حمادي الرحماني، أحد القضاة السبعة والخمسين المعزولين في يونيو 2022. ففي ديسمبر 2024 داهمت قواتٌ أمنيةٌ منزلَ الرحماني واعتدت عليه وعلى أسرته ومن ثمّ اعتقلته، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً. لكنه ظلّ ملاحقاً بأحكامٍ قضائيةٍ، من بينها حكمٌ بالسجن ثلاث سنوات. وفي أبريل 2025، اعتُقل مجدّداً على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة تونس، بعد حضوره جلسة محاكمةٍ في ملف "التآمر على أمن الدولة"، الذي يحاكَم فيه عشرات المعارضين السياسيين.
يضاف للقائمة أيضاً القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، الذي كان من أكثر القضاة صراحةً في انتقاد الرئيس. إذ شبّه وضع القضاء في تونس بوضع غزة "مدمَّرٌ بالكامل، والسكاكين مسلطةٌ على رقاب القضاة". بعد هذه التصريحات بأيامٍ، داهمت قوات الأمن منزله في أبريل 2025 واعتقلته، قبل أن يصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب قراراً بسجنه بتهم "التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق" (تكوين عصابة) و"الإساءة عبر شبكات الاتصال". ومع الإفراج عنه لاحقاً، إلا أن قضيته ظلّت شاهداً على مدى توظيف القضاء سلاحاً ضد القضاة أنفسهم.
واستمرت حملة الاعتقالات بعدما أحكم قيس سعيّد قبضته على المنظومة القضائية، حتى وصلت في 15 أغسطس 2025 إلى اعتقال القاضي مراد المسعودي في الشارع العام وأمام أسرته، في عملية وصفتها زوجته بالاختطاف من "مجهولين اقتادوه لجهة غير معلومة". ليتبين بعد ساعات أنه قُبض عليه تنفيذاً لحكم قضائي صدر ضده بالسجن بتهم التأثير على الناخبين وجمع تزكيات بطرق غير قانونية في إطار ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2024. ووصف محامي المسعودي، سمير بن عمر، في تصريح للفراتس الحكمَ بأنه "العدم"، مؤكداً أن موكله طعن فيه طبقاً للقانون، وأن إيداعه السجن قرار باطل له خلفية سياسية.
ونبّهت الشبكة العربية لاستقلال القضاء مع إطلاقها في 2025، وتضمّ خمس عشرة منظمةً حقوقيةً من ستّ دولٍ عربيةٍ، إلى "التعدّي الممنهج ضد القضاء والقضاة في تونس وصولاً إلى تقويض مجمل ضمانات استقلالية القضاء وإخضاع القضاة لنظامٍ قوامه الهشاشة والخوف". واستدلّت الشبكة بتعطيل السلطة التنفيذية حركة النقل القضائية أكثر من عامٍ، بسبب إعادة إدماج قضاةٍ أقرّت المحكمة الإدارية بإيقاف إعفائهم، قائلةً أن هذا التعطيل شلّ عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ما يدلّ على استمرار الأزمة حتى اليوم.
سبق الشبكةَ العربيةَ تقريرٌ لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في 27 فبراير 2023 ذكر أن الرئيس قيس سعيّد كثّف هجماته على استقلال القضاء منذ 2022 عبر العزل والاعتقال. ووثّقت المنظمة توقيف عددٍ من القضاة ضمن ما وصفته السلطة "الحرب على الفساد"، دون تقديم ضماناتٍ قانونيةٍ كافيةٍ، وفي إطار إجراءاتٍ استثنائيةٍ تمنح الرئيس صلاحية إقالة أو توقيف القضاة بمرسومٍ رئاسي. وعدّت المنظمة أن هذه الخطوات تجسيدٌ لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وأن القضاة المستهدفين لم تُوجَّه لهم تهمٌ واضحةٌ أو شفافةٌ، بل استعملت ضدّهم تهمٌ فضفاضةٌ متعلقة بالأمن أو الفساد.
تَوافَق تقرير هيومن رايتس ووتش مع بيانٍ لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) في يونيو من ذلك العام، سلّط الضوء على إجراءات الرئيس سعيّد الممنهجة ضد الجهاز القضائي والعاملين فيه وتحويرها على مقاسه. ودعا البيان لوضع حدٍّ للاعتداءات على استقلالية القضاء.
كذلك فإن بورقيبة استبعد من لا يتماهى مع سياسته بالتأديب أو حركة النقل التعسفية لأماكن بعيدةٍ ونائية. وجاء في أطروحة جوش مايكل "كومباريتيف جستِس: جستِس إن تونيزيا آند ألجيريا (العدالة المقارنة: العدالة في تونس والجزائر) الصادرة في ديسمبر 2007، أن حزب الدستور الجديد فرض بقيادة بورقيبة هيمنته على الدولة. ووفق الكاتب، اعتمد الحزب دستور 1959 الذي نصّ في فصله الخامس والستين على أنّ القضاء مستقلٌ، والقضاة لا يخضعون في أدائهم إلا للقانون. لكن الممارسة خالفت هذا المبدأ.
كذلك لم يسمح بورقيبة بتأسيس جمعياتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ، وأنشأ محكمة أمن الدولة سنة 1968، التي تعدّ محكمةً استثنائيةً تنظر في القضايا ذات الطابع السياسي. وكانت المحكمة شكلاً من أشكال التحكم في الأحكام القضائية وسيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين من أحزابٍ ونقاباتٍ وإسلاميين.
ولعل أبرز القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة قضية "برسبكتيف" (أو آفاق)، التي تخص مجموعةً من الطلبة والمثقفين المعارضين حكمَ بورقيبة وقد حوكموا بلا أدلّة. بالإضافة إلى محاكمة النقابيين سنة 1978، التي جاءت عقب أحداث الخميس الأسود في يناير من ذلك العام، إذ شهد صداماتٍ داميةً بين عمّالٍ يقودهم الاتحاد العامّ التونسي للشغل وقوات الأمن والجيش. اتُّهمت قيادة الاتحاد، وعلى رأسها القيادي النقابي الحبيب عاشور، بـالتآمر على أمن الدولة. مثالٌ آخر وهو ملفات الإسلاميين في الثمانينيات. مثلاً رفضت سلطات بورقيبة منح تصريح العمل الحزبي لحركة الاتجاه الإسلامي، وقابلت طلب الحركة باعتقال عشراتٍ من أعضائها في يونيو 1981. قدمتهم للمحكمة بتهم "الانتماء لجمعية غير مرخصة" و"النيل من كرامة رئيس الجمهورية" و"توزيع منشورات معادية للنظام". وتراوحت أحكام المعتقلين بين عامٍ وأحد عشر عاماً.
يقول محمد حداد، المستشار في تقييم السياسات العامة وتنفيذها، في دراسة "تونس: بنية إدارة المسار المهني للقضاة، الإرث الاستعماري للنموذج الفرنسي" المنشورة سنة 2024، إن تونس تُعدّ من أكثر الأنظمة المعقّدة لإدارة الحياة المهنية للقضاة في العالم. هذا النظام أُنشئ عن قصدٍ ونفذ على مدى عقودٍ، مع تطويره حدَّ الإتقان. ويمتدّ مفعوله منذ الدخول أول مرةٍ في السلطة القضائية إلى غاية مرحلة التقاعد، ويبقى مؤثراً على القضاة حتى في حالة إلحاقهم إلى إداراتٍ أو مؤسساتٍ أخرى.
ووفق حداد، فأثناء حكم بورقيبة كان القضاء جزءاً من مشروع بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. أسّس بورقيبة المجلس الأعلى للقضاء أول مرةٍ سنة 1967 وترأّسه، فكان المجلس خاضعاً كلياً للرئيس. إذ كان بورقيبة يتدخل في الحكم مباشرةً، ويعاقب المتمردين بالنقل التأديبي للأماكن النائية، والعزل غير المعلن، والحرمان من الامتيازات. وكان يكافئ القضاة المقربين منه بالمناصب العليا.
وتضيف الدراسة أن المحاكم ظلّت منظَّمةً على النمط اللاتيني (القانون المدني) مع اختصاصاتٍ محدودة. فيما ظلّ ذراع الحكومة التنفيذي يؤثّر بقوةٍ في عمل السلطة القضائية. وأُنشئ مجلسٌ أعلى للقضاء يتولّى شؤون الإطارات القضائية، لكن تأثير الرئاسة والحكومة على التعيين والترقية والنقل والعقوبات أبقى القضاء بلا استقلالٍ فعليّ.
ولما سقط بورقيبة بانقلابٍ عسكريٍ ناعمٍ في السابع من نوفمبر 1987، وتولّى زين العابدين بن علي الحكمَ، جعل الرئيس الجديد القادم من المؤسسة الأمنية القضاءَ واجهةً مؤسسيةً لإضفاء الشرعية على النظام. فوضع المجلسَ الأعلى للقضاء تحت سلطته الفعلية، وسلّط عليه وزارة العدل للتحكم في قرارات القضاة داخل قاعات المحاكم وخارجها. كذلك وظّف بن علي القضاءَ لمحاربة خصومه السياسيين.
ومع أن بن علي أسقط محكمة أمن الدولة سنة 1987 إلّا أنه استمر في محاكمة معارضيه في محاكم عسكريةٍ ومدنية. ولعل أشهر القضايا ملاحقته الإسلاميين بداية التسعينيات، إذ رأى أن صعود حركة النهضة كان تهديداً مباشراً له. فخطّط لمحاكماتٍ جماعيةٍ لقيادات الحزب الإسلامي، وأبرزهم راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو.
تقول البريطانية آن وولف، المتخصصة في شؤون شمال إفريقيا، في كتابها "بوليتيكل إسلام إن تونيزيا: ذا هيستوري أوف ألناهدا" (الإسلام السياسي في تونس: تاريخ حركة النهضة) الصادر سنة 2017، إن بن علي استغل القضاء بداية التسعينيات لاستئصال الإسلاميين من الساحة السياسية على مدى عقدين. نفذ ذلك بمحاكماتٍ غير عادلةٍ، واعترافاتٍ منتزعةٍ تحت التعذيب. والنتيجة كانت أحكاماً قاسيةً أمرت بها السلطة لإزاحة النهضة من طريق الحكم.
كان هذا الاستغلال السياسي للقضاء سبباً في أن أرسل القاضي الراحل مختار اليحياوي، الذي كان يترأس المجلس الأعلى للقضاء، رسالةً مفتوحةً سنة 2001 للرئيس زين العابدين بن علي يطالب فيها برفع اليد السياسية عن القضاء التونسي. وقال القاضي في الرسالة: "أتوجّه إليكم بهذه الرسالة لأعبّر لكم عن سخطي ورفضي للأوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أدّت إلى تجريد السلطة القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية [. . .] إن القضاة التونسيين يعانون من حصارٍ رهيبٍ ولا يبقي أيّ مجالٍ للعمل المنصف".
في عهدَيْ بورقيبة وزين العابدين بن علي، مثّلت هذه المؤسسة الدستورية، التي تبلورت بعد استقلال تونس، واجهةً شكليةً للدولة، وكانت مرتبطةً برئاسة الجمهورية وتحت سيطرتها. وهو ما يشير إليه محمد حداد في دراسته، أن الترقيات وعمليات التنقلات السنوية في السلك القضائي، سواءً في عهد حكم بورقيبة أو بن علي، كانتا أدوات نفوذٍ وإخضاعٍ في يد السلطة منذ الاستقلال، سواءً لمعاقبة القضاة المعارضين أو مكافأة الطائعين.
أما في عهد قيس سعيّد فإدارة القضاء كانت مختلفة. فبعد إعلانه عن الإجراءات الاستثنائية، قرّر تعيين القاضية ليلى الجفال وزيرةً للعدل، وهي زميلة زوجة الرئيس، القاضية إشراف سعيّد. أشرفت الجفال مباشرةً على تنفيذ تدخل الوزارة في عمل القضاة، والذي كان يفترَض أن يبقى سلطةً مستقلةً حسب ما نصّ عليه دستور 2014. وقبله خصّص دستور 1959 باباً للسلطة القضائية وجعلها عنصراً أساساً لترسيخ مبادئ العدالة والقانون، لكنه لم يضمن استقلالها بما يكفي. مضافٌ لهذا أن وزيرة العدل التي احتفظت بمنصبها منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في 2021، أشرفت على تعيين قضاةٍ بعددٍ من المراكز القضائية لسدّ شغور القضاة المُعْفَيْن، مع أن المحكمة الإدارية أمرت بإرجاعهم لمناصبهم.
استمرّ قيس سعيّد على نهج أسلافه في تحكمهم بمجرَيات القضاء، بل إنه تجاوزهم بإعادة هندسة القضاء عبر المراسيم. وحوّل القضاء من مؤسسةٍ مستقلةٍ نسبياً إلى جهازٍ إداريٍ تابعٍ للرئاسة. لم يعاقب القضاة، كما فعل بورقيبة وبن علي، بل أحكم قبضته الأمنية وأمر باعتقال كلّ قاضٍ معارضٍ، ووجّه لهم تهماً سياسيةً ثقيلةً كالمساس بأمن الدولة، والتخطيط للانقلاب، والتخطيط لعملٍ إرهابي.
ولأول مرةٍ في تاريخ تونس الحديثة، وبمرسومٍ رئاسيٍ، تقرّر منع القضاة من الإضراب ومنع كلّ عملٍ جماعيٍ من شأنه "تعطيل سير القضاء". وهو ما يعني تجريم أيّ فعلٍ احتجاجيٍ، ووضع القضاة الذين يفعلونه تحت طائلة العقوبات الإدارية التي يمكن أن تصل إلى الإعفاء والملاحقات الجزائية.
يعلّق على هذا التغيير في عهد سعيّد الكاتب الإسباني توماس دسرو في دراسةٍ صادرةٍ في مارس 2025 تحت عنوان "قيس سعيّد غوفيرنينس" (حكم قيس سعيّد). فيقول إن القضاء كان أكثر القطاعات تأثراً بقرارات الرئيس، وتحوّل من سلطةٍ دستوريةٍ مستقلةٍ إلى جهازٍ تنفيذيٍ خاضعٍ مباشرةً للرئاسة، من المراسيم وتغيير الدستور 2022 الذي وصف القضاء "وظيفة" لا "سلطة". ويرى دسرو أن هذه الخطوات التي اتخذها سعيّد – أي المراسيم 117 و 11 و 35 – لم تكن إصلاحاتٍ بل وسيلةً لتركيز السلطة. إذ تحوّل القضاء من رقيبٍ محتملٍ على السلطة التنفيذية إلى أداةٍ لترهيب المعارضين.