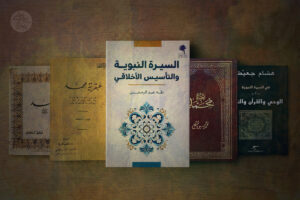استعمرت فرنسا وإسبانيا المغربَ بموجب اتفاقيات فرضت نظام الحماية منذ سنة 1912. لكن هذا الاستعمار خلَّف نزاعاتٍ حدوديةً استمرّت حتى بعد الاستقلال واستفادت منها الدول الكبرى التي أدّت دوراً في إدارة الصراع لتضمن مصالحها السياسية والاقتصادية. فاستعادة المغرب السيادةَ على أراضيه تدريجياً وصولاً لاستعادة الأقاليم الصحراوية سنة 1975، لم يُنهِ الأزمة في هذه المنطقة الشاسعة التي تحدّها الجزائر شرقاً وموريتانيا جنوباً والمحيط الأطلسي غرباً والمغرب شمالاً. إذ سرعان ما اندلعت التوترات مع بروز جبهة البوليساريو، التي رفضت السيادةَ المغربية على الإقليم وطالبت بإقامة دولةٍ مستقلةٍ في الصحراء، مدعومةً سياسياً وعسكرياً من الجزائر. في حين ظلّ المغرب يؤكد أن هذه الأراضي جزءٌ لا يتجزأ من سيادته الوطنية.
ونتيجةً لهذا التباين، ارتقى نزاع الصحراء الغربية إلى مستوىً إقليميٍ معقّدٍ، بعدما قرّرت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، احتضان جبهة البوليساريو ودعم مطالبها بالانفصال. ولم يقتصر الأمر على البعد الإقليمي، إذ سرعان ما تحوّل النزاع إلى ورقةٍ بيد القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، التي سعت إلى تمديد الصراع ووجدت فيه فرصةً لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا، عبر صفقاتٍ اقتصاديةٍ وإستراتيجيةٍ، أو من خلال موازنة النفوذ وضبط موازين القوى. ومن المتوقع أن تشهد جلسة أكتوبر 2025 في مجلس الأمن الكلمة الأخيرة في قضية الصحراء الغربية، حسب ما صرّح المبعوث الأممي في قضية الصحراء ستافان دي ميستورا الذي يعتقد بأن الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي سيُعجل بحلّ الملف، شرط "تقديم دعمٍ فعّال".
أما الوجود الإسباني في المغرب، فقد سبق الاستعمارَ الفرنسيَّ بزمنٍ طويلٍ وجاء على مراحل متعدّدة. ففي القرن الخامس عشر، احتلت إسبانيا مدناً ساحليةً مثل سبتة ومليلية والناظور. ثم توسعت في القرن التاسع عشر لتسيطر على تطوان، قبل أن تشارك فرنسا في فرض نظام الحماية على المغرب مطلع القرن العشرين. وبموجب اتفاقٍ بين القوتين الاستعماريتين، قُسمت المملكة المغربية، فكان نصيب إسبانيا المنطقةَ الشمالية التي سمِّيَت "المنطقة الخليفية" إلى جانب المنطقة الجنوبية التي عرفت لاحقاً بِاسم "الصحراء الإسبانية".
بعد استعادة المغرب سيادته من فرنسا سنة 1956، شرعت المملكة في استرجاع باقي مناطقها تدريجياً. فبدأت باستعادة المنطقة الشمالية الخاضعة للاحتلال الإسباني، ثم أنهت الوضع الدولي لمدينة طنجة في يوليو من السنة نفسها، معلنةً وحدتها السياسية مع البلاد من جديد. غير أن الجنوب المغربي ظلّ تحت السيطرة الإسبانية، وهو ما جعل استكمال الوحدة الترابية هدفاً إستراتيجياً للدولة، سعت إلى تحقيقه بالمقاومة المسلحة التي قادها جيش التحرير، إلى جانب التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية.
في خضم هذا المسار التحرري، كثّف المغرب جهوده لاسترجاع أقاليمه الجنوبية. فخاض جيش التحرير المغربي بين سنتَيْ 1957 و1958 معارك مع قوات الاحتلال الإسباني في منطقتي طرفاية وسيدي إفني. ورغم تحالف إسبانيا مع فرنسا لمحاصرة المقاومة، اضطرت قوات المستعمر في نهاية المطاف إلى التفاوض. ووُقّعت اتفاقية أنغرا دي سينترا في أبريل 1958، التي استعاد المغرب بموجبها منطقة طرفاية. فيما بقيت سيدي إفني تحت السيطرة الإسبانية إلى أن استرجعت سلمياً سنة 1969، بفضل ضغطٍ دبلوماسيٍ وشعبيٍ توّج باتفاقٍ رسميٍ بين البلدين.
شكَّل الوجود الإسباني في الصحراء الغربية أكبر عقبةٍ أمام استكمال الوحدة الترابية للمغرب في 1975، وهي السنة التي شهدت تحولاً حاسماً في مسار القضية. ففي خريف ذلك العام، أطلق الملك المغربي حينها الحسن الثاني "المسيرة الخضراء"، وهي مسيرةٌ شعبيةٌ سلميةٌ شارك فيها نحو ثلاثمئةٍ وخمسين ألف مغربيٍ اجتازوا الحدود إلى الصحراء بهدف الضغط على إسبانيا لإنهاء احتلالها. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع رأيٍ استشاريٍ صادرٍ عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، أقرّ بوجود روابط قانونيةٍ وتاريخيةٍ بين القبائل الصحراوية وسلطان المغرب، وإن لم يمنح المغرب سيادةً قانونيةً مباشرةً على الإقليم.
أسفر الضغط الشعبي والدبلوماسي عن توقيع "اتفاق مدريد" في نوفمبر 1975 بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا. نصّ الاتفاق على نقل إدارة الإقليم إلى كلٍّ من المغرب في شمال الصحراء وموريتانيا في جنوبها، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسبانية. غير أن هذا التطور فتح الباب أمام نزاعٍ جديدٍ، بعد بروز "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة بِاسم "البوليساريو" والتي تأسست سنة 1973 ورفضت الاتفاق، مطالبةً باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب وموريتانيا معاً.
انبثقت البوليساريو عن ما سُمّي "الحركة الجنينية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، التي تأسست بمبادرةٍ من شبابٍ صحراويين كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط. وكان هدفهم في البداية يقتصر على تصفية الاستعمار الإسباني ولم يُعبروا عن أيّ توجهاتٍ انفصالية. غير أن التطورات السياسية والميدانية، ولاسيما بعد توقيع اتفاق مدريد وظهور الدعم الجزائري، دفعت الجبهة إلى المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، وتأسيس دولةٍ مستقلة.
تتخذ البوليساريو من منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر مقراً لها تدير منه أنشطتها السياسية والعسكرية. وتحظى الجبهة بدعمٍ سياسيٍ وعسكريٍ كبيرٍ من الجزائر، التي دعمت الجبهة في المحافل الدولية. وتواصل البوليساريو إلى اليوم المطالبةَ بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، والسعيَ إلى إقامة ما تسمّيه "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وهي كيانٌ أعلنته من جانبٍ واحدٍ سنة 1976 ولم يحظَ باعترافٍ أمميٍ حتى الآن.
وفي ظلّ تصاعد هجمات جبهة البوليساريو، وجدت موريتانيا نفسها تحت ضغطٍ عسكريٍ واقتصاديٍ كبيرٍ، خاصةً بعد أن وسّعت الجبهة عملياتها إلى العمق الموريتاني. وبفعل هذا الاستنزاف، قرّرت نواكشوط، عاصمة موريتانيا وأكبر مدنها، الانسحاب من إقليم وادي الذهب سنة 1979، وتخلّت رسمياً عن مطالبها الترابية في الصحراء الغربية بموجب اتفاقٍ وقّعته مع البوليساريو. واستغل المغرب هذا الانسحاب ليبسط سيطرته على الجزء الجنوبي من الإقليم، ويعلن أن الصحراء بكاملها جزءٌ لا يتجزأ من أراضيه، وهو ما زاد تعقيد النزاع الإقليمي.
يقول محمد بوكطب، الحاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية من جامعة محمد الأول، في دراسته "الصحراء المغربية بين التسوية الأممية والمبادرة المغربية"، المنشورة سنة 2020: "في سنة 1973، انتقلت إسبانيا إلى الحديث عن إمكانية قيام كيانٍ منفصلٍ في الصحراء، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فأعلنت أن شعب الصحراء قد عبّر عن رأيه من خلال الجماعة الصحراوية بالانضمام لإسبانيا".
وأضاف بوكطب أنه "بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية، وتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الإدارة من إسبانيا، وبينما اعتبر المغرب أن ملف الصحراء قد طوي إلى الأبد، كانت البدايات الأكثر عنفاً لقضية الصحراء تنسج خارج الأقاليم الصحراوية، وبالضبط داخل الأراضي الجزائرية".
تسوّغ الجزائر دعمَها البوليساريو بالرغبة في تصفية الإرث الاستعماري في المنطقة، ودعم الشعوب في تقرير مصيرها. خاضت الحكومة الجزائرية حراكاً دبلوماسياً طيلة أكثر من خمسين عاماً لحشد مواقف دوليةٍ لدعم جبهة البوليساريو في تأسيس دولةٍ صحراويةٍ جديدة. ولا تعدّ الجزائر نفسها طرفاً في نزاع الصحراء الغربية، لكن المغرب يطلبها للجلوس على طاولات المفاوضات في الأمم المتحدة لأنه يعدّها طرفاً في النزاع.
الباحث المغربي في العلاقات الدولية ورئيس وحدة البحوث والدراسات بمركز أركان، إيهاب العاشق، قال لمجلة الفراتس إن "الدعم الكبير وغير المشروط من قِبل الجزائر للبوليساريو، نابعٌ من كون الجزائر في حرب زعامةٍ مع المغرب حول النفوذ الإقليمي. وخروج الصحراء من السيادة المغربية سيقدّم للجزائر منفذاً بحرياً على المحيط الأطلسي".
وأضاف أن إطالة أمد النزاع في الصحراء يصرف أنظار المغرب عن مطالبته بـالجزء الغربي من الجزائر، الذي اندلعت بسببه حرب الرمال سنة 1963. وقد نشب هذا النزاع المسلح بعد أقل من عامٍ على استقلال الجزائر، بسبب خلافٍ حدودي. إذ تمسكت الجزائر بالحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، في حين طالب المغرب بأجزاء من الجنوب الغربي الجزائري، مستنداً إلى ما عدّه "حقاً تاريخياً".
من جهته، يرى محمد الشيخ بيد الله أن للجزائر دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع على الصحراء الغربية، مؤكداً أن "عدم طيّ هذا الملف بشكلٍ نهائيٍ يعود بشكلٍ أساسيٍ إلى معارضة الجزائر منذ البداية لأيّ مسارٍ تفاوضيٍ بين المغرب وإسبانيا". وأضاف أن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين كان من أبرز المعارضين لعودة الصحراء إلى السيادة المغربية، بل إنه "عرقل كلّ محاولات التسوية وهدّد بإشعال المنطقة إذا ما عادت الصحراء للمغرب"، على حدّ تعبيره. هذا المعطى الأساسي ذكرته فعلاً وثيقةٌ لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعود لشهر يناير 1977، رفعت عنها السرية في نوفمبر 2021.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية في حديثٍ لمجلة الفراتس، أن موقف الجزائر من النزاع لم يتغير منذ عهد الرئيس بومدين رغم تعاقب الرؤساء على الحكم. ويؤكد أن الثبات في الموقف الجزائري كان أحد الأسباب الرئيسة التي عطّلت التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ نهائيٍّ للنزاع.
وفي ظلّ تعثر المساعي الأممية واستمرار الموقف الجزائري الرافض أيَّ حلٍّ لا يفضي إلى تقرير الصحراويين مصيرهم، لجأ المغرب إلى عرض مبادرةٍ جديدةٍ لتجاوز حالة الجمود. ففي 11 أبريل 2007، تقدم المغرب إلى الأمم المتحدة، التي كان يتولّى أمانتها العامة آنذاك بان كي مون، بمبادرة منح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية. وهو المقترح الذي رحّب به مجلس الأمن ورفضته الجزائر والبوليساريو معاً.
يعتقد عبد الفتاح الفاتحي أن بعض القوى الكبرى ترى الجزائر خزاناً نفطياً وغازياً مهماً، والمغرب موقعاً إستراتيجياً محورياً في شمال إفريقيا، فضلاً عن كون البلدين سوقين مهمين للسلاح. وضمن هذا التصوّر، تستخدم استدامة نزاع الصحراء أداةً ضمن إستراتيجيات النفوذ المتبادلة. إذ تسعى الجزائر إلى الحفاظ على موقعها مزوداً رئيساً للطاقة إلى أوروبا، مدعومةً في ذلك بمواقف روسيا والصين داخل بعض المحافل الدولية.
وهنا برز بُعدٌ جديدٌ للصراع، يتجاوز الجغرافيا والنزاعات التاريخية، ليكشف عن رهاناتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ وإستراتيجيةٍ أوسع، ترتبط بمصالح الطاقة والتحالفات العسكرية وممرات التجارة الإقليمية. يقول الفاتحي: "يتّضح أن القوى الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى جانب فرنسا وإسبانيا باعتبارهما قوّتين استعماريتين سابقتين، تعتمد في كثيرٍ من الأحيان على قضايا النزاع الإقليمي كأدواتٍ لإدارة توازناتٍ دقيقةٍ في العلاقات الدولية"، مؤكداً أن هذا ما جعل قضية الصحراء تُدوّل على أعلى مستوىً منذ الحرب الباردة، إذ تحوّلت إلى ملفٍ إستراتيجيٍ ضمن صراعات النفوذ الدولية.
من جهته يقول الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الأول في وجدة، محمد بوكطب: "أصبحت قضية الصحراء أداةً لتعميق تبعية دول المنطقة. علاوةً على أن المنطقة المغاربية هي منطقةٌ حيويةٌ للأمن الإستراتيجي لأوروبا ولحوض المتوسط". وأضاف: "بالاستناد إلى مجموعةٍ من الاعتبارات التي عزّزها الماضي الاستعماري سواءً في المغرب أو في الجزائر، أو حتى بالنسبة للمنطقة المغاربية وبلدان إفريقيا الساحل فإن "سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغاربية ترتكز على التحكم في العلاقات المغربية الجزائرية، بحسب الأولوية المحددة من طرف تلك القوى".
ساعد توظيف هذا النزاع الولايات المتحدة على مقايضة المغرب باعترافها بمغربية الصحراء مقابل توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل. في 10 ديسمبر 2020، أصدر البيت الأبيض بياناً جاء فيه أن الرئيس ترامب "يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وفي نفس البيان اتفق المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما". هذا التحول في التموضع السياسي أضعف هامش الموقف المغربي، وجعله أكثر حذراً في مواقفه تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، كما ظهر جلياً في تعاطيه مع الحرب الأخيرة في غزة، والتي اكتفى فيها ببعض بيانات إدانةٍ ضعيفةٍ، ولم يتخذ موقفاً كما حصل في الانتفاضة الثانية سنة 2000 عندما قررت الرباط إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المملكة، احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية. أما على الصعيد العسكري، فعزّزت الولايات المتحدة حضورها في منطقة شمال إفريقيا مستغلةً نزاع الصحراء لتوقيع صفقات تسليحٍ كبرى مع المغرب. تشمل الصفقات بيع مقاتلات إف 16 ومنظومات باتريوت الدفاعية وطائراتٍ مسيّرةً، إلى جانب تدريباتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ، أبرزها مناورات الأسد الإفريقي، وهو أكبر تمرينٍ عسكريٍ في القارة الإفريقية، والذي يعطي للجيش الأمريكي حضوراً عسكرياً دائماً ونقطة ارتكازٍ إستراتيجيةً غرب المتوسط.
ومما يؤكد استغلال واشنطن قضيةَ الصحراء عسكرياً إعلانها في بيان التطبيع الرسمي نفسه عن صفقة تسلّحٍ أمريكيةٍ للمغرب بقيمة مليار دولارٍ، شملت أربع طائراتٍ مسيّرةٍ من نوع "سي غارديان إم كيو 9-ب" وذخائر متطورة. وغداة التوقيع أبلغت إدارة ترامب الكونغرسَ رسمياً بصفقة التسلح.
رغم التوتّر بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، تسعى واشنطن لتحويل الجزائر إلى مصدر طاقةٍ مهمٍ وشريكٍ محتملٍ في مواجهة النفوذ الروسي والصيني المتزايد في المنطقة. وقد تجسَّد ذلك في سلسلة اتفاقياتٍ حديثة التوقيع للتنقيب عن النفط والغاز بين شركة سوناطراك، المسيرة للنفط والغاز الجزائري، وشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، بالإضافة إلى اتفاق تعاونٍ مع شيفرون في مجال الاستكشاف البحري. كذلك ذكر تقريرٌ لمعهد واشنطن للسياسات صدر في يوليو 2025 رغبةَ واشنطن في تعزيز العلاقات مع الجزائر لمواجهة التمدد الاقتصادي والعسكري الروسي والصيني في المنطقة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
في الجهة المقابلة استمرت روسيا في تبنّي الموقف الجزائري بشأن نزاع الصحراء داخل مجلس الأمن. ويتجلّى ذلك في امتناعها المتكرر عن التصويت على قرارات تمديد ولاية بعثة "المينورسو" (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، مثل القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي مدّد مهمة البعثة إلى 31 أكتوبر 2025. وتلجأ موسكو في مداخلات ممثليها إلى التشديد على "حلّ متوازن يرضي الطرفين"، رافضةً ما تعدّه "ضغوطاً غربية" لفرض حلولٍ أحادية.
وإلى جانب امتناعها المتكرر عن التصويت داخل مجلس الأمن، حرصت روسيا على التنسيق المسبق مع الجزائر لتوحيد المواقف. ففي 9 أكتوبر 2024، التقى السفير الجزائري في موسكو نائبَ وزير الخارجية الروسي لبحث الموقف قبل تصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية "المينورسو". كذلك شهد شهر يونيو 2024 محادثاتٍ مماثلةً على هامش جلسة لجنة تصفية الاستعمار (سي-24)، جدّدت فيها موسكو دعمها لخيارات الجزائر وجبهة البوليساريو، ما يعكس تناغماً دبلوماسياً متزايداً بين الطرفين قبيل الاستحقاقات الدولية.
ولا يقتصر التنسيق بين روسيا والجزائر على الساحة الأممية فحسب، بل يمتد إلى مجالَي الطاقة والتسليح. فبعد حرب أوكرانيا وما تبعها من فقدان موسكو جزءاً من أسواقها الأوروبية، برزت الجزائر حليفاً إستراتيجياً لتأمين منفذٍ بديلٍ للغاز الروسي وتعزيز التعاون العسكري، ما يمنح روسيا حافزاً إضافياً لمساندة الموقف الجزائري في نزاع الصحراء.
وقد استوردت الجزائر أسلحةً روسيةً تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولارٍ خلال العقد الأخير. وحسب تقرير معهد ستوكهولم للسلامة ونزع التسلح الصادر في أبريل 2025 فإن 48 بالمئة من واردات السلاح الجزائرية خلال الفترة ما بين 2020 و2024 جاءت من روسيا. وتشمل هذه الأسلحة طائرات سوخوي ومنظومات دفاعٍ جوّيٍ متطورة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركاتٌ روسيةٌ مثل "غازبروم" و"لوك أويل" اتفاقياتٍ للتنقيب والاستثمار في الجزائر، مع بحث فرص شراكاتٍ في مجال الغاز الطبيعي المسال.
ومع الدعم غير المباشر الذي تحظى به الجزائر من موسكو، اختار المغرب الإبقاء على تعاونه معها للحدّ من تدخّلها في نزاع الصحراء. ويشير مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، إلى أن الرباط واصلت تعاونها العسكري والاقتصادي مع روسيا وحتى الصين، ما مكّنها من ضمان حيادٍ نسبيٍ من بكين ومواقف أكثر توازناً من موسكو. ويتجلى ذلك في مشاريع إستراتيجيةٍ مثل "مدينة محمد السادس طنجة تك" التي تعد أبرز استثمارات الصين في شمال إفريقيا، وفي عقود التبادل التجاري مع روسيا التي شملت الفوسفات والحبوب والطاقة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والصين ما يربو على تسعة مليارات دولارٍ خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، فيما تبقى حصة روسيا أقلّ، إذ تقدر قيمة صادراتها الزراعية إلى المغرب بنحو 280 مليون دولار في 2024.
وتنعكس هذه المصالح على سياسات القوى الكبرى في نزاع الصحراء. فالولايات المتحدة وروسيا كثيراً ما وظّفتا هذه النزاعات الحدودية للتحكم في ولاء التوجه السياسي للدول المعنيَّة بالنزاع. وهو ما تمثّل في الصراع الإقليمي الذي وظّفت فيها الجزائر في جعل ملف الصحراء جزءاً من التنافس السياسي بين موسكو وواشنطن على مناطق النفوذ".
وبحكم قربها الجغرافي وصِلتها التاريخية بالمنطقة، لم تتبنَّ فرنسا موقف الحياد حيال نزاع الصحراء الغربية، وانحازت بوضوحٍ إلى الطرح المغربي، مستعملةً نفوذها الدبلوماسي والعسكري لحماية موقف المغرب داخل مجلس الأمن ومنع أيّ قراراتٍ قد تضعف موقعه، وهو ما منح المغرب سنداً دولياً قوياً.
وعزّزت باريس تعاونها العسكري والأمني مع المغرب، ليصبح شريكاً أساسياً لها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية بمنطقة الساحل وغرب المتوسط. وفي الجانب الاقتصادي، استفادت الشركات الفرنسية الكبرى من هذا التقارب عبر توسّعٍ واضحٍ في قطاعات السيارات والطاقة والبنية التحتية.
ومنذ نحو خمسة عقود، استفادت فرنسا من إبقاء النزاع بلا حلّ. إذ يضعف النزاع الاتحادَ المغاربي ويعطّل قيام كيانٍ اقتصاديٍ وسياسيٍ مغاربيٍ قد يزاحم فرنسا في العمق الإفريقي. وبالتالي تُبقي فرنسا نفوذَها في بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية عبر شراكاتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ، مستفيدةً من انشغال القوتين المغاربيتين بالنزاع. وقد مكّنها التحالف مع المغرب من ضمان سوقٍ واسعةٍ لشركاتها الكبرى في مجالات السيارات (مثل رينو وبيجو) والطاقة والبنية التحتية، ومنحها نفوذاً سياسياً في غرب المتوسط ومناطق إفريقيا الناطقة بالفرنسية. وفي الجانب الأمني، استفادت باريس من موقع المغرب وجعلته خطاً أمامياً في مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية القادمة من منطقة الساحل، ما جعل استدامة النزاع تصبّ في مصلحتها لضمان بقاء المغرب معتمداً على الدعم الفرنسي.
واختارت فرنسا الانحياز للمغرب بدل الجزائر لأن علاقتها مع الجزائر تبقى حبيسة ذاكرةٍ استعماريةٍ داميةٍ وشراكاتٍ متوترةٍ تميل نحو موسكو وبكين، لتبرز الجزائر منافساً سياسياً يسعى إلى تقليص النفوذ الفرنسي في إفريقيا. وعرقلت باريس كلّ مبادرةٍ تدعو إلى تنظيم استفتاءٍ حول نزاع الصحراء أو توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما حصل سنة 2006 عندما رفعت حقّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد فقرةٍ تدعو إلى مراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، وفي سنة 2013 استخدمت كلّ وسائلها الدبلوماسية لمنع التمديد ليشمل آلياتِ رصدٍ حقوقيةً في الصحراء. كذلك دعمت مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، وهو ما أضعف المسار الأممي الذي كان قائماً على تقرير المصير.
وعلى الصعيد العسكري، عزّزت باريس تعاونها الدفاعي والاستخباراتي مع الرباط، وجعلت من الجيش المغربي شريكاً رئيساً في تدريباتٍ ومناوراتٍ مشتركةٍ، بما يرسّخ موقعه في مواجهة الجزائر وجبهة البوليساريو. كذلك نظّمت مع الرباط مناوراتٍ جويةً وبحريةً مشتركةً مثل "شيركي" و"شيبيك"، وتبادلا الخبرات في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، إلى جانب صفقات تسلّحٍ شملت طائرات نقلٍ وأجهزة رصدٍ وزوارق حربية. هذا التعاون جعل من الجيش المغربي شريكاً مفضلاً لفرنسا وركيزةً أساساً في إستراتيجيتها الأمنية بغرب المتوسط، كما منح الرباط غطاءً إستراتيجياً يعزّز موقعها في مواجهة الجزائر وجبهة البوليساريو.
وإذا كانت فرنسا قد اختارت الانحياز الواضح للمغرب عبر دعمٍ دبلوماسيٍ وعسكريٍ مكّنها من تثبيت نفوذها في المنطقة، فإن إسبانيا، المستعمر السابق لإقليم الصحراء، كانت تستخدم مبدأ إمساك العصا من المنتصف إلى حدود 2021. فقد تركت إسبانيا النزاع مفتوحاً منذ انسحابها سنة 1975 باتفاق مدريد الثلاثي، واستعملته ورقة ضغطٍ متجددةً في علاقاتها مع كلٍّ من الرباط والجزائر.
ففي ثمانينيات القرن العشرين، ربطت إسبانيا أيّ نقاش حول الصحراء بملف سبتة ومليلية، المدينتين اللتين تعدّهما الرباط مغربيتين. كذلك استفادت من اتفاقيات الصيد البحري التي شملت مياه الصحراء لتعزيز نفوذها الاقتصادي. وتبنّت مواقف مترددةً داخل الأمم المتحدة خلال التسعينيات وبداية الألفية. في سنة 1991 مثلاً، لم تعارض مدريد علناً الاستفتاء حول إقليم الصحراء، لكنها في الوقت نفسه لم تضغط لتنفيذه. وسنة 2002 امتنعت إسبانيا عن تقديم رأيها بمحكمة العدل الدولية حول اتفاق مدريد، وفضّلت الاكتفاء بدور المراقب، وهو ما سمح لها بتأمين شراكاتها مع المغرب ممرّاً تجارياً وأمنياً، مع ضمان إمدادات الطاقة من الجزائر مورّداً رئيساً للغاز.
وفي السنوات الأخيرة، واصلت إسبانيا توظيف النزاع لتحقيق مكاسب آنيّة. ففي 2021 اندلعت أزمةٌ دبلوماسيةٌ مع الرباط بعد استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ما دفع المغرب إلى التلويح بورقة الهجرة عبر تدفق آلاف المهاجرين على سبتة. كذلك أدّى إعلان إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية سنة 2022 إلى ردّ فعلٍ جزائريٍ تمثّل في تعليق معاهدة الصداقة وتقليص صادرات الغاز. وإلى جانب ذلك، ما زالت مدريد تستخدم اتفاقيات الصيد البحري وملف الهجرة غير النظامية أدوات ضغطٍ متجددةً في علاقاتها مع الجانبين.
في إحاطته الأخيرة في إطار مشاورات مجلس الأمن بنيويورك يوم 14 أبريل 2025، يبدو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، متفائلاً بإنهاء هذا النزاع مع متمّ هذه السنة. جاء في نص إحاطة دي ميستورا: "وفي رأيي، فإن الأشهر الثلاثة المقبلة تشكل فرصةً لتقييم كيف يمكن لاندفاعةٍ جديدةٍ قائمةٍ على انخراطٍ نشطٍ ومتجدّدٍ من بعض أعضاء المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، أن تسهم في تهدئةٍ إقليميةٍ، وفي الوقت نفسه، إطلاق خريطة طريقٍ جديدةٍ نحو حلٍّ نهائيٍّ لنزاع الصحراء الغربية".
هو السيناريو، حسب المبعوث الأممي، الذي سيجعل من جلسة أكتوبر المرتقبة فرصةً حاسمةً لحلّ ملف الصحراء. لكن دي ميستورا يشترط في الإحاطة نفسها أن يكون كلّ ذلك مقروناً مع "تقديم دعم فعّال".
يقحم المسؤول الأممي إشاراتٍ مهمةً في سياق التوصل إلى حلٍّ لهذا الملف. تقول الإحاطة: "أما الرسالة الثالثة فهي الأهم، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم الانخراط المباشر في تسهيل التوصل إلى حلٍّ متفقٍ عليه. وفي مثل هذه الحالة، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف هذا المجلس والأمين العام، فإن الأمم المتحدة، وأنا شخصياً، يمكن أن تكون داعمةً لهذا الانخراط".
على المستوى المغربي، فإن إحاطة ستافان دي ميستورا الأخيرة توحي باقتراب إنهاء ملف الصحراء، الذي يعدّ القضية الأولى عند المغاربة، لأن القرارات التي صار يصدرها مجلس الأمن الدولي حول الصحراء تنحو في اتجاه فرض الحكم الذاتي حلاً نهائياً للنزاع.