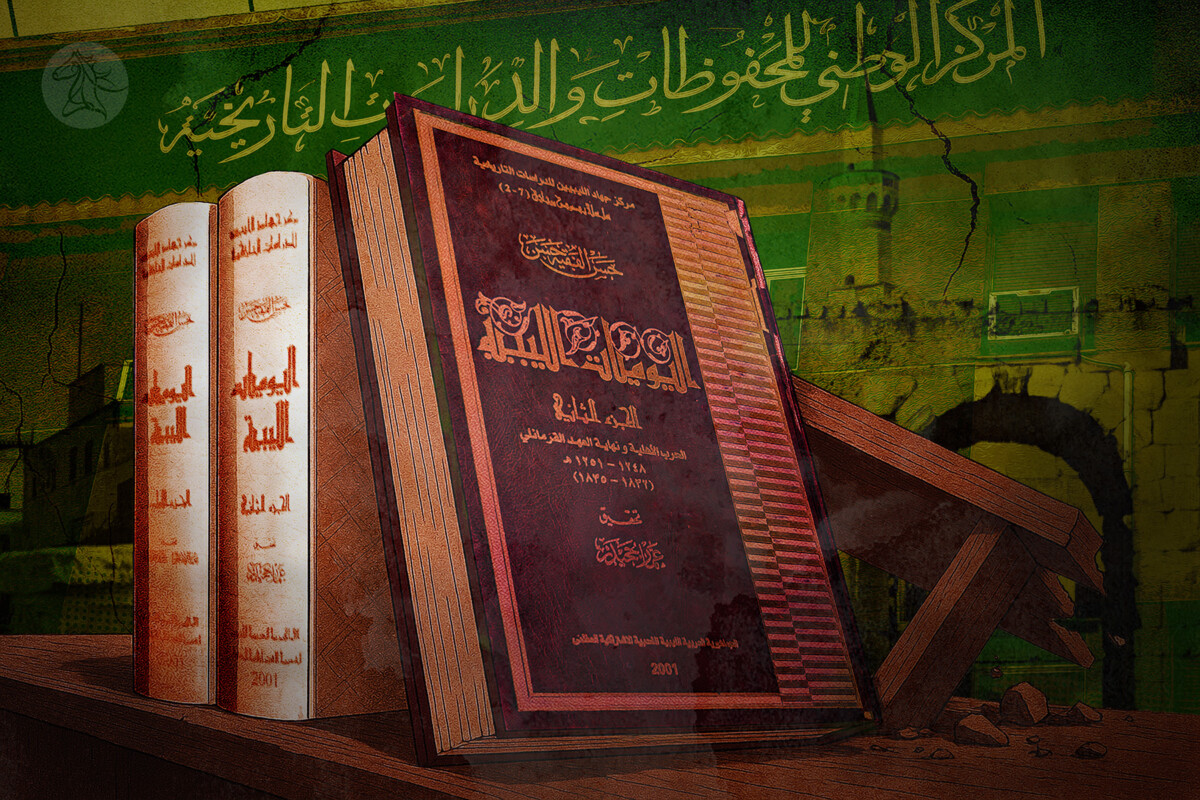ظرف صدور الجزء الثالث من "اليوميات"، كما يسميها الليبيون، كان مختلفاً عن الجزئيْن الأول والثاني. فقد أتاحه محقِقُه المؤرخ عمّار جحيدر للقراء نسخةً رقمية عبر موقعه الشخصي "آفاق". وكان الجزءان الأولان صدرا بطبعة فاخرة سنتي 1984 و2001 توالياً عن "المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية"، المؤسسة الرسمية المنية بجمع الوثائق والمخطوطات التاريخية الليبية وحفظِها وفهرستها وحمايتها. حقق الجزء الأول المؤرخ الراحل محمد الأسطى وجحيدر، والثاني حققه جحيدر بعد رحيل الأسطى سنة 1991. ومع أنّ جحيدر في جزء الكتاب الثالث ينسبُ ملكيته إلى المركز، إلا أنّ المركز حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم يصدر نسخةً ورقيةً منه.
أُسِّسَ المركز بدايةً تحت اسم "مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي" سنة 1977. كان الاسم إظهاراً لفهمِ سياسات الجماهيرية الليبية بزعامة العقيد معمر القذافي نحو توظيف التاريخ الليبي في روايته، من الاستعمار الإيطالي لفترة ما بعد الاستقلال، انتقالاً لما بعد ثورة الفاتح سنة 1969. لكنه مع ذلك كان فرصةً للباحثين الليبيين والمؤرخين للتدرّب ودراسة مخطوطات تاريخية وشهادات شفوية لم يطلع عليها أحد قبلاً. وبعد ثورة 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام القذافي، همّشت الدولة الليبية المركزَ والمؤسساتِ الثقافية والسياسات الثقافية بداعي العجز المالي. ليكون كتاب "اليوميات" شاهداً على تحوّل أولويات الدولة الليبية وسياساتها نحو التاريخ الثقافي والاجتماعي في البلد.
كان حسن شاهداً على مراحل مهمة في التاريخ الليبي. ولِد في آخر عهدِ علي باشا القرمانلي، حاكم طرابلس. وعايش انتزاعِ يوسف باشا ابن علي باشا الحكمَ من يدِ أخيه الأكبر حسن وقتله، وكذلك ثورة يوسف على أبيه حتى ترك أبوه الحكم سنة 1793. وكان لحسن الفقيه علاقات مالية بحكّام طرابلس ومنهم يوسف باشا والولاة العثمانيين مثل أحمد عزت باشا والي طرابلس من 1848 إلى 1852. وكان حسن الفقيه أحدَ رجالات الدولة، عضواً في مجلس الشورى. فأتاحت له مكانته هذه أن يكون مطلعاً على أخبارِ قصرِ السراي الحمراء، مركز الحكم في البلاد، سواءً كانت أخباراً اجتماعية أو سياسية أو حتى دينية.
أرّخ حسن الفقيه حسن في أجزاءِ اليوميات للحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية على مدار خمسين عاماً من سنة 1810 إلى 1861. فنجده يكتب عن ولادة أبنائه أو أولاد أعلام المدينة وناسِها وعن الوفيات والزيجات وأخبار السفر والحج والشجارات والصلح، وكل ذلك بتأريخٍ دقيق ومفصّل باليوم والتاريخ الهجري. نراه أيضاً، بحكم تخصصه في التجارة، يسجّل كل شاردة وواردة في السوق وتحولاته وتغيرّاته وما نزل بالميناء من بضاعة ومن أين جاءت.
يقول عمار جحيدر للفِراتْس إنّ حسن الفقيه كان مطلعاً على "معطيات التاريخ الكمي في اللغة العربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر"، فقد كان يسجّل تغيرّات الأسعار والضرائب في السوق بدقة. وبذلك تنطوي يومياته على "جوانب أصيلة غزيرة من مختلف ألوان التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تشد إليها الباحث والقارئ شداً. ويبدو اتساقها الجلي مع مفهوم التاريخ الحقيقي، التاريخ المجتمعي الذي يرصد مختلف الشرائح".
كتب حسن الفقيه يومياته بلهجة طرابلس المحلية المليئة بمصطلحاتٍ تركيةٍ وأوروبية منها الإيطالية والإنجليزية، ما يشي أنّ استعمالَ اللغة الإيطالية في ليبيا يسبق الاحتلال بعقودٍ. من هنا يرى جحيدر أنّ اليومياتِ وثيقةٌ لغوية تفصح عن لهجةِ أهل طرابلس السائدة وقتها، ما يمكِّن "دارسي اللهجات من الوقوف على مرحلة من مراحل تطورها في ليبيا". وقد أصدر جحيدر نفسه معجماً لغوياً سمّاه "معجم اليوميات الليبية" سنة 2021، يتناول فيه مسائل اليوميات اللغوية ومراحل تحقيقها ليكون كتاباً توثيقياً لعملية التحقيق وكيف اشتغل عليها هو وأستاذه الأسطى.
تُوفي حسن الفقيه حسن سنة 1868 وبقيت يومياته ووثائقه ملكاً لعائلته تحتفظ بها جيلاً بعد جيل، ولم تخرج من البيتِ إلا عند تمكّن الإيطاليين من البلاد. يروي علي الفقيه حسن، أحد أحفادِ المؤلف، في تقديمه الكتابَ أوّلَ صدورِه أنّ الإيطاليين داهموا بيت العائلة سنة 1922، أثناء حملات التفتيش السياسي، وصادروا أوراق اليوميات ووثائق العائلة. ثم أعادوها بعد أيام و"قد نقص منها عدد كبير من الأوراق التاريخية". لكن ما جرى لليوميات لم يكن اسثتنائياً، إذ تعوّد الإيطاليون منذ نزولهم طرابلس في أكتوبر 1911 على حرق الموروث الثقافي وإتلافِه وسرقته.
ويشير المؤرخ عمر الزبيدي إلى المكتبات الخاصة في دراسته "إتلاف المكتبات الخاصة من أخطر الأضرار الثقافية [. . .]"، والتي نشِرت سنة 1992 في كتاب "أعمال المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات في ليبيا"، أنها أول ما شمله الحرق أو التمزيق. ويستعين الزبيدي في الدراسة باستبيانٍ للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على مئة ألف أسرةٍ ليبية سنة 1984. وجد الباحث أن حالات الضرر الثقافي بلغت 744 حالة مسجلة، نتيجة أضرارِ حربِ استرداد السيطرة على طرابلس وبرقة والتوسع في فزّان التي قادها الفاشيون الإيطاليون في العشرينيات. يقول الزبيدي: "اتضح أنّ كل تلك الحالات [الضرر الثقافي] كانت مكتبات خاصة. يمثّل الكتاب المخطوط بها 70 بالمئة تقريباً". أي ضياع مخطوطاتٍ نادرةٍ في التاريخ واللغة والحديث والفقه والأدب.
نجتْ اليوميات من الإتلاف والحرق، لكنها لم تنج من مصادرتها مرة أخرى. يحكي علي الفقيه في تقديمه كتابَ جدِّه أنّ الأمر تكرر مرةً أخرى سنة 1948 زمن الإدارة البريطانية، عندما اعتقلت السلطات الجدَ وأودعته السجن بسبب نشاطِه في سبيل استقلال ليبيا. يقول: "وفي ذلك اليوم صادرت السلطات البريطانية كثيراً من الوثائق التاريخية والسياسية من بيت علي الفقيه حسن [يقصد نفسه] ومن ضمن تلك الوثائق اليوميات هذه [. . .] وكانت نتيجة التفتيش ضياع قسم كبير من هذه اليوميات التاريخية". وكانت بريطانيا قد فرضت على برقة وطرابلس احتلالاً عسكرياً مؤقتاً بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. امتد هذا الاحتلال من سنة 1943 حتى استقلال ليبيا سنة 1951، تحت مسمى "المملكة الليبية المتحدة".
المرة الثالثة التي خرجت فيها اليوميات من بيتِ عائلة الفقيه حسين كانت عند نشر حلقاتٍ منها في صحيفة الميدان من 3 أغسطس 1969 إلى 31 أغسطس 1969، آخر أيام المملكة الليبية. في الفاتح من سبتمبر من ذلك العام نادى الملازم أوّل معمّر القذافي من إذاعة مدينة بنغازي بسقوطِ النظام الملكي تحت حكم الملك إدريس السنوسي وقيام الجمهورية الليبية، ليبدأ تاريخ جديدٍ لليوميات ومعها سياسات الدولة الليبية عن تاريخ البلاد، لاسيما تاريخ الاستعمار الإيطالي.
لكن أكثرَ الحقب التي استعادها القذّافي كانت فترة الاستعمار وحركة الجهاد الليبي في مواجهةِ الإيطاليين، وبهذا أصبحَ الاستقلال الليبي سنة 1951 استقلالاً مزيفاً عنده، ورأى أنّ البلد لم تستقل إلا سنة 1969. ألقى القذّافي بظلال الشك على الشرعية الوطنية للملك إدريس السنوسي الذي تولى حكم ليبيا رسمياً بعد الاستقلال، وعدّ ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 انعتاقاً حقيقياً من الاستعمار الغربي.
أدركَ القذافي مبكراً دورَ الذاكرة الجمعية وضرورة استغلالها في أن يستتب الأمن أثناء حكمه. ليسَ برسم صورة بديلة للماضي الليبي وحسب، بل بتعريف حاضرِه أيضاً. فقد حوّلَ حدثَ تعطيل الصحافة الحرة والتعددية السياسية ومحاولة إتلافِ مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وإلغاء جميع القوانين الوضعية إلى ثورةٍ تاريخيةٍ سمّاها الثورة الثقافية. وقد أعلن عن هذه الثورة فيما صار يعرف باسم "خطاب زوارة التاريخي" سنة 1973، وفيه دعا القذافي للتمرد على ما وصفه بأنه "الدولة التقليدية ذات النمط الرجعي".
ويظهر أيضاً أسلوب القذافي هذا في ردِّه على الثورة الطلابية في 7 إبريل 1976، عندما ثار طلاب الجامعات ضد الحكم العسكري وسياسات التجنيد. فأطلق القذافي ثورةً طلابيةً مضادة من أتباعه، كان من نتائجها شنق طلابٍ في ساحاتِ الجامعة. عرفت تلك الثورة في المناهج الدراسية بثورة "السابع من الطير"، وشهر الطير هو اسم أبريل في الأشهر الفلاحية الليبية، حين استعاد الطلاب الجامعةَ "من المخرّبين والرجعيين" بحسب مزاعم القذّافي واتباعه. لكن مرحلة الاستعمار وإعادة قراءتها وروايتها ظلّت الهمَّ الأكبر للقذافي في سنواتِ حكمِه الأولى.
يظهر هذا في استقطابِ القذّافي المعارضين المعروفين للنظام الملكي، مثل الشيخ الطاهر الزاوي، الذي عاد من منفاه في مصر ليصبح مفتي الديار الليبية. كان الزاوي من أهم مناهضي الملك إدريس السنوسي، ومع أنّه لم يكن مناصراً للقذّافي إلا أن الزعيم الليبي وجد فرصتَه في التقاء المواقف تجاه المملكة الليبية ومؤسسيها. فدعمت الدولة الليبية كتابات الزاوي التاريخية التي ينتقد فيها إدريس السنوسي وقادة الحركة السنوسية، ويمجد فيها دور عمر المختار قائد المقاومة السنوسية في العشرينيات. ومنعت الدولة الروايةَ التاريخية المغايرة لهذه النظرة الرسمية.
يظهر الاسم الأوّل للمركز الهدف الرئيس الذي أنشئ لأجله، أي دراسة الجهاد أولاً في عمومِ التاريخ الليبي. وعند تغيّر الاسم، قُصد به التركيز على الجهاد ضد الإيطاليين. ومع ذلك احتفظَ المركز بشخصيته المستقلة عن اللجنة الشعبية العامة وعن القذّافي، ولم يكن أداة أكاديمية في يدِ السلطة تستخدمها كما تشاء.
يؤكد علي الهازل، الناطق الإعلامي للمركز وأحد أقدم العاملين فيه، استقلال المركز عن النظام الليبي وقتَها. قال الهازل للفِراتس إنّ القذافي زار المركز سنة 1989 واجتمعَ بالعاملين الذين قالوا له إنّ الإذاعة الليبية تزوّر التاريخ الاستعماري بقولِها "إنّ القوات الإيطالية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها غزو ليبيا، لكن الواقع أنّ إيطاليا احتلت ليبيا". فأجابهم القذافي: "أنا قائد ثورة أريدها منتصرة من معركة بدر. أما أنتم في الأبحات والندوات وكل الأعمال العلمية، لابد لكم من استخدام المصادر سواء كانت وثائق أو رواية شفوية. ولا يحق لأي أحد الإعتراض إلا في حالة وجود معلومات غير دقيقة".
ويؤكد الهازل موقف القذافي هذا في قصةٍ مع عمر اشكال، ابن عم القذافي وأحد رموز النظام، إذ جاء للمركز وأمرهم بإصدار كتاب عنوانه "الكتاب الأسود" يضم أسماء المتعاونين مع الاستعمار الإيطالي الذين كان المركز يملك وثائقَ لهم. يقول الهازل: "لم يكن الأمر بتلك السهولة [. . .] تواصلنا مع قلم القذافي [مكتب القذافي] وأبلغناه بما حدث، فكان رد القذّافي أن افعلوا ما ترونه مناسباً". ولم يصدر الكتاب.
عملَ المركز في فضاءٍ تفاوضيٍ مع السلطة يركّز فيها على دراسات الاستعمار الإيطالي وتجميع الوثائق التاريخية والروايات الشفوية التي تسجّل تلك الحقبة. هذا مع استقلالية المركز في العملِ الأكاديمي على التاريخ الليبي والعربي والإسلامي عامةً بعيداً عن السلطة وغاياتها. هنا بدأ العمل على اليوميات الليبية. وكانت تلك بداية رحلة وثائق حسن الفقيه حسن مع المؤرخ عمّار جحيدر والمركز. إذ يستذكر جحيدر تلك الأيام بقولِه إنّ إدارة المركز انتبهتْ "مبكراً إلى أهمية اليوميات الليبية التي ظهرت بعض أخبارها في الوسط الثقافي وبعض الصحف حينذاك. وقد بادر المركز إلى شراء مخطوطة اليوميات الأصلية الفريدة من الأستاذ علي الفقيه حسن، حفيد المؤرخ، رحمه الله تعالى".
جحيدر كان باحثاً في شعبةِ الوثائق والمخطوطات الناشئة في المركز حينذاك، فرافق أستاذَه المؤرخ محمد الأسطى ومدير المركز محمد الجراري إلى بيتِ علي الفقيه حسن في فبراير 1978 لشراءِ المخطوطة. واشترط علي الفقيه حسن أن يكون الأسطى محققَ الكتاب بسببِ خبرتِه بالتاريخ الليبي في القرن التاسع عشر وإتقانه اللغة التركية، وتحقيقه بعضَ صفحاتها قبل ذلك مع الكاتب علي مصطفى المصراتي.
كان كتاب "حملة نابولي على طرابلس 1828"، وهو جزء من اليوميات يركز على الحرب البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا، أول مطبوعات المركز سنة 1978. يتحدث جحيدر عن تلك التجربة في كتابِه "معجم اليوميات الليبية" بقولِه إنّ الكتابَ نشِرَ في مناسبة افتتاح المركز في نوفمبر 1978 واستُعجِلَ العمل عليه فخرج مليئاً بالأخطاء المطبعية التي "شوّهت النص". هذه التجربة دفعتْ المحققان للتريّث في العملِ على اليوميات وتحقيقها، وهذا ما يدلل عليه تباعد فترات نشر أجزاء الكتاب فقد خرج الجزء الأول منه سنة 1984. ثم أعيد طبع الجزء الأول مع الطبعة الأولى من الجزء الثاني سنة 2001. ولم تصدر بقية الأجزاء إلا بدءاً من 2023.
هذا التباعد التاريخي بين فترات النشر سببه أيضاً تفرق الوثائق والمذكرات نفسها وحاجتها إلى عمل تحقيقي مضنٍ لجمعها في تواريخ متتالية وفي مواضيع تجمع كتابها. فقد كان حسن الفقيه يحتفظ بمذكرات متفرقة لليوميات وعمله في التجارة. بالإضافة إلى فقدانِ جزءٍ مهمٍ من اليوميات. وبهذا كان إخراج اليوميات الليبية بعيداً عن الصورة الأكاديمية، التي قد تحدّ من انتشاره، تحدِّياً كبيراً للمركز والعاملين على الكتاب. ونجحَ المحققان في ذلك، فالكتاب حتى اليوم أشهر انتاجات المركز التي تفوق الألف كتاب. وربما هو الكتاب الوحيد من منشوراته الذي لم يغب عن مكتبات القراء والمثقفين الخاصة، حتى أصبحَ رمزاً من رموزِ كتابة التاريخ الليبي. لكن على ذلك، سرعان ما أصبح المركز خزينةً حقيقيةً للذاكرة الليبية.
يذكر المركز في موقعه أنّ جان فانسينا، الأستاذ بجامعة ويسكنسون الأمريكية، حضر بدايات 1978 لتدريب مجموعة من شباب المركز على كيفية جمع الروايات التاريخية المدوّنة والملفوظة. وبعد الدورة التدريبية وُزِّع الباحثون على مناطق ليبيا، فسجلوا حتى أغسطس 1978 أكثر من ألفِ مقابلةٍ مع من سموا "قدامى المجاهدين" الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي، لينتجوا أكثر من ستمئة شريط تسجيلي فيه مقابلات مع هؤلاء يروون ذكرياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية فترة الاستعمار.
وهكذا ظلّ المشروع يكبر مع مراحل مختلفة لا تقتصر فقط على جمعِ روايات الجهاد. بل روايات المنفيين الليبيين إلى الأراضي الإيطالية، وروايات المهاجرين فترة الاستعمار والمتعاونين مع الإيطاليين، وأخرى للعائلات المتضررة من المرحلة. ليُجمع كل ذلك في "موسوعة روايات الجهاد"، وهي التي صدرَ منها خمسون مجلداً منذ بداية المشروع، فيها تفريغ المقابلات مع ليبيين عايشوا المرحلة الاستعمارية.
ويرى علي عبد اللطيف حميده، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، في مقالتِه "مركز دراسات جهاد الليبيين [. . .]"، المنشورة سنة 2017، أنّ مشروع التسجيل هذا من أهم مشاريع المركز. ويضيف إنّ "هذه العلمية الرائدة [مشروع الرواية الشفوية] أنجزت أهم تجميع للتاريخ الشفاهي، وهذا ما قاله لي البروفسور فانسينا، في العالم وليس فقط في إفريقيا والعالم العربي".
تفوق المركز في تلك الفترة في البحث عن الوثائق الليبية ونشرها. فنشَر موسوعة "الوثائق الإيطالية"، ضمن سلسلة الوثائق التاريخية، التي ترجمها عاملون ومتعاونون معه عن الإيطالية منذ 1989 إلى 2001، حتى قارب عددها ثلاثين كتاباً. وشملت وثائقَ لمعارك ضد الاستعمار وملف المنفيين، والخطط الاستعمارية. وصل عدد الوثائق الأصيلة عن ليبيا المحفوظة في خزائن المركز إلى ما يقارب خمسة وعشرين مليون مادة وثائقية مصوّرة، منها وثائق ألمانية وأمريكية وفرنسية وتركية.
هذه التغييرات في الاسم والتبعية كشفت أزمة المركز واختصاصاته ودوره في الدولة. وكشفت أيضاً تحولات سياسة النظام نفسه من التركيز على الجهاد ضد الإيطاليين إلى العمل البحثي والأكاديمي على الذاكرة الليبية عامة. وكان هذا التحول بعد اعتذار إيطاليا إلى ليبيا سنة 2008 على مرحلة الاستعمار، ومن ثمّ اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية سنة 2009.
مرّ المركز بأولى مشاكله القانونية سنة 2007 في ملكية مقرِّه مع الهيئة العامة للأوقاف. إذ انتهت وزارة الإسكان من بناء المبنى سنة 1984 بالقرب من مقبرة "سيدي منيذر" وسط طرابلس، وهو المقرّ الذي عُرف به المركز حتى اليوم، وتدّعي الأوقاف ملكيته.
يتحدث محمد الجراري في مدوّنتِه الشخصية في سنة 2015 عن أنّ الأوقاف سعت "لابتزاز شهرة المركز ومكانته وطالبت بمبالغ إيجار ضخمة جداً تفوق إمكانيات المركز وما يخصَّص له من الميزانية العامة مما سيؤثر سلباً على منشوراته ومشاريعه العلمية". يحكي الجراري أيضاً أنّ المركز رفضَ ودخل في معركة قانونية استمرت "لأكثر من ثلاث سنوات أثبت فيها المركز عدم أحقية الأوقاف في المبنى [. . .] التي لا علاقة لها بمقبرة منيدر المخصصة للأوقاف". خيِّرَ المركز رئيسَ الأوقاف وقتها بين القناعة بقيمة التعويض المقررة أو إحضار ما يؤكد أحقيتهم في الأرض، "التي استطاع المركز بشهادات تاريخية وشفوية من تأكيد أحقيته فيها".
انتصر المركز في معركته وبدأ عهدٌ جديدٌ في ليبيا وفي مسيرة المركز نفسه الذي أصبحَ أكثر طموحاً، لاسيما مع توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا سنة 2010 تتيح الولوج إلى الأرشيف الاستعماري واستعادة الوثائق. لكن ذلك لم يدم، فقد انطلقت في منتصف فبراير سنة 2011 انتفاضة شعبية في المدن الليبية تنادي بسقوطِ النظام، لتتحول بسرعة إلى صراعٍ مسلّحٍ انتهى بمقتلِ القذّافي في أكتوبر 2011.
كذلك تحوّل اسم المركز مرةً أخرى سنة 2012 إلى "المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية"، وخرجَ القانون رقم 24 الذي عده الجراري في تصريحٍ لقناةِ الجزيرة في مايو 2012 حمايةً للمركز لأن القانون يعترف به رسمياً "أرشيفاً وطنياً" تجب حمايته. ويطبق عقوبات قاسية على الجرائم التي تحدّ من عمل المركز وتتعارض معه. لكن كان على المركز أن يخسر إحدى أهم إنجازاته، فقد قال الهازل للفِراتْس إنّ المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الانتقالية التي تشكلت سنة 2011، ألغى الاتفاقية الإيطالية في نفس عامِ القانون.
دخلت ليبيا منذ نهايات 2013 في مرحلة متوتّرة مهدّت إلى صراعات مسلحة سنة 2014. فأصاب المركز ما أصاب جل مؤسسات الدولة الليبية. فأغلب الميزانية المرصودة من تلك الفترة هي ميزانية تيسيرية للمهام اليومية ومعاشات الموظفين.
يقول الهازل شارحاً: "من أهم تلك المشاكل عدم صرف ما يسمى ميزانية التنمية، ما عدا بعض المرتبات وبعض النثريات تصرف في شراء الورق والبنزين وما شابه ذلك". ويستمر في حديثِه قائلاً إنّ مبنى المركز، الذي يحتاج صيانةً دوريةً لاسيما في خزائن الوثائق، لا يلقى هذه الصيانة.
يضيف الهازل البعدَ الأمني إلى قائمةِ تحديات المركز فيقول: "هناك اثنان وعشرون مشروعاً علمياً كلها متوقفة بسبب فقدان الأمن، فقد اتفقنا مع شركة ألمانية لجلب معدات لتطوير الأرشيف. وصلت المعدات إلى المركز، ولكن الشركة رفضت إرسال الخبراء بحجة الفراغ الأمني في البلد".
وتستمر قائمة تحديات المركز التي يسردها الهازل لتمتد إلى ضعفِ أجورِ الباحثين وعدم تعيين موظفين جدد: "إدارة الأرشيف تحتاج إلى مئة وخمسين باحثاً من خريجي التاريخ والمكتبات واللغات الأجنبية كالإنجليزية والإيطالية، والعدد الموجود اليوم في تلك الإدارة لا يزيد عن العشرين".
وفي ظلِّ أجواء عدم الاستقرار السياسي والأمني وزيادةً للطين بلة اشتعلَ الخلاف القانوني بين المركز والأوقاف مجدداً سنة 2016، عندما أصدرت الأوقاف حجزاً إدارياً على المركز أوقف مرتبات الموظفين أشهراً. وفي حوارٍ لمدير المركز محمد الجراري مع موقع "ليبيا المستقبل" في مارس 2017، قال إنّ هذا القرار أوقف عجلة العمل بالمركز ما "يعني تهديد لملايين الوثائق الموثِّقَة للتاريخ الليبي. علاوة على جمع الإضافي منها لزيادة مخزون الأرشيف. إضافة إلى التجويع المجحف للعاملين وأسرهم".
وتكرر الأمر سنة 2021 عندما طالبت الأوقاف إخلاءَ المقرّ في مهلةِ ثلاثةِ أيام. وأصرّ المركز على أنّ المبنى لا يتبع الأوقاف بل يتبع بلدية طرابلس، كما صرّح الجراري لموقع "أخبار ليبيا 24" في 7 يناير 2021. يستذكر الهازل تلك الأيام بقولِه: "لم تحترم الهيئة [الأوقاف] مكانة هذا المركز الذي وجد نفسه أمام مصير مجهول قد يعصف بالذاكرة الليبية".
لم يقف المركز وحده في معركته القانونية تلك. إذ سرعان ما انتشرَ خبر النزاع على مواقع التواصل الاجتماعي وهبّ ليبيون كثيرون لدعمِه وحثّ رئاسة الوزراء على إنقاذ المركز ووثائقه.
فمثلاً كتبَ الصحفي جلال عثمان مقالة في "بوابة الوسط" بعنوان "لماذا تصر هيئة الأوقاف على إزعاج التاريخ؟" في يناير 2021، يتهم فيها الأوقاف بالضغط بالسلاح وإرهاب موظفي المركز. يقول عثمان: "تحولت هيئة الأوقاف إلى استخدام أسلحة جديدة، تمثلت في سلاح المحاصرة والاعتصامات". أشار عثمان كذلك إلى أول حصار للمركز في ديسمبر من طرف جماعات محسوبة على هيئة الأوقاف. تطور الحصار ليصبح اقتحاماً بملابس عسكرية من جماعة مسلحة وأخرى مدنية، تمكنت لاحقاً من الدخول إلى مكتب محمد الطاهر الجراري، مدير المركز. طالبوه إما بإخلاء المبنى في الحال، أو الموافقة على توقيع رسالة إقرار تفيد بملكيته لهيئة الأوقاف، "وهو الحل الذي وجده الدكتور الجراري كفيلاً بحماية المركز من الضياع".
دق خطر الضياع ناقوسه على المركز من جديد في يناير 2025. ففي خبر نشرته وكالة الأنباء الليبية في نفس الشهر، حذّر المركز من خطر انهيار المبنى وتلف المحفوظات "بسبب تسرب المياه من الأسقف والحيطان". وذكرت وكالة الأنباء أنّ المركز حذّر "من تأثير زيادة الرطوبة على الوثائق والمخطوطات ومكتبات الكتب والروايات التي تشكل خزائن تاريخ ليبيا، مما قد يؤدي إلى تدميرها بالكامل".
في هذا المناخ المضطّرب وجدَ جحيدر نفسه يكمل العمل على اليوميات دون توقف. وعند تقديمه الجزء الثالث من الكتاب لنشرِه، اعتذرت إدارة المركز لعدم وجود ميزانية له. وبمساعدةِ الشاعرِ الليبي المكي أحمد المستجير، بدأ بنشرِ ما تبقى من أجزاءِ الكتاب حتى الجزء السادس على موقِعه الإلكتروني منذ 2023 وحتى 2024 في نسخٍ محققة وجاهزةٍ للطبع. ومع وجود دورِ نشرٍ ليبية يمكنها نشر الكتاب، إلا أنّ ملكية المركز الكتابَ تمنع ذلك.
حارب الفاشيون الذاكرةَ الليبية لأنّهم لم ينظروا إليها ذاكرةَ المكان، بل ذاكرة أقوامٍ احتلوا الأرض الرومانية التي استعادتها إيطاليا. وقد أعاد معمر القذافي تلك الذاكرة على السطح وحاول مأسستها والسيطرة عليها أحياناً، أو توجيهها في اتجاهٍ معيّنٍ في أحيانٍ أخرى. واليوم تبدو الذاكرة الليبية في الدركِ الأسفلِ من سلم اهتمامات الحكومات الليبية المتلاحقة. بل يمكن لتلك الذاكرة أن تختفي بالعجزِ عن نشرِها، أو تحت تهديد السلاح أو حتى بقطرةِ ماءٍ تتلف الوثائق.