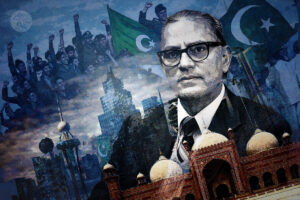حين وصلتُ طهران أول مرةٍ سنة 2024، كنت أحمل في ذهني صورةً تقليديةً عنها، شعراء ونُسّاك ومساجد وزعفران وأسواقٌ عامرةٌ بالبضائع والحكايات. لم أتخيّل أنّ ما سيربطني بهذه البلاد ليس معلَماً معمارياً أو لحظةً سياسيةً، بل كوب شايٍ ومقهىً في جنبات سوق طهران، لا يزال يحمل مذاقُ أكواب الشاي فيه تراكماً خاصاً لن تجده إلا في إيران. ووسط المقاهي الحديثة التي يحتسي فيها الشباب "إسبرسو" و"كابتشينو"، يقف مقهى علي درويش، علامةً على علاقة الإيرانيين الوطيدة بالشاي الذي بات عنصراً من تاريخهم الثقافي والاجتماعي.
لم يكن في نيّتي أن أعيد تعريف علاقتي بكوب الشاي، وأن أتعرّف إلى تاريخ الشاي في إيران. ولم أكن أبحث كذلك عن رمزيةٍ ضائعةٍ في طقسٍ يوميّ. لكن إيران، هذا البلد العالق بين تاريخه المثقل وواقعه المتوتّر، أخذني من يدي إلى ما يشبه الاعتراف. لم يحدث ذلك في متحفٍ ولا في ندوةٍ فكريةٍ، بل في مطبخٍ صغيرٍ ومجلسٍ نسائيٍّ وعند بابِ متجرٍ قديمٍ في سوق طهران الكبير. وفي كلّ مرةٍ كان هناك كوب شايٍ في المنتصف، كأنه وسيطٌ صامتٌ بيني وبين ما لا يُقال.
هناك في بيتٍ دافئٍ جنوبيّ طهران، ناولتني امرأةٌ خمسينيةٌ كوباً زجاجياً رقيقاً، وقالت "نوش جان". عبارةٌ لا تُترجَم بقدرِ ما تُحَسّ. ففي اللغة الفارسية القديمة، "نوش" تعني الخلود أو البقاء، و"جان" تعني الروح أو النفس. وهي عبارة يردّدها الإيرانيون عند تقديم مشروبٍ أو مطعومٍ، وتُشبه في معناها ما نقوله بالعربية: بالهناء والشفاء. كانت تلك الكلمات الأولى التي تسلّلت إلى قلبي بعمقٍ لم أعهده من قبل. في تلك اللحظة، أدركتُ أنّني أرتشف طبقاتٍ من التاريخ والطقوس. وشعرتُ أنني أتعرف إلى الإيقاع الداخلي لهذا المجتمع الذي لا يفصح عن نفسه بالسياسة ولا بالشعارات، بل بما يُدار بصمتٍ على صينيةٍ من النحاس: بالذوق والرائحة وطريقة التقديم. فالشاي في إيران ليس عنصراً ثانوياً في مسرح الحياة اليومية، هو خشبة المسرح نفسها. هو ما يجمع العائلة بعد تعب النهار، وما يقدَّم في مناسبات الفرح والحزن، وما يرافق الشعر والسياسة وحتى الصمت. هو شكلٌ من أشكال الإصغاء. وأحياناً، شكلٌ من أشكال المقاومة الهادئة: أن تستمرّ في الطقس، رغم كلّ ما تغيَّر.
مع ما قد يتبادر إلى الذهن إلّا أنّ الشاي لم يكن جزءاً أصيلاً من التقاليد الإيرانية، وفق ما يظهره المؤرخ السويسري جورج فان درييم في دراسته الموسّعة "ذا تَيل أوف تي" (قصة الشاي) المنشورة سنة 2019. فعلى مدى قرونٍ وقبل أن تحتلّ أوراق الشاي اليابسة مكانها في بيوت الإيرانيين وقلوبهم، كانت القهوة الآتية من اليمن وبلاد العثمانيين، سيّدة المجالس في البلاط الصفوي في عهد الدولة الصفوية التي حكمت بين 1501 و 1736. وكانت رفيقةَ المثقَّفين في المقاهي الأدبية القاجارية (نسبةً إلى العائلة القاجارية الملكية والدولة الحاكمة في إيران بين 1789 و 1925). لكنها ظلّت في الغالب حكراً على الطبقات العليا، فيما كان عامة الناس يكتفون بشرابٍ بسيطٍ من الماء المحلّى بالسكر يسمى "شَرْبَت". وشربت مشروبٌ لا يزال حاضراً في الثقافة الإيرانية إلى اليوم، ويكشف عن ميلٍ شعبيٍّ واضحٍ للطعم الحلو.
ربما ساهمت عوامل عدّةٌ في تحوّل الذوق الإيراني من القهوة إلى الشاي. فتكلفة الشاي أقلّ وتحضيره أسهل، ويمكن تحليته بسهولة. كذلك فإن نقل القاجاريين عاصمتهم إلى طهران – الأقرب جغرافياً إلى روسيا – أتاح تواصلاً ثقافياً وتجارياً جديداً. جلب هذا التواصل معه وعاء "السماور" الروسي إلى البلاط القاجاري. والسماور وعاءٌ معدنيٌّ طويلُ العنق يسخَّن فيه الماء بهدوءٍ مستمرّ، استطاع أن يشقّ طريقه تدريجياً إلى بيوت الناس بعد البلاط القاجاري. لم ينتشر مشروب الشاي في إيران انتشاراً واسعاً إلّا في أواخر القرن التاسع عشر، لكنّه سرعان ما اعتلى عرش الضيافة وتحوّل إلى رمزٍ يوميٍّ للدفء والكرم والانتماء.
وبحسب دراسةِ فان درييم، كان دخول الشاي إلى إيران خطوةً مهمةً – وليس تحوّلاً ذوقياً عابراً – أعادت تشكيل الثقافة اليومية والاقتصاد الزراعي في البلاد. جاءت نقطة التحوّل الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر حين أوفد إلى الهند ضمن بعثةٍ رسميةٍ محمد ميرزا قاجار قوانلو، المعروف بكاشف السلطنة، وهو دبلوماسيٌ إيراني ينحدر من طبقة النخبة المتعلّمة. فأظهر هناك اهتماماً بصناعة الشاي البريطانية في الهند، وانبهر بعادات شرب الشاي وتقاليده الاجتماعية.
لم يكتفِ كاشف السلطنة بالإعجاب، بل عاد إلى إيران وفي ذهنه مشروعٌ طموحٌ لتوطين زراعته في شمال البلاد. فقد أراد فكّ الارتباط بالاستيراد الذي كان يثقل كاهل الاقتصاد الإيراني، ويُخضع البلاد لحاجتها إلى الأسواق الهندية (البريطانية) والصينية.
في شهر يوليو من سنة 1900، عاد كاشف السلطنة إلى إيران ومعه ثلاثة آلاف شتلة شايٍ آساميّة (نسبةً إلى منطقة آسام بالهند)، واختار منطقة لاهيجان الواقعة في محافظة غيلان على بحر قزوين لبدء التجربة. ووفقاً لسجلات وزارة الزراعة الإيرانية، فقد ثبت أنّ التربة الحمضية والمناخ الرطب في لاهيجان يوفّران شروطاً جيدةً لزراعة الشاي، شبيهةً بظروف الأقاليم الصينية والهندية التي تزرع فيها هذه النبتة.
في خريف سنة 1842، أَوكَلت شركة الهند الشرقية (ذراع الإمبراطورية البريطانية لإدارة موارد مستعمراتها) لمغامرٍ وخبير نباتات يدعى روبرت فورتشن مهمة سرقة أسرار الشاي من الصين، التي كانت تهيمن حينئذٍ على إنتاج المشروب الأكثر طلباً في الإمبراطورية البريطانية.
ينقل كتاب "قصة الشاي" أن فورتشن وصل متسللاً إلى الصين في ربيع 1843، بعد أن حلَق رأسه وتنكر بزيّ تاجرٍ صينيٍّ من إحدى الأقليات العرقية. وكان يجيد التصرف ويتحدّث اللغة بما يكفي ليخدع من حوله. أراد فورتشن أن يحصل على إجاباتٍ عن أسئلةٍ طالما أرَّقت البريطانيين، على رأسها هل يخرج الشاي الأسود والشاي الأخضر من نبتتَيْن مختلفتَيْن، أم يصدُقِ الصينيون في زعمهم أنهما من نبتةٍ واحدة. وإن كانا من نبتةٍ واحدةٍ، فما الأسرار التي يخفيها أهل الصين عن كيفية استخراج أنواعٍ عدّةٍ من الشاي من النبات نفسه.
في رحلته للبحث عن الإجابات لم يكتفِ فورتشن بجمع البذور، لكنه سعى أيضاً إلى سرقة المعرفة بزراعة الشاي ومعالجته. فاستقطب عمَّالاً مهرةً ونقلَ معدّات المعالجة، وسجَّل ملاحظاتٍ دقيقةً عن التربة والطقس وتقنيات التخمير والتجفيف. وبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، نجحت مهمّته نجاحاً باهراً. فنُقلت أسرار الشاي من مقاطعة فوجيان الصينية إلى سفوح دارجيلنغ وآسام في شمال الهند.
وبعد سنواتٍ قليلةٍ بدأت الهند إنتاج كمياتٍ ضخمةً من الشاي وتحوّلت من مستورِدٍ إلى مُصدِّرٍ، متجاوزةً الصين نفسها في حياة فورتشن. بهذه السرقة العلمية المنظّمة، كسرت بريطانيا احتكارَ الصينِ أسواقَ الشاي، وكلّ ذلك لحساب "شركة الهند الشرقية" البريطانية التي أغرقت الصين بالأفيون عبر السوق السوداء، ما أدّى لاحقاً إلى اندلاع حرب الأفيون الثانية. حسبما توثّق الكاتبة سارة روز في كتابها "فور أول ذا تي إن تشاينا" (من أجل كلّ الشاي في الصين)، الصادر سنة 2010.
والمفارقة أنّ ما فعله فورتشن بالصينيين تكرّر لاحقاً، ولكن هذه المرّة في الاتجاه المعاكس. ففي الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند بين سنتَيْ 1858 و 1947، كانت أسرار صناعة الشاي محصورةً بدوائرَ ضيقةٍ مخصصة للأوروبيين فقط. فقد مُنع الهنود وغير الأوروبيين من الوصول إليها. لكن كاشف السلطنة، الدبلوماسي الإيراني الطموح، لم يستسلم لهذا الإقصاء. وتظاهر بأنّه طالبٌ فرنسيٌّ يدرس علم النبات، ونجح بهذه الحيلة في الدخول إلى عالم صناعة الشاي. جمعَ الملاحظات والمعلومات وراقب عن كثبٍ وتمكّن من كشف أسرار المعالجة والإنتاج، تماماً كما فعل فورتشن في الصين، بحسب ما تذكر سارة روز. فتعرّض الاستعمار البريطاني لنوعٍ من "الردّ بالمثل".
بحلول بدايات القرن العشرين، وتحديداً مع صعود الدولة البهلوية الأولى بقيادة رضا شاه بهلوي، أصبح مشروع الشاي في إيران أداةً استراتيجيةً لتعزيز السيادة الاقتصادية. دعمت الدولة جهود كاشف السلطنة، وبدأت تُصدِر قراراتٍ تحفيزيةً لتشجيع المزارعين على استبدال المحاصيل التقليدية بالشاي. في الوقت عينه أنشأت أوّل مصنعٍ لإنتاج الشاي في إيران بمدينة لاهيجان سنة 1934. وفي عقدَين فقط، تحوّلت السفوح الخضراء لجبال غيلان ومازندران في شمال إيران إلى مَزارع شايٍ مترامية الأطراف. وصار الشاي في إيران سلعةً محليّةً ذات طابعٍ وطنيٍّ، بعدما كان منتجاً مستورداً يستهلَك على استحياء، وفق ما يرد في "الموسوعة الإيرانية" العلمية المنشورة سنة 2000.
تراجعت زراعة الشاي في إيران تراجعاً حادّاً منذ تسعينيات القرن العشرين، نتيجة السياسات الاقتصادية التي تبنّتها حكومة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بين سنتَيْ 1989 و 1997، بما في ذلك تحرير السوق وفتح الأبواب أمام واردات الشاي الأقل ثمناً من الخارج. ومع ذلك أطلقت الحكومة الإيرانية في 2004 حملةً وطنيةً لإحياء هذا القطاع. تسارعت هذه الجهود في أعقاب العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران، التي فرضت ضغوطاً متزايدةً على الواردات ودفعت باتجاه تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
اتخذت الحكومة في 2021 خطواتٍ لدعم مزارعي الشاي في إيران. فرفعت أسعار شراء أوراق الشاي الخضراء، وهي الأوراق الطازجة التي تقطف من المزارع وتباع مباشرةً إلى مصانع المعالجة، بهدف تحسين دخل المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للشاي الإيراني في السوق المحلي.
إن رحلة الشاي من وافدٍ غريبٍ إلى جزءٍ أساسٍ من الهوية الإيرانية، قصةٌ عن التكيّف الثقافي والاقتصاد السياسي والسيادة الغذائية. قد لا يدرك كثيرون، وهم يحتسون كوباً من شاي لاهيجان في أحد شوارع طهران، أنهم يشربون تاريخاً حافلاً بالتجريب والمقاومة والتجذّر.
المقهى لا تزيد مساحته عن مترٍ ونصف المتر، بلا طاولاتٍ ولا مقاعد ولا ضجيج. فقط جدرانٌ ضيقةٌ تتنفّس التاريخ، ورفوفٌ خشبيةٌ تحمل أكواباً زجاجيةً، وسماورٌ نحاسيٌ ينبض كقلبٍ قديمٍ لا يتوقف. وجدتُ هناك الحاج كاظم مهبوتيان، سبعينيٌّ بوجهٍ مشرقٍ وتجاعيد حفرتها عقودٌ من احتساء الشاي والكلمات. كان يُعِدّ إبريقاً من شاي الزعفران بالليمون والنعناع، وصفتُه الخاصة التي سمّاها "چای مهربانی"، أي شاي اللطف أو شاي الطيبة.
سألته عن الاسم، فابتسم كما يفعل من يحتفظ بسرٍّ صغيرٍ، وقال: "الشاي يجب أن يُشرب بقلبٍ طيّبٍ […] هذا شايٌ من أجل القلوب". ثمّ أخبرني أنّه ورث المقهى عن والده، الحاج علي مهبوتيان المكنّى بالحاج علي درويش، والذي اشتراه سنة 1918 من مؤسِّسه الحاج حسن. المكان انتقل من يدٍ إلى يدٍ، لكنّ النيّة بقيت واحدةً: أن يكون مأوىً صغيراً للمحبة في زحام المدينة.
أهداني الحاج كاظم ميداليةً نحاسيةً ثقيلةً، كتِب على أحد وجهيها "مرحباً في إيران" باللغة الإنجليزية، وعلى الوجه الآخر نقشٌ بِاسم المقهى. شعرتُ في لحظةٍ عابرةٍ أنني تلقيت أكثر من تذكار. دعوةٌ غير معلنةٍ للدخول إلى عمق إيران، لا إيران العناوين، بل إيران القلوب المفتوحة. قلت له إنّ أصول جدتي ترجع لمدينة همدان غرب إيران. فاتّسعتْ عيناه، وقال لي إنّ أباه الحاج علي أيضاً من همدان. فابتسمت، وقال لي: "ربما نحن أقارب".
قبل أن أغادر طلب أن يلتقط لي صورةً أمام المقهى. ابتسمت مجدداً، كما لو أنّني أشارك في طقسٍ محفوظٍ بعناية. طقسٌ يمارَس في حضرة شيءٍ أقدم من الصورة وأعمق من الذاكرة. التقطَ الصورة بهدوءٍ، ثم نشرها على صفحة المقهى في تطبيق إنستغرام موثّقاً لحظةً عابرةً كأنها امتدادٌ عضويٌّ لذاكرة المكان.
ما أثار استغرابي لم يكن الحضور الرقميّ للمقهى، بل دقّة الحاج كاظم في تثبيت التفاصيل والإمساك بما يفلت عادةً من عين العابر. كأنّ بقاء "قهوه خانه حاج علي درويش"، بكلّ ما فيها من رفوفٍ خشبيةٍ وروائح شايٍ قديمٍ، معلّقٌ على قدرتها هي وحدها على ترويض التبديد. المقهى لم يكن مكاناً فحسب، بل نسيجاً كثيفاً من المعاني، وكلّ زاويةٍ فيه تنضح بشيءٍ يشبه الحنين. لكنّه ليس حنيناً إلى الماضي، حنينٌ إلى زمنٍ لم نعشه، ومع ذلك نعرفه كما تُعرف الذاكرة التي وُرثت ولم تُعَش.
وعندما تغيّر المشروب، لم تتغيّر الوظيفة الرمزية. فالشاي مع حضوره المادي، لم يتمكّن من استبدال البنية الرمزية التي أسّسها حضور القهوة في الوعي الجماعي. ففي بلدٍ خضع لتقلّباتٍ اقتصاديةٍ واستعماريةٍ واحتلالٍ ناعمٍ عبر التجارة، حافظ الإيرانيون على مصطلح "قهوه خانه" تعبيراً عن الاستمرارية الثقافية، وعن وفاءٍ لصيغةٍ اجتماعيةٍ لم تكن القهوة إلّا مدخلاً لها.
إن كنتَ زائراً إيران، فستعرف من الوهلة الأولى أنّك لن تدخل بيتاً دون أن يقدّم لك الشاي. ليس ذلك مجرد تعبيرٍ عن كرم الضيافة، بل هو طقسٌ اجتماعيٌّ راسخٌ لا يكتمل اللقاء من غيره. فالشاي أوّل ما يحضَّر في البيوت، قبل أن يسأل الضيف عن اسمه أو سبب زيارته. يقدَّم على صينيةٍ غالباً من النحاس أو الفضّة، فيما يُرى على الكؤوس الزجاجية ذات الخصور اللون القرمزي القاني يتوهّج كحجرٍ كريم. وإلى جانبها وِعاءٌ صغيرٌ من مكعبات السّكر، أو أحياناً حبّاتٍ من التمر أو التوت المجفف، حسب تقاليد كلّ منطقة.
البيوت والمحالّ التقليدية تُعدّ الشاي على سماور وتضع الأباريق فوقه لتبقى ساخنة. تستخدم غالباً شاياً أسود من لاهيجان، وهو شايٌ قويٌّ لكّنه ناعمٌ في مذاقه، يُخمَّر فترةً طويلةً حتى يأخذ لونَه الداكن ونكهته المركّزة. وفي بعض الأحيان يفضّل البعض الشاي المستورد لسرعة غليانه. قليلٌ من العائلات تضيف الهيل أو الزعفران أو أعواد القرفة، وكأنها تقول إن الشاي ليس مجرّد وصفةٍ، بل هو بيانُ ذوق.
ما يدهش في هذه الطقوس ليس شكلها فقط، بل الزمن الذي يستثمر فيها. لا أحد في إيران يُعدّ الشاي بسرعة. لا ماء مغليّ يُصَبّ على أوراق الشاي مباشرةً، ولا كيس شايٍ يرمى في كوبٍ على عجل. هناك دائماً تلك الدقائق الهادئة التي ننتظر فيها الشاي "ليأخذ حقّه". نبني حوله المحادثات ونهدّئ به التوتر، ونفتَح به باب الكلام حتى في أصعب اللحظات.
الشاي في إيران زمنٌ خاصٌّ داخل الزمن. هو فعل انتباهٍ واستراحة تأمّلٍ، شكلٌ من أشكال الوجود المادي والروحي معاً. ولذلك لا عجب أن يحضر الشاي في أمثال الإيرانيين الشعبية وفي شِعرهم. لخّص الشاعر الإيراني أحمد رضا أحمدي، في قصيدته "چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود" (الشاي يبرد على الطاولة في مساء الجمعة) التي نشرت في أبريل 2007، هذا المعنى ببساطةٍ عذبة. فقال: "الشاي يبرد على الطاولة في مساء الجمعة، وأنا أفكر فيك. فيك، أنت البعيد. وفي هذا الشاي الذي لم يعد دافئاً، وفي هذه الجمعة التي تمرّ من دونك، وفي هذا الإحساس بالوحدة الذي يغلي في داخلي".
لكلِّ بيتٍ إيرانيٍّ شايُه، ولكل منطقةٍ نكهتها، ولكلٍّ شخصٍ طريقته في التحضير. كأنّ الشاي في إيران منظومةٌ من الرموز والاختلافات الخفيّة، وليس مشروباً موحّداً.
في شمال البلاد مثلاً، على ضفاف بحر قزوين حيث تكثر مزارع الشاي في لاهيجان ورشت، يفتخر أهل غيلان ومازندران بشايهم المحلّي. يفضّلونه ثقيلاً ومُركّزاً بلونٍ داكنٍ يشبه لون العنبر المحروق. يضعونه على السماور فترةً طويلةً، ويشربونه غالباً مع قطعةٍ صغيرةٍ من السكر تمسَك بين الأسنان ولا تُذوَّب في الكأس "قند"، فيرتشف الشاي من حولها كما لو كان الفعل طقساً قديماً. قد يضاف أحياناً الهيل أو نبتة تدعى "چای کوهی"، وهي زهرٌ برّيٌ يعطّر الشاي بنكهةٍ جبليةٍ لا يخطئها أنفٌ، ولها أيضاً فوائد طبيعية.
أمّا في الجنوب حيث حرارة الطقس ترهِق الجسد، فالشاي يُعدّ بطريقةٍ أخفّ، ويقدّم في كؤوسٍ زجاجيةٍ صغيرةٍ كي لا يفقد حرارته بسرعة. في مدن كالأهواز وعبادان، يضاف أحياناً ماء الورد أو "ليمو عماني" (وهو اسم الليمون المجفف في الأسواق الإيرانية)، لإضفاء بعض الانتعاش إلى الشاي. والناس هناك يشربونه في الصباح الباكر قبل أن تبدأ حرارة النهار، أو في المساء بعد أن تهدأ الأرض من وطأة الشمس.
في القرى، لا يزال الشاي يحضَّر على نار الحطب. لا سماور كهربائيٌّ ولا استعجال. تغلى المياه في إبريقٍ نحاسيٍّ فوق موقدٍ من الطين، بعد أن تجمَع أعشاب الشاي يدوياً وتجفَّف في الشمس. مذاق الشاي هناك أكثر خشونةً، لكّنه يحمل دفئاً لا يمكن للمدينة أن تمنحه. تجلس العائلات تحت شجرة توتٍ أو جوزٍ، ويمرّرون الكأس من يدٍ إلى أخرى كأنّهم يمرِّرون الحكايات نفسها.
في المدن الكبرى، مثل طهران وأصفهان وشيراز، تختلف طقوس الشاي بحسب الطبقة الاجتماعية. في البيوت البسيطة يقدَّم على صينيةٍ معدنيةٍ إلى جانب مكعبات سكّر وعلبةٍ بلاستيكيةٍ فيها كعكٌ بسيطٌ أو بسكويت. أمّا في بيوت الأثرياء، فالصينية قد تكون فضيةً والكأس على طبقٍ صغيرٍ وإلى جانبه قطعة حلوى فاخرةٌ أو مكعّب سكّر مزيّنٍ بالزعفران. وقد يستخدم شايٌ مستوردٌ عالي الجودة أحياناً، لا سيما من دارجيلينغ أو سيلان، ما يعدّه البعض نوعاً من الترف.
حتى بين الأجيال، تتباين العلاقة مع الشاي في إيران. فالكبار الذين عايشوا الثورة والحرب لا يمكنهم بدء يومهم بلا كأس شايٍ عند السابعة صباحاً. وكأن الجسد نفسه لا يُفعَّل إلّا بتلك الجرعة الأولى. الشاي هناك ليس مجرّد عادةٍ، بل امتدادٌ زمنيٌّ لجهازٍ عصبيٍّ تدرّب على طقوس البقاء. أمّا الشباب فيميلون أحياناً إلى القهوة، لا سيما في طهران، علامةً على الانفتاح أو الحداثة أو حتى التمرّد الصامت على إرث الأجيال.
ثمّة أيضاً طقوسٌ تتصل بالحزن والفرح. في مجالس العزاء، يقدَّم الشاي في إيران بلا سكّر، إشارةً صامتةً للحزن. وفي الأعراس، يقدَّم في أكوابٍ مزيّنةٍ مع الزعفران واللبان، كأنما الشاي أيضاً مدعو للاحتفال.
في رمضان 2025، وفي الحسينيّات التي تزدهر ليلاً في طهران في أيّامٍ محددةٍ من الشهر، كان الشاي يوزَّع مع وجبة الإفطار في كؤوسٍ صغيرةٍ بيد شاباتٍ يوزّعن الطعام على المارّة بابتساماتٍ خفيفة. في تلك المجالس، كان الشاي فعلَ تضامنٍ وخدمةٍ وانتماء.
إحدى تلك الليالي، عشيّة ذكرى مولد الإمام الحسن، مررتُ للمرّة الثانية بحسينيّةٍ صغيرةٍ أسّسها عددٌ ممّن قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية كنتُ صادفتهم من قبل، ومنذئذٍ صاروا يحيّونني كلّما مررت معتقدين أنّني من سكّان طهران. في تلك الليلة، كنت متردّدةً في أن أتوقّف لتناول كوب شايٍ وقطعة بسكويت، لكنني فعلت. وما أن عرفوا أنني زائرةٌ حتّى دعوني للدخول وتناول الإفطار معهم. عرضتُ عليهم أن أساعد في توزيع أكواب الشاي فرحّبوا بالفكرة، وكأنّ وجودي بينهم كان أمراً مألوفاً، جزءاً من الطقوس لا غريباً يقتحمها.
جلسنا على الأرض في الداخل وتشاركنا الإفطار، بينما كان الشاي يصَبّ من إبريقٍ خزفيٍّ أبيض، كتِب عليه اسم الإمام الحسين بالأسود. شربنا الشاي لا بعد الطعام، بل معه. كان يتدفّق بيننا جزءاً من الوجبة وليس ختاماً لها. ففي الثقافة الإيرانية يشرب الشاي الحلو مع وجبة الطعام، لا بعدها، فَبِهِ يستكمَل الطعم ويستقرّ الهضم. ينقَع فيه خبز البربري (أحد أشهر أنواع الخبز في إيران)، ويُذوّب فيه جبن الماعز، وتليّن به الخضروات الطازجة، فيضفي نكهةً مميّزةً على هذا المزيج. وأنا أكتب الآن، يكاد الطعم يعود إلى فمي.
كنت أحمل في داخلي شيئاً من الخوف، شعوراً خفيّاً بالاختلاف الطائفي نسجه خيالي حين وقفتُ عند الباب، وغذّاه الإعلام بالصورة المسبقة التي يرسمها عن إيران وتظهِر الشعب والسلطة كتلةً واحدةً لا تحتمل الاختلاف. تلاشى كلّ ذلك بسرعةٍ، تماماً في اللحظة التي قدّمتْ لي فيها إحدى الشابّات أوّل كأس شايٍ لأفطر عليه. ذاب الخوف كما يذوب مكعّب السكر في كوب شايٍ ساخن. لم يسألني أحد عن طائفتي ولم تكن بيننا لغةٌ مشتركةٌ، ففارسيتي كانت بسيطةً وإنجليزيتهم أبسط. لكننا ضحكنا كثيراً ونحن نتبادل الخبز والجبن والشاي، ضحكٌ فيه من الدفء ما يغني عن أيّ ترجمة.
مع بداية عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني سنة 2013، شهدت إيران موجةً جديدةً من الانفتاح النسبي. لم تقتصر هذه الموجة على الخطاب الدبلوماسي أو الاتفاقات في ما يخصّ برنامج إيران النووي، بل تسللت إلى تفاصيل الحياة اليومية، ومنها فضاء المقاهي. بدأت تظهر في طهران ومدن كبرى أخرى مقاهٍ جديدةٌ بتصاميم عصريةٍ، أقرب في هويتها البصرية إلى تلك الموجودة في بيروت أو إسطنبول أو برلين منها إلى "قهوه خانه" التقليدية. لم يكن هذا تحوّلاً في الذوق العامّ، بل كان انعكاساً لتحوّلاتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ أوسع.
في ظلّ بطالةٍ متزايدةٍ بين الشباب وقيودٍ سياسيةٍ متواصلة، باتت المقاهي الحديثة تقدّم نموذجاً لاقتصادٍ صغيرٍ لا يعتمد على الدولة ولا يخضع لها. يمكنه خلق مساحةٍ للعمل والتعبير، والانتماء إلى عالمٍ رقميٍّ أوسع. وبفعل الصعود السريع لوسائط مثل تطبيقَيْ إنستغرام وتيك توك، أصبح فنجان القهوة إلى جانب كتابٍ أو حاسوبٍ محمولٍ، مشهداً مألوفاً في حسابات الشباب الإيراني الذين يسعون – رغم الجدران – إلى إعادة ترسيم علاقتهم بالعالم. فالمقهى لم يعد مكاناً لتناول المشاريب، بل صار موقعاً للظهور وصناعة الذات وتحدّي العزلة المفروضة سياسياً. إنها محاولةٌ حثيثةٌ لتحويل مشهد الحياة اليومية إلى بيانٍ ثقافيٍّ معلَنٍ، يمرّ من عدسة الكاميرا ومن فم فنجان قهوة.
لم تكن المقاهي في إيران محاكاةً لثقافةٍ غربيةٍ أو استيراداً حديثاً لثقافة القهوة. إنها امتدادٌ لفضاءٍ عامٍّ نشأ في قلب العمارة الصفوية بمدنٍ كأصفهان. فقد ازدهرت المقاهي في ساحة نقش جهان بالمدينة، حيث التقت الروائع الهندسية بسحر التجمّع الجماهيري، وشهد الرحالة الأوروبيون فضاءً حيوياً يجمع النقّاد والأدباء والمحبّين. وقد وثَّق آدم أولياريوس، سكرتير سفير دوقية هولشتاين (الواقعة في أراضي شمال ألمانيا اليوم) إلى الدولة الصفوية، جمال العمارة التي ميّزت المقاهي في تلك الفترة. ونستند في هذا الوصف إلى ما ورد في كتابه الأصلي باللغة الألمانية "ڤيرميرته نيفي بِشْرايبونغ دير موسكوڤيتشِن أوند پِرزيشِن رايزِه" (الوصف الجديد والموسّع للرحلة إلى روسيا وفارس)، الذي نُشر سنة 1656، ويتضمّن مشاهداته وتوثيقه أثناء إقامته في أصفهان بين سنتَيْ 1637 و 1638.
ويشير الباحث الإيراني المتخصص في تاريخ الفن والعمارة، فارشيد إمامي، إلى أن المقاهي أسهمت في بلورة "فضاءٍ عام" ثقافيٍّ فعّالٍ احتضن الشعر والموسيقى. جاء ذلك في دراسةٍ نشرت سنة 2016 تحت عنوان "كوفيهاوسِز، أوربان سْبيسز أند ذه فورميشن أوف إيه بابليك سْفير إن ساففيد إصفهان" (المقاهي، الفضاءات المدنية، وتشكّل فضاء عام في أصفهان الصفوية). وكان شاه عباس الأول الذي حكم من 1588 حتى 1629، ثالث ملوك الدولة الصفوية في إيران ومؤسس أصفهان الحديثة، يحضر إلى هذه المقاهي ويشهد أنشطتها، دليلاً على أهميتها الرمزية والاجتماعية.
بالموازاة نُسِّقت تلك المساحات بطريقة الفن المعماري التقليدي. صالاتٌ مقبّبةٌ ونوافير وعواميد مضيئةٌ تحاكي التقاء الترف والانفتاح، قبل أن تصل فكرة المقهى إلى أوروبا. ففي المملكة المتحدة، لم يُفتتح أوّل مقهىً في أكسفورد إلّا سنة 1650 ثم تلاه مقهىً في لندن سنة 1652، بحسب ما يرد في موسوعة "كونكسبيديا" الكندية المتخصصة في التوثيق الاجتماعي، أي بعد نحو خمسة عقودٍ كاملةٍ على ازدهار فضاء المقاهي في إيران.
إننا أمام قراءةٍ جديدة. لَم تنقل إيران تجربة المقهى الغربي، بل أضفت عليها تشكيلاً حضارياً خاصاً، قبل أن يُعاد تصدير الفكرة نحو الغرب. كانت المقاهي في إيران في الجوهر، مشروعاً حضارياً واجتماعياً، وليس مجرّد تقليد. قد يكون انتشار المقاهي الحديثة استرداداً للمشروع الأوّلي الذي صدّرته إيران إلى العالم الغربي.
كتبتُ هذه الكلمات يوم كانت طهران تحترق، وقلبي يتفتّت كزجاج نافذةٍ في عاصفة. شعرتُ أن المدينة التي أحببتها حتى جذورها تُنتزع من بين أصابعي، كأن أحدهم يقتلع شجرةً نبتت داخلي.
طهران لم تكن مدينةً فحسب، بل رحماً آخَر وُلدت فيه من جديد. دخلتُها غريبةً، أبحث عن ظلّي بين أزقّتها. وخرجتُ منها وكأن روحها التصقت بروحي، فلا سبيل للفكاك. ما زلتُ أسترجع تلك الليالي في حدائق بيوت الأصدقاء. نحتسي الشاي في باحاتٍ تتلألأ بندى المساء، نراقب الزهور التي اشتريناها معاً وهي تستقرّ في التراب، ونتبادل الشِعر كما لو كان امتداداً لحرارة الشاي بين أيدينا. كلّ رشفةٍ تفتح باباً جديداً للكلمات، وكل بيتٍ شعريٍ يذوب في الفناجين كما يذوب السكّر، حتى يصبح الشاي نفسه قصيدةً سائلةً نرتشفها ببطءٍ كي لا تنتهي. كنت أصمت طويلاً، مأخوذةً بليونة أصواتهم وبرهافة الحروف حين تتساقط من أفواههم، وأرتشف الشاي متمنيةً أن أعود الى طهران حتى قبل أن أغادرها.
يحملني طعم الشاي الذي أحتسيه الآن إلى تلك الأزقّة التي تعلّمتُ فيها أن أصغي للعالم ببطءٍ، أن أرى في كلّ زهرةٍ حياةً مكتملةً، وفي كلّ كلمةٍ عابرةٍ قصيدةً كاملة.
كان الحنين إلى طهران وهي تحترق جرحاً حيّاً، فلم أجد ملاذاً إلّا في الشاي، في طقسه البسيط الذي كان يختزن كلّ ما تركته هناك. الشاي صورةٌ حيّةٌ لليالي إيران، ومرور الملعقة في الفنجان يذكّرني بنبرةِ صديقٍ يلقي كتاباتِه على ضيوفه وتلاميذه بلكنته البوشهرية. ومع أنّي لم أفهم عمقَ ما كتب، كنت أترقّب لحظةَ حديثه عنها لضيوفه وأنا أُعِدّ لهم الشاي، وصوت السماور الكهربائي يعاود النبض. فيذكّرني بنهضتي لأُعِدَّ فنجانَ شايٍ آخر. الشاي، ذاك الخيط الذي يجمع ملامح الوجوه وضحكاتنا الخافتة، ورائحة الحدائق التي اختلط فيها عبق التراب برائحة النعناع الطازج.
اليوم كلّما سكبتُ الماء على أوراق الشاي من لاهيجان، يتصاعد البخار كما لو يحمل وجوه أصدقائي معه. تتسلّل أصواتهم بين الدرجات الحادّة لرائحة الشاي، تملأ الغرفة كأنها لا تزال هناك. ومع أول رشفةٍ أرى نفسي أمشي في شوارع طهران وأصغي إلى الريح التي كانت تمرّ عبر أشجارها. وأشعر أن لحظةً واحدةً تكفي لتعيد إليّ كلّ شيءٍ: دفء اللقاءات، وهدوء الليل، وطمأنينة الإحساس بأنني أنتمي.