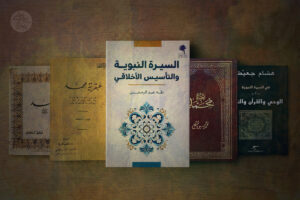تباينت التقديرات حول نجاح العملية في القضاء على البرنامج النووي الإيراني. فبُعَيْد الضربات أعلن الرئيس ترامب أن "منشآت إيران الأساسية لتخصيب اليورانيوم دمِّرَت تماماً". غير أنه بعد أيامٍ، أفادت شبكة سي إن إن بأن وكالة استخبارات الدفاع، الذراع الاستخباراتية لوزارة الدفاع الأمريكية، خلصت إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية على المنشآت الإيرانية الثلاث لم تدمِّر البرنامج النووي الإيراني، إنما أعادته أشهراً إلى الوراء فحسب. وقال مصدران في الوكالة انخرطا في التقييم المبدئي للضربة الأمريكية إن أجهزة الطرد المركزي بقيت بمأمنٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، وإن اليورانيوم المخصّب نقل من المواقع قبل الضربات الأمريكية. ردّت إدارة ترامب بغضبٍ على هذا التقرير، إذ أكّد ترامب أن الضربات كانت واحدة "من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ"، وأن "المواقع النووية في إيران قد دُمّرت بالكامل".
وسواء دُمّر البرنامج النووي الإيراني أم لا، فإن هذه الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بدت وكأنها دقّت المسمار الأخير في نعش المنظومة الدولية للحدّ من انتشار الأسلحة النووية، التي نشأت مع توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي سنة 1970. فقد أبانت الهجمات عن الخلل البنيوي في هذه المنظومة المتمثل بالسماح لخمس قوىً بالاحتفاظ بأسلحةٍ نوويةٍ في حين تحظرها على الآخرين. اعتماد المعاهدة على الامتثال الطوعي أتاح للمصمّمين على الانتشار النووي إمّا البقاء خارجها كالهند وإسرائيل وباكستان، أو الانسحاب كما فعلت كوريا الشمالية. ولّدت هذه الحالة معضلاتٍ أمنيّةً تجعل الدول غير النووية تشعر بالهشاشة أمام جيرانٍ مسلحين نووياً، ما يدفعها للسعي وراء الحصول على هذه الأسلحة. جاء الهجوم على برنامج إيران النووي ليؤكد المنطق الذي سعت المعاهدة إلى تقويضه: أن السلاح النووي وحده يوفر ضماناتٍ أمنيّةً حقيقية.
انقسم المنظّرون في أعقاب الحرب العالمية الثانية إزاء مسألة بروز الأسلحة النووية وإدارتها وتأثيرها المستقبلي بين فلسفتين متنافستين. ارتكزَ الفريق الأول على مفهوم الردع لمنع الحرب. والمقصود بالردع في العلاقات الدولية منع فاعلٍ ما فاعلاً آخَر من اتخاذ خطوةٍ معيّنةٍ عبر التهديد بعواقب غير مرغوبة. حاجَجَ آنذاك الفيزيائي الأمريكي والعضو المؤسس في معهد هدسون والمنظّر في استراتيجيات الردع، هيرمان كان، بأن الأسلحة النووية قد تمنع الحرب عبر مبدأ "التدمير المتبادل المؤكد"، إذ توفّر استقراراً عبر تهديد الفناء المتبادل. اشتهر هذا المفهوم أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حين راكم الطرفان ترساناتٍ نوويةً هائلةً لردع بعضهما عن الضربة الأولى، تأكيداً بأن أيّ هجومٍ سيقابَل بردٍّ انتقاميٍ مدمِّر.
أما الفريق الثاني فقد رأى أن طريقة الردع هذه تجعل من مسألة الفناء البشري احتمالاً دائماً، وأن لا مناص من نزع السلاح لأنه السبيل العقلاني الوحيد. قدّم عالِم الرياضيات الأمريكي جيمس نيومان أشدَّ نقدٍ لاذعٍ حين وصف أعمال هيرمان كان بأنها "رسالة أخلاقية عن القتل الجماعي: كيف تخطط له، كيف تنفّذه، كيف تفلت من عواقبه، وكيف تبرّره". أما الفيلسوف البريطاني برتراند راسل، الذي شارك في صياغة "بيان راسل آينشتاين" سنة 1955 الداعي إلى نزع السلاح النووي، فقد رأى أن تصورات كان التفصيلية لما بعد الحرب النووية تثبِت فعلياً الحكمة في تجنّب مثل هذه الحرب البتّة. وسبق أن اعتبر القسّ الأمريكي والناشط الاشتراكي المعادي للحرب نورمان ثوماس أن أعمال كان تبيّن لماذا "يشكّل نزع السلاح الشامل الأمل الوحيد لبقاءٍ كريمٍ للنوع البشري".
برزت المحاولات الأولى لمنع الانتشار النووي بعد الحرب العالمية الثانية، يحدوها إدراكٌ عميقٌ بأن القنبلة الذرية تمثل تهديداً غير مسبوقٍ على الأمن العالمي. وتمثّل أبرز هذه الجهود المبكرة في "خطة باروخ" التي قُدّمت إلى لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرّية في يونيو سنة 1946. سُمّيت الخطّة بِاسم برنارد باروخ، وهو رجل أعمالٍ أمريكيٌ عمل مستشاراً لعدّة رؤساء أمريكيين واختاره الرئيس ترومان ممثلاً للولايات المتحدة في اللجنة. اقترحت الخطة إنشاء "الهيئة الدولية للتنمية الذرية" التي تتملك وتدير جميع مناجم اليورانيوم والمنشآت النووية والمواد الانشطارية في العالم. وعليه، وبموجب هذه الخطة، تتنازل الدول عن أسلحتها ومنشآتها النووية إلى جهة إشرافٍ دوليةٍ، مع تمكين الهيئة من تفتيش أيّ موقعٍ وفرض عقوباتٍ فوريةٍ على المخالفين. وهي عقوباتٌ لا يمكن لأيّ طرفٍ في مجلس الأمن أن يستخدم حقّ النقض ضدّها.
فشلت خطة باروخ لأسبابٍ لن تكفّ عن عرقلة جهود السيطرة النووية عقوداً. فقد رآها الاتحاد السوفييتي محاولةً من الولايات المتحدة للحفاظ على احتكارها النووي ومنع موسكو من امتلاك قدرة ردع. وتعزّز الشك السوفييتي لأن الخطة طالبت الدول الأخرى بالتخلي عن أسلحتها أولاً بينما تبقى الأسلحة الأمريكية حتى المرحلة الأخيرة من التنفيذ. ورفضت حكومة ستالين نظام التفتيش المقترح وعدَّته انتهاكاً للسيادة السوفييتية.
يضاف إلى ذلك أن الخطة كانت ستمنح الولايات المتحدة وحلفاءها سيطرةً فعليةً على الهيئة الدولية، في حين كانت الدول الغربية تهيمن على عضوية الأمم المتحدة كذلك. وردّ السوفييت بمقترحٍ مضادٍّ يدعو إلى نزع سلاحٍ نوويٍ فوريٍ من جميع الدول، بيد أنّ الولايات المتحدة رفضت المقترح لأنها لم تكن مستعدةً للتخلي عن ميزتها النووية من دون آليّات تحقّقٍ صارمةٍ، وهو ما لم يكن الاتحاد السوفييتي ليقبله. فقضى هذا الجمود على مشروع الرقابة النووية الدولية، ومهّد الطريق لسباق التسلح الذي طبع حقبة الحرب الباردة وما حملته هذه المرحلة من مخاطر وأحداثٍ حتّمت عودة النقاش في حظر الانتشار النووي.
واجه الرئيس الأمريكي جون كينيدي ضغوطاً هائلةً من مستشاريه العسكريين لشنّ ضرباتٍ جويةٍ فوريةٍ على مواقع الصواريخ. وهو ما قد يؤدي إلى ردٍّ سوفييتيٍ وتصعيدٍ إلى مواجهةٍ نوويةٍ شاملة. حينئذٍ، أبحرت سفنٌ سوفييتيةٌ تحمل كثيراً من الصواريخ نحو كوبا بينما استعدّت المدمرات الأمريكية لاعتراضها. وفي ذروة الأزمة، كادت غواصةٌ سوفييتيةٌ مسلحةٌ بنسيفةٍ (طوربيد) نوويةٍ أن تطلقها على المدمرات الأمريكية لولا امتناع أحد القادة الثلاثة المكلفين بالهجوم. وفي المقابل، كان الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف يواجه ضغوطاً من بعض مستشاريه الذين طالبوه بالدفاع عن المنشآت السوفييتية في كوبا بأيّ ثمنٍ كان.
كشفت الأزمة سهولة اندلاع حربٍ نوويةٍ نتيجة سوء تقديرٍ أو سوء تواصلٍ أو قرارات قادةٍ ميدانيين واقعين تحت ضغطٍ هائل. وأدرك كلٌّ من كينيدي وخروتشوف أنهما فقدا السيطرة على مجريات الأحداث، وأن منطق المواجهة النووية كان يدفعهما إلى حربٍ لا يريدانها. قاد هذا الإدراكُ إلى القناعة بأنه في عالمٍ متعدد القوى النووية، ستزداد مثل هذه الأزمات بما لا يمكن لجمه. فكل قوةٍ نوويةٍ إضافيةٍ ستخلق احتمالاتٍ جديدةً للحوادث وسوء الفهم، أو الاستفزازات المتعمدة التي قد تتصاعد فوق قدرة أيّ قائدٍ على التحكم بها. وانتهى الأمر بكينيدي وخروتشوف إلى أنّ الحرب النووية ستغدو حتميةً في نهاية المطاف ما لم يُوقَف انتشار الأسلحة النووية.
أفضى هذا الإدراك إلى انفراجةٍ في أغسطس 1967، حين قدّمت القوّتان المتصارعتان اللتان تمتلكان الغالبية الساحقة من الأسلحة النووية مشروعَ معاهدة عدم الانتشار إلى لجنة نزع السلاح في الأمم المتحدة. وبعد شهورٍ من التعديلات لتلبية مطالب الدول غير النووية، لا سيّما بشأن الالتزامات بالنزع النهائي للسلاح، وُقّعت معاهدة حظر الانتشار النووي في يوليو 1968 لتدخل حيز التنفيذ سنة 1970. أنشأت المعاهدة تصنيفين من الدول استناداً إلى القدرات النووية القائمة، خمس دولٍ هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا والصين، احتفظت بأسلحتها النووية مع التعهّد بنزعها في نهاية المطاف، فيما تخلّت بقية الدول عن السلاح النووي إلى الأبد مقابل الحصول على الدعم في مجال الطاقة النووية السلمية.
تمثّلت أولى هذه الإشكاليات في عجز المعاهدة عن التعامل مع الدول غير الموقّعة. وإسرائيل هنا هي المثال الأبرز، إذ بدأ برنامجها النووي في منتصف خمسينيات القرن الماضي، أي قبل تدشين المعاهدة، بعد أن دخلت في شراكةٍ سرّيةٍ مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا في صحراء النقب. بدأ البناء في 1958، ودخل المفاعل طورَ التشغيل بين سنتَيْ 1963 و1964. أي إنّ إسرائيل طوّرت قدراتها النووية في حين مفاوضات المعاهدة واعتمادها. فمكّن امتناع إسرائيل عن التوقيع من تفاديها الرقابة الدولية مع الحفاظ على غموضٍ بشأن قدراتها. ومع أنّ التقديرات الاستخباراتية الغربية، ووكالة الاستخبارات الأمريكية بالذات، أشارت إلى أنّ إسرائيل امتلكت ترسانةً نوويةً قبل حلول أواخر السبعينيات، إلّا أن المجتمع الدولي عجزَ عن إلزامها بالامتثال أو الشفافية.
أمّا الإشكالية الثانية فتكمن في عدم وضوح الحدّ الفاصل بين البرامج النووية العسكرية والمدنية. فالهند عندما جرّبت قنبلتها النووية سنة 1974 وصفتها بأنها "تفجير سلمي". استغلّت الهند ثغرةً في صياغة المعاهدة فرّقت بين البرامج العسكرية والمدنية. ولم توقع على المعاهدة أصلاً بحجة أنها تؤسّس لتراتبيةٍ غير عادلةٍ بين مالكي السلاح النووي و"المحرومين" منه. وقد أثبت اختبارها أنّ الدول قادرةٌ على تطوير قدراتٍ نوويةٍ عسكريةٍ مع البقاء خارج قيود المعاهدة تقنياً، وأنّ التمييز بين التقنية السلمية والعسكرية يكاد يكون بلا معنىً، إذ إن تقنيات التخصيب وإعادة المعالجة اللازمة للمفاعلات المدنية تكفي لإنتاج موادّ صالحةٍ للأسلحة.
تجلّت إشكالية المعاهدة الثالثة في مطلع الثمانينيات بعدما اتضح عجز المنظومة النووية عن منع أيٍّ من الدول عن شنّ عملٍ عسكريٍ أحاديٍّ ضدّ برامج نوويةٍ لدولٍ أخرى. ففي سنة 1981، وتحت مسمى "عملية أوبرا"، شنّت إسرائيل هجوماً أحادياً على مفاعل تموز (أوزيراك) العراقي. ومع أنّ القادة الإسرائيليين برّروا الضربة بأنها منعت العراق من تطوير أسلحةٍ نوويةٍ وحمت المنطقة من انتشارها، غير أنّ السجل التاريخي يقول لنا روايةً مغايرة. فعوضاً عن التخلّي عن البرنامج النووي، سرّع العراق خطواته بعد الهجوم. وبدا أنّ الضربة الإسرائيلية "أفضت إلى إطلاق برنامج أسلحة نووية لم يكن موجوداً بالأساس". أي إن الهجمات لم توقِف الطموحات العراقية، بل دفعت صدام حسين إلى الاعتقاد بأنّ امتلاك السلاح النووي ضرورةٌ لردع أيّ هجومٍ إسرائيليٍ مستقبليّ. فانتقل البرنامج إلى العمل السرّي وتوسّع بدرجةٍ كبيرةٍ، ولم يفكّك إلّا بعد حرب الخليج سنة 1991 وعمليات التفتيش الأممية اللاحقة. ويتبين هنا أنّ الضربات العسكرية قادرةٌ على تدمير منشآتٍ وقتل طواقم عمل، بيد أنّها عاجزةٌ عن محو المعرفة النوويّة أو تغيير الحسابات الاستراتيجية أبداً.
أما الإشكالية الرابعة للمعاهدة والمنظومة النابعة منها فهو عجزها عن منع سباقات تسلّحٍ إقليميةٍ بين الدول التي لم توقّع عليها. تجلّى هذا مع برنامج باكستان النووي الذي تُوّج بتجارب سنة 1998. كان مشروع باكستان مدفوعاً بشعورٍ بالتهديد من القدرات النووية الهندية ما أنتج معضلةً أمنيةً عجز إطار المعاهدة عن معالجتها. إذ إن استحواذ دولةٍ ما على أسلحةٍ نوويةٍ يفرض على الفور ضغوطاً أمنيّةً على الجيران والمنافسين الإقليميين. فقد كان اختبار الهند سنة 1974 الدافع المباشر لبرنامج باكستان، وهو ما رفع من مستوى التوتر في جنوب آسيا وألقى بظلاله على حسابات إيران ودولٍ إقليميةٍ أخرى. وهذا يعني أنّ الانتشار النووي لا يبقى محصوراً في علاقةٍ ثنائيةٍ، بل يمتدّ مولّداً معضلاتٍ جديدةً ومشجّعاً على مزيدٍ من تطوير الأسلحة إقليمياً.
أما إشكالية المعاهدة الأخيرة فهي ضعف آليّات فرضها. وكوريا الشمالية خير مثال. وقّعت بيونغ يانغ على المعاهدة سنة 1985، لكنها انتهكت اتفاقات الضمانات في تسعينيات القرن الماضي، إذ أعادت معالجة البلوتونيوم سرّاً لأغراضٍ عسكرية. وعندما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بتفتيشٍ خاصٍّ سنة 1993، أعلنت كوريا الشمالية انسحابها من المعاهدة لتغدوَ أول دولةٍ تفعلها. ومع أنها جرّبت تجارب نوويةً في سنوات 2006 و2009 و2013 و2016 و2017، إلا أن المجتمع الدولي لم يستطع سوى فرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ عليها. وأثبت انسحابها أنّ المعاهدة اتفاقٌ طوعيٌ في جوهره، بلا سلطة فرضٍ ملزِمةٍ تجاه من يصرّ على خرقها.
ومع نهاية الحرب الباردة في الثمانينيات، خطت القوى العظمى خطواتٍ أجرأ للحدّ من انتشار الأسلحة النووية. فقد شهدت اتفاقيات الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية (ستارت) في الثمانينيات والتسعينيات تخفيض الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كثيراً من قوتيهما النوويتين. وقد ألزمت معاهدة "ستارت" الأولى البلدين بتقليص عدد الرؤوس الحربية النووية أثناء ذروة الحرب الباردة. ولم يتوقف الزخم مع انهيار الاتحاد السوفييتي، بل استمر حين أبرم الرئيس جورج بوش الأب والرئيس الروسي بوريس يلتسين تفاهماتٍ غير رسميةٍ لتقليص التصنيع النووي أكثر. فأخذت الأسلحة النووية، التي كانت تُعدّ بعشرات الآلاف، تختفي من القواعد العسكرية حول العالم ما خلق تفاؤلاً بإمكانية تحقّق نزع السلاح النووي.
تزامنت ذروة هذا التفاؤل مع رئاسة باراك أوباما. ففي خطابه الذي ألقاه في العاصمة التشيكية براغ في أبريل 2009، قال أوباما: "أُعلِنها واضحةً، بقناعةٍ تامّةٍ، بالتزام أمريكا بالسعي لتحقيق السلام والأمن في عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية". وقد كان لرؤية أوباما أبعادٌ متعددة. إذ أدّت معاهدة "ستارت الجديدة" مع روسيا، التي وقِّعَت سنة 2010، إلى تقليص قوتيّ البلدين إلى 1550 رأساً نووياً منشوراً لكلٍّ منهما، وهو أدنى مستوىً منذ الخمسينيات. كذلك جمعت قمم الأمن النووي قادة العالم لتأمين المواد النووية الخطرة، وقلّصت الولايات المتحدة من دور الأسلحة النووية في مخططاتها العسكرية.
إضافةً إلى ذلك، جعل أوباما من الاتفاق النووي مع إيران حجر الزاوية في سياسته الخارجية. بدأ البرنامج النووي الإيراني في خمسينيات القرن الماضي في عهد الشاه بمساعدةٍ أمريكيةٍ عبر برنامج آيزنهاور "الذرّة من أجل السلام". وبعد الثورة الإسلامية سنة 1979، تُخُلِّيَ عن البرنامج لكنه استؤنِف بهدوءٍ أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. كشفت جماعاتٌ إيرانيةٌ معارضةٌ البرنامج السرّي الإيراني سنة 2002 ووجود منشآتٍ لتخصيب اليورانيوم في نطنز ومفاعلٍ يعمل بالماء الثقيل في أراك يمكنه إنتاج البلوتونيوم للأسلحة. أخفت إيران هذه المنشآت عن المفتشين الدوليين لما يقرب من عقدين.
ما تلا ذلك كان شبيهاً بلعبة القط والفأر الطويلة التي أبانت عن حدود نظام المراقبة الدولي. كانت إيران تتعاون مع المفتشين ثم تطردهم، وتفرض الأمم المتحدة عقوباتٍ فتقدّم إيران تنازلاتٍ، لتعود لاحقاً إلى أنشطةٍ محظورة. وفي هذا النمط من الامتثال والعصيان، تقدّم برنامج إيران النووي باطّرادٍ فيما ظلّت المفاوضات تراوح مكانها. وقد أظهر هذا النمط كيف يمكن للمصممين على حيازة السلاح النووي التلاعب بتفضيل النظام الدولي للانخراط الدبلوماسي، مستخدمين المفاوضات غطاءً لمواصلة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالأسلحة.
بعد عدّة جولاتٍ من المفاوضات، وقّعت الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، إضافةً لألمانيا "خطة العمل الشاملة المشتركة" في يوليو 2015. وافقت إيران على التخلّي عن جزءٍ كبيرٍ من اليورانيوم المخصّب لديها وقبول عمليات تفتيشٍ دوليةٍ غير مسبوقةٍ وتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وكانت سنة 2015 بمثابة ذروة التفاؤل الذي أعقب الحرب الباردة بشأن إمكانية الوصول إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية. فقد نجحت "ستارت الجديدة" في تقليص القوة الأمريكية الروسية، وأدّى الاتفاق مع إيران إلى حلّ أزمة انتشارٍ خطيرةٍ عبر الدبلوماسية، فيما بدا نظام عدم انتشار الأسلحة النووية فاعلاً ومتيناً.
وجّه الغزو الروسي أوكرانيا في فبراير 2022 الضربةَ الأشدّ لنظام ضبط التسلح. فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2023 تعليق مشاركة روسيا في "ستارت الجديدة"، بيد أنّه لم يذهب إلى حدّ الانسحاب الكامل. واستند إلى المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وتوسّع الناتو لتسويغ خطوته، منهياً فعلياً عمليات التفتيش وتبادل البيانات بين أكبر قوّتين نوويتين. كذلك انسحبت روسيا من نظام الرصد التابع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وهدّدت باستئناف التجارب. بدا هذا التعليق نهاية نظام ضبط التسلح الثنائي الذي نظّم التنافس النووي الأمريكي الروسي طيلة أكثر من خمسة عقود.
مثّل انهيار معاهدة "ستارت" والنظام الأوسع للحدّ من التسلح تحوّلاً جوهرياً في الإمكانات النووية العالمية. فغياب القيود التعاهدية أتاح لكلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا توسيع قوتيهما بلا حدٍّ، وهي أوّل مرّةٍ منذ السبعينيات. وألغى غياب آليّات التفتيش وتبادل البيانات الشفافيةَ وزاد من احتمالات سوء التقدير أثناء الأزمات. كذلك أزال انهيار التعاون الأمريكي الروسي القيادةَ التي دفعت جهود عدم الانتشار عالمياً. فعندما تتخلّى أكبر قوّتين نوويتين عن ضبط التسلح، يصعب إقناع الدول الأخرى بقبول قيودٍ على الانتشار. لم يهدد تفكّك "ستارت" الاستقرارَ الثنائي فحسب، بل المنظومة العالمية لعدم الانتشار بأسرها.
كان يفترض أن يحلّ الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 مسألة البرنامج النووي الإيراني عبر المسار الدبلوماسي، وقد بدا أن هذا النهج قد يكلّل بالنجاح. إذ قبلت إيران بفرض قيودٍ صارمةٍ على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، مع إنشاء أكثر أنظمة المراقبة تدخلاً في التاريخ لضمان عدم تمكنها من بناء أسلحةٍ نوويةٍ سراً. وعلى مدار عامين، عمل الاتفاق عمله كما نُصّ عليه. التزمت إيران بتعهداتها وتمكّن المفتشون الدوليون من دخول منشآتٍ نوويةٍ إيرانيةٍ غير مسبوقةٍ وتقلّص مخزون إيران من اليورانيوم كثيراً وتوقفت أنشطتها النووية الأخطر.
مثّل الاتفاق نموذجاً لنجاح نظام عدم الانتشار، إذ جمع بين التحقق والحوافز والانخراط الدبلوماسي للحدّ من برنامجٍ نوويّ. غير أنه واجه أعداء نافذين قضوا على نجاحه. فقد وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ تاريخي". كذلك هاجم دونالد ترامب الاتفاق في حملته الانتخابية سنة 2016، ثم انسحب منه في مايو 2018. وعد ترامب بالتفاوض على "اتفاقٍ أفضل" وفرض أشدّ العقوبات في التاريخ على إيران. وردّت إيران بانتهاكٍ تدريجيٍ للاتفاق الذي لم تعد تجني منه فوائد. وبحلول سنة 2021، كانت تخصّب اليورانيوم بنسبة نقاءٍ تصل إلى 60 بالمائة، وهي نسبةٌ تقرّبها من مستوى صنع الأسلحة النووية. وهكذا انهار الاتفاق الذي كان يفترض أن يمنع حصول إيران على السلاح النووي، فيما باتت قدراتها النووية تتقدم أسرع من أيّ وقتٍ مضى.
كانت إسرائيل وإيران في خضمّ حرب ظلٍّ وحروبٍ بالوكالة تعزّزت في العقد الأول من الألفية. هاجمت إسرائيل مثلاً بفيروس "ستاكسنت" سنة 2010 منشآتٍ نوويةً إيرانيةً، وأحدثت انفجاراتٍ غامضةً في مواقع نوويةٍ وعسكريةٍ إيرانيةٍ، واغتالت علماء على الأراضي الإيرانية. وردّت إيران بدعم جماعاتٍ وكيلةٍ في المنطقة ومهاجمة أهدافٍ إسرائيليةٍ وأمريكية. ومع انهيار الاتفاق النووي وفشل المسار الدبلوماسي، تصاعدت حرب الظلّ ففاقمت من تقويض القانون الدولي وأعراف عدم الانتشار. اغتالت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية علماءَ نوويين إيرانيين مبرّزين، ومنهم محسن فخري زاده، رأس البرنامج النووي الإيراني، في سنة 2020.
ومع اندلاع حرب السابع من أكتوبر سنة 2023، تضمّن ردّ إسرائيل على هجوم حماس استخدام القوة العسكرية لتسوية الملفات التي تقلقها إقليمياً بما في ذلك ملفّ البرنامج النووي الإيراني. لم يتوقف الردّ الإسرائيلي عند شنّ حربٍ شاملةٍ على غزة، بل طالَ حلفاءَ إيران في المنطقة. وجدت إيران نفسها أكثر عزلةً مع تعرّض محورها الإقليمي لهجماتٍ متواصلة. وبدأ القادة الإسرائيليون يتحدثون علناً عن عملٍ عسكريٍ ضدّ المنشآت النووية الإيرانية.
فبدأت الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو 2025 على المنشآت النووية الإيرانية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة. وأفضى الصراع الذي دام اثني عشر يوماً إلى تغيير المشهد النووي. استخدمت إسرائيل مئات الطائرات والمسيّرات الهجومية في العملية، مدعومةً بعناصر تعمل داخل إيران. وفي 22 يونيو، أمر الرئيس الأمريكي ترامب القاذفات الأمريكية من طراز "بي تو" بمهاجمة مواقع نوويةٍ إيرانيةٍ باستخدام أربع عشرة قنبلةً خارقةً للتحصينات تزن كلّ واحدةٍ منها ثلاثين ألف رطل. استهدفت هذه الهجمات منشآتٍ نوويةً رئيسةً في نطنز وفوردو وأصفهان.
فها نحن بدأنا نشهد بوادر تسابقٍ نوويٍ بين دول الإقليم بعد الهجمات الإسرائيلية الأمريكية. أعلنت السعودية أنها تعيد النظر في خياراتها النووية في ضوء المتغيرات التي طرأت على بيئة الأمن الإقليمي، ووقّعت اتفاقية دفاعٍ في سبتمبر 2025 مع باكستان. ولمّحت تركيا إلى أنها قد تحتاج لإعادة النظر في وضعها النووي.
وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها في موقعٍ لا تحسد عليه بعد هجمات يونيو 2025، الأمر الذي أبرز الانهيار الجذري لنظام المراقبة الدولي. فتدمير المنشآت النووية الإيرانية صعّب إجراء عمليات التفتيش التي شكّلت أساس نظام المراقبة الدولي. ومن دون الوصول إلى المواقع المدمرة، لم تتمكن الوكالة من التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية أو مراقبة جهود إعادة البناء. وهكذا غدت الوكالة التي نجحت في التحقق من التزام إيران بالاتفاق النووي سنة 2015 على مدى عامين، عاجزةً عن مراقبة تداعيات الانهيار العنيف لذلك الاتفاق. وقد أظهر ذلك أن العمل العسكري لا يدمّر البنى التحتية المادية وحسب، بل يدمّر أيضاً الأسس المؤسسية للحوكمة النووية الدولية.
ومع ادعاءات الإدارة الأمريكية بتدمير البرنامج الإيراني كاملاً، كشفت الهجمات عن القصور الجوهري للحلول العسكرية في مواجهة مشكلات الانتشار. فقد حذّر مسؤولو الوكالة الدولية من أن إيران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون أشهر". وقد أُسّست البنية التحتية النووية الإيرانية لتأخذ في الحسبان احتمال الهجوم عليها. إذ أقيمت المنشآت الرئيسية في عمق الأرض، وربما وُزعت المواد المهمة في مواقع سرّية. والأهم هو أن الهجمات لم تستطع القضاء على المعرفة النووية. فالعلماء الإيرانيون احتفظوا بخبراتهم، والقاعدة الصناعية في البلاد بقيت إلى حدٍّ كبيرٍ سليمة. ومع إمكانية تدمير المنشآت المادية، فإن المعرفة بكيفية إعادة بنائها تبقى قائمة. فالأسلحة النووية في جوهرها مسألةٌ معرفيةٌ علميةٌ، فمتى امتلكت دولةٌ ما المعرفةَ بصناعتها، لا يمكن للقصف أن يمحوَها.