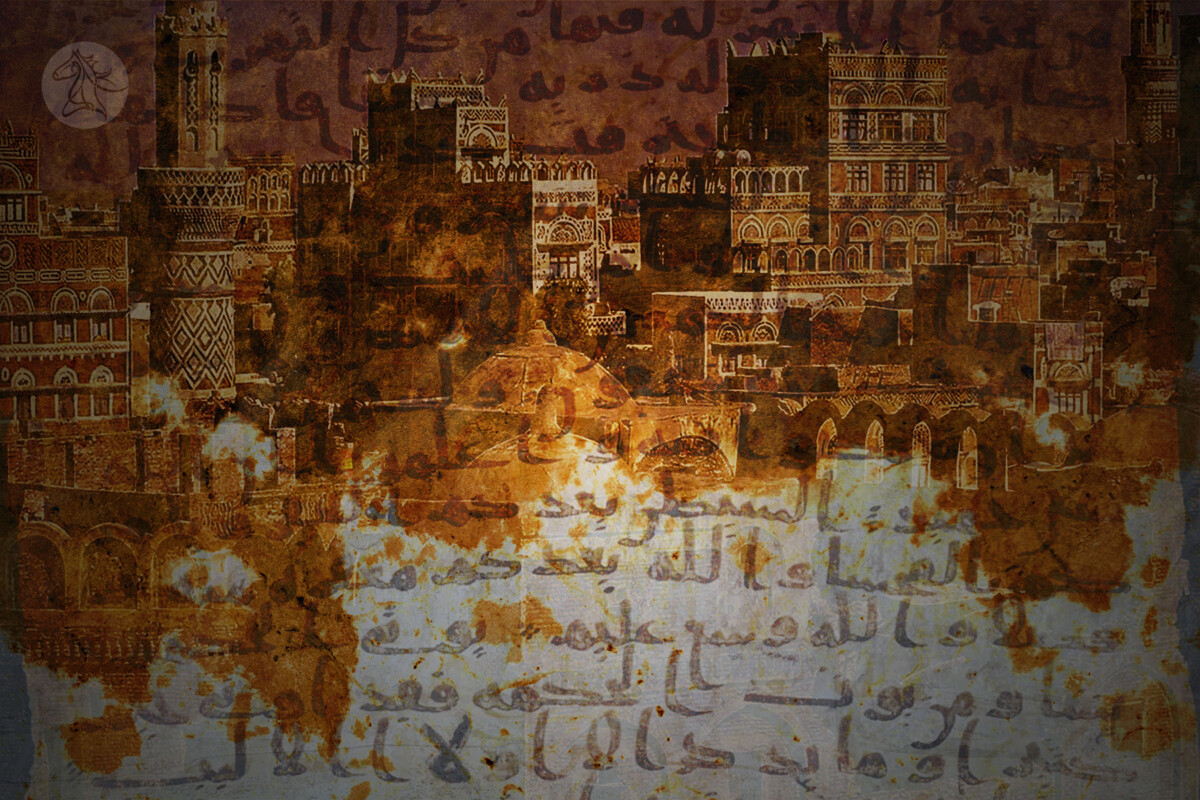كانت دعوى المقال أن هناك مخطوطاتٍ يرى مختصّون أن دراستها ستكشف عن كثيرٍ من زيف التاريخ الإسلامي عن القرآن وأصول الإسلام، وأن ثمّة مقاومةً من المسلمين لدراستها خوفاً من انكشاف السرّ الذي خفي قروناً. أطّر الكاتب مقالته بتصريحاتٍ لباحثين مهمّين في حقل الدراسات القرآنية الغربية، على رأسهم مدير المشروع، الباحث الألماني من جامعة سارلاند غيرد بوين. زعم بوين أن الطبقة السفلية من طرس صنعاء (والطِرْس ورقٌ كان يُخطّ عليه ثمّ يُمحى ليُكتب عليه مرّةً أخرى)، التي مُحيت لكتابة النصّ العثماني (رسم عثمان بن عفان) المعتمد على الطرس نفسه، تخفي تاريخَ تطوّرٍ قرآنيٍّ يريد المسلمون إخفاءه لادّعاءِ إلهية القرآن الذي بين أيديهم الآن وسلامته من العيوب.
شاعت هذه الأفكار المشكّكة في فتراتٍ تاريخيةٍ متنوعةٍ في أوساطٍ فكريةٍ مختلفةٍ غربيةٍ، وبين العامة والساسة والرحالة والتنويريين والمستشرقين. لذا فإن عودة هذه الفكرة للظهور في مقالة ليستر ليست غريبةً في ذاتها، وإنما تأتي غرابتها بعودتها للظهور على ألسنة بعض المتخصصين، أو اعتماداً على تصريحاتهم. كذلك فقد ظهرت بعد مرور أكثر من قرنٍ ونصفٍ من ترسّخ المعرفة الغربية النقدية عن القرآن والنصوص الحافّة به، بما تحمله هذه المعرفة من مناهج حديثةٍ متنوعةٍ ومتطورة.
وبما أن جزءاً من المعرفة يرتكز على محاولة فحص الظواهر وتخليصها من سحريتها وتفسيراتها غير المنضبطة، فإن التقدم المعرفي الذي شهدته دراسة الشرق منذ القرن التاسع عشر طالما فتح الباب للتساؤل عن مصير الأفكار النمطية المسبقة عنه، وعن كيفية استمرارها وانتشارها وإعادة تركيبها وإنتاجها. وعليه يُنظر إلى حدث اكتشاف مخطوطات صنعاء، الذي يراه بعض الدارسين أهمّ حدثٍ في تاريخ الدراسات القرآنية الغربية المعاصرة، مساحةً للتساؤل عن العلاقة بين تقدم المعرفة وبين الأفكار النمطية داخل نظامٍ فكريٍّ ومعرفيٍّ راسخٍ في تفسير الوقائع. ومساحةً للتساؤل عن قدرة المعرفة على تبديد هذه النمطيات والأوهام المسبقة. وكذلك قدرة التفكير المسبق على خنق التفكير العلمي، خصوصاً إذا تغلغلت هذه النقاشات في البنية المعرفية للباحثين والمؤسسات العلمية، وباتت جزءاً من النموذج المعرفي لعملهم وبه يفسّرون أصول النصّ القرآني والتاريخ الإسلامي المبكر.
وكما يبدو، فالتفريق بين "قرآن بين أيدينا" و"قرآن قديم ومحتجب"، والتفريق بين "إسلام مصنوع تاريخياً" عبر مدونات السيرة والتفسير و"إسلام حقيقي" نشأ في سياقاتٍ جغرافيةٍ وتاريخيةٍ مختلفةٍ، هو تصوّرٌ ظهر في الخمسين سنةً الأخيرة. ففي سنتَي 1974 و1977 على التوالي، ظهر كتابان مهمّان على ساحة الدرس الغربي للقرآن. الأول بالألمانية، ويمكن عنونته بالعربية "القرآن الأصلي: إعادة بناء التراتيل المسيحية في القرآن" للاهوتيّ الألماني غونتر لولينغ. أما الثاني، فكان بالإنجليزية، وعنوانه "كورانِك ستَديز" (الدراسات القرآنية) للأمريكي جون وانسبرو. ترتكز فكرة الكتابين على أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو "القرآن الأصلي".
افترَض وانسبرو –بتطبيق المناهج الأدبية الشكلية على القرآن وعلى مدونات السيرة والتفسير– أن القرآن الحالي نتاج عملية تحريرٍ شاملةٍ باشَرَها المفسرون والقرّاء في القرنين الثاني والثالث الهجريّين. وذلك في وسطٍ طائفيٍّ يجمع يهود ومسيحيين و"مسيحيين يهود" (يهود عرقياً تحولوا مذهبياً للمسيحية). كذلك افترض أن القرآن الأصلي لم يكن سوى مجموعةٍ من الأقوال أو البلاغات النبوية حُرّرت لاحقاً وزِيد عليها من النقاشات الدينية التي دارت حولها.
بدوره، زعم لولينغ أن القرآن مرّ بأربعة مراحل حتى وصل إلى هيئته الحالية. الأولى حين كان القرآن مجموعة تراتيلٍ مسيحيةٍ تتلوها طائفةٌ مسيحيةٌ داخل مكة. ثم المرحلة المحمدية التي أعادت صياغة هذه التراتيل. وفي المرحلة الثالثة وضع محمد إضافاته الدينية الخاصة لهذه التراتيل. أما في المرحلة الرابعة، بعد محمد، فقد حرّر المسلمون النصّ نهائياً ونتجَ عنه القرآن الذي نعرفه الآن.
وضع الكتابان مصداقية التراث الإسلامي في مهبّ الريح، وشكّلا بدايةَ منعطفٍ حاسمٍ داخل الدراسات القرآنية الغربية، وبدايةَ تشكيكٍ في تاريخ الإسلام المبكر كما ترويه المصادر الإسلامية وكما تقبّلته –ولو إجمالاً– الدراسات الغربية. مهّد هذا الطريق لفرضياتٍ جديدةٍ عن هذا التاريخ المحجوب، تبحث عن القرآن والإسلام الأصليَّيْن خارج هذه المصادر. أمّا الأمريكي المختصّ في الإسلام المبكر فرد دونر في دراسته "القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية"، المنشورة ضمن كتاب "القرآن في محيطه التاريخي" والمترجم للعربية سنة 2012، فيرى أن الأسئلة المركزية لحقل دراسات القرآن قد خُلخِلَت منذ هذه اللحظة. وقد نتجت عنها أسئلةٌ على غرار: من كاتب القرآن؟ ولِمَن كَتَبَه؟ وبأيّ لغةٍ كتبه؟ وكيف وصل هذا القرآن إلينا؟. يقول المستشرق الألماني شتيفان فيلد في محاضرته "تاريخ القرآن، لماذا لا تحرز تقدماً؟"، المترجمة سنة 2018 على موقع "تفسير"، إنه في ظلّ الفراغ الناتج من خلخلة الأسئلة ظهر كثيرٌ من الفرضيات الجدلية في أصل التاريخ الإسلامي وأصل القرآن.
مجموع هذه الفرضيات شكَّلت ما يُسمّى في الدراسات القرآنية الغربية "الاتجاه التنقيحي"، أو "اتجاه المراجعين". حاول روّاد هذا الاتجاه بناء فرضياتٍ جديدةٍ عن تاريخ القرآن والإسلام على أساس الدلائل التاريخية الملموسة وحدها من نقوشٍ وعملاتٍ ومخطوطاتٍ، بدلاً عن المصادر الإسلامية "المزيِّفة للتاريخ". منها فرضية "الهاجرية" للمؤرخَيْن الأمريكيَّيْن باتريشيا كرون ومايكل كوك، ومفادها أن الإسلام بدأ طائفةً يهوديةً مسيحانيةً في القرن السابع سُمّيَت بالهاجريين نسبةً إلى هاجر أمّ إسماعيل، ثمّ انفصلوا بهويةٍ مستقلةٍ وكتابٍ مقدسٍ مستقلٍ بعد قرنين. وكذلك فرضية المؤرخ البريطاني جيرالد هوتنغ حول نشأة الإسلام في وسطٍ كتابيٍّ وليس وسطاً وثنياً.
نشأ الإسلام وفقاً لهذه الفرضيات في الهلال الخصيب في وسطٍ يهوديٍّ ومسيحيٍّ يعجّ بالنقاشات الدينية، وحُجِب التاريخ الحقيقي له وراء ستارٍ إيمانيٍّ مزوَّر. يبرز هذا "الحجب" في نصّ القرآن والرواية التقليدية عنه، ومدونات السيرة والحديث، التي ترسم صورةً عن إسلامٍ نشأ في وسطٍ مكّيٍّ وثنيٍّ في القرن السابع الميلادي.
يظهر أكبر تجلٍّ لفكرة "القرآن المحجوب" في كتاب "ذا سيرو-آراميك ريدنغ أوف ذه كوران" (قراءة سريانية آرامية للقرآن)، المنشور سنة 2000 للألماني كريستوف لكسنبرغ، وهو اسمٌ مستعارٌ لكاتب. يتناول الكتاب ما يَعُدّه أصل القرآن السرياني، مفترضاً أن القرآن الحاليّ ليس نصّاً أصلياً وما هو إلّا حجابٌ لنصٍّ تعبّديٍّ سابقٍ مكتوبٍ بلغةٍ ممزوجةٍ من السريانية والعربية. نقّح المسلمون هذا النصّ لاحقاً وأعادوا شكله وضبطه على قواعد العربية المستحدَثة، فغاب كثيرٌ من ملامحه المركزية وتغيّر كثيرٌ من ألفاظه وتراكيبه.
تضيف فكرة لكسنبرغ طبقةً أخرى على طبقات غياب حقيقة نصّ المسلمين المقدس. إذ لا يصبح القرآن نصّاً ناتجاً عن تزويرٍ أو عن عمليةٍ واعيةٍ لبناء سردية خلاصٍ، كما الحال مع وانسبرو وكرون وهوتنغ، وإنما نصّاً ناتجاً عن خطأٍ وجهل. يُضاف لهذا الطرح فكرة "الشرق الحاجب لذاته". يتبيّن هذا في عنوان الكتاب الفرعي "مساهمة في فكّ شفرة القرآن"، إذ يُظهر الكاتب نفسَه القادرَ على فكّ الشفرة ونزع الحجاب. لا من أجل فهمٍ غربيٍّ جديدٍ للإسلام، بل من أجل تفهيم الإسلام الحقيقي للمسلم نفسه.
حلمُ بناء نسخةٍ نقديةٍ من القرآن هو حلمٌ استشراقيٌّ تقليديٌّ حاوله الدارسون في مرحلة نضج الحقل في القرن التاسع عشر. وبرز من هؤلاء الدارسين الألماني غوستاف فلوغل، صاحب أوّل معجمٍ لألفاظ القرآن وأوّل مصحفٍ غربيٍّ مطبوعٍ (نسخةً نقدية). هذا الحلم سببه علميٌّ. فالدراسة العلمية للكتب المقدسة تتطلب تجاوز النسخة المعتمدة (أي مصحف القاهرة) إلى نسخةٍ نقديةٍ تعتمد نصوصاً سبقت النسخة المعتمدة. ذلك يعني نسخةً تتأسّس على نصوصٍ ومخطوطاتٍ، وليس على رواياتٍ وأخبارٍ. وهو الأمر الذي لم يتوفّر في حالة دراسة الإسلام والقرآن بسبب قلّة المخطوطات المتاحة للدارسين.
هذا الحلم لم يتحقق. فقد تراجع الاهتمام بمصحف فلوغل نفسه بسبب ظهور مصحف القاهرة المطبوع سنة 1924، الذي يُعَدّ ثاني المصاحف الإسلامية المطبوعة بعد المصحف العثماني المطبوع سنة 1874 والذي حظي بتقدير مستشرقين كُثرٍ، منهم الألماني إغناتس غولدتسيهر الذي كتب تقريراً مادحاً له. وهذا وفق ما يخبرنا الباحث الأردني من جامعة برلين الحرّة، إسلام داية، في دراسته "طباعة المصحف بين فيلولوجيا المستشرقين وعلم القراءات" المنشورة سنة 2014. انضباط عمل اللجنة ووضوحه جعل مصحف القاهرة أساساً جيداً لعمل الدارسين إلى اليوم، على كونه نسخةً غير نقديةٍ ترتكز على قراءةٍ واحدةٍ ونظام أوقافٍ بعينه ونظام عدٍّ محدّد.
حاول الألماني غوتهلف برغشتراسر استعادة هذا الحلم بنسخةٍ نقديةٍ مرّةً أخرى بمجموعة مخطوطاتٍ صُوِّرت في ثلاثينيات القرن الماضي. وتنوعت مصادر المخطوطات ما بين أسفارٍ حصل عليها المستشرقون في جولاتهم بالمشرق أو مواد نَقَلَها الاستعمار لأوروبا، مثل مخطوطات المصحف المحفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس. لكن المشروع توقّف بسبب ما أشيع من فقدان الصور جرّاء القصف في الحرب العالمية الثانية. إلّا أن فرِد دونر في دراسته "تأملات في تاريخ الدراسة الغربية وتطورها"، المنشورة ضمن كتاب "ترندز أند إيشوز إن كورانِك ستَديز" (اتجاهات وقضايا في الدراسات القرآنية) الصادر سنة 2019، يخبرنا أن المخطوطات لم يمسسها سوء. فقد أعلن أنطون شبيتلر، تلميذ برغشتراسر وصاحب الاهتمام بالقراءات، احتفاظه بها على مدى خمسين عاماً.
ومن هنا مع اكتشاف مخطوطات صنعاء، لاح حلم الوصول لنسخةٍ نقديةٍ عن القرآن مرّةً أخرى. إلّا أن ظهوره في سياق الادعاءات التنقيحية عن تزوير التاريخ الإسلامي حفّز حلماً آخَر، هو اكتشاف ماضي ما يمكن تسميته "الإسلام المحتجب أو الخفيّ" تحت طبقات نصّ القرآن المعتمد والمرويات التراثية. حرّر غيرد بوين كتاباً مع كارل أوليغ سنة 2005 حملت ترجمته الإنجليزية سنة 2010 هذا العنوان بالفعل: "هيدِن أوريجنز أوف إسلام" (أصول الإسلام الخفيّة). ضمّ الكتاب عدداً من الدراسات تقوم على التخرُّص بنتائج مخطوطات صنعاء إلى جانب تحليلاتٍ لدلائل تاريخيةٍ، مثل العملات الأموية ونقوش قبّة الصخرة.
وفي مقالته "ما القرآن"، يستعين توبي ليستر بتحليلات –أو قُل تخمينات– غيرد بوين لمخطوطات صنعاء، ولم تكن حينها قد خضعت لدراسةٍ موسَّعةٍ بعد. يعلن بوين أن مخطوطات صنعاء ستكشف عن ما لا يريد المسلمون لأحدٍ معرفته، أي هذا الإسلام المحتجب خلف نسخة القرآن المزيَّفة والمزيِّفة والكامن في النسخة الممحوّة من طرس صنعاء. لذا يفسر بوين تأخّر دراسة المخطوطات بتعنّت الجانب اليمنيّ في إتاحتها.
لعلّ أبرز الدراسات في هذا الاتجاه ما طرحه أستاذا الدراسات الدينية بهنام صادقي ومحسن جودارزي بعنوان "طرس صنعاء 1 وأصول القرآن" سنة 2012، ودراسة بهنام صادقي وأوري بيرغمان "موازنة بين مصحف عثمان وإحدى مخطوطات صنعاء" سنة 2010، وتُرجمت الدراستان للعربية على موقع "تفسير" سنة 2022. قدمت الدراستان تحليلاً مفصلاً لجزءٍ كبيرٍ من مخطوطات الطرس. وعقدتا أيضاً مقارنةً بين النصَّيْن العلويّ والسفليّ الممحوّ في الرقّ، وبين هذين النصَّيْن وبين المصحف العثماني المعتمد، وبينه وبين بعض مصاحف الصحابة كما تروي عنها الأخبار وكما يمكن استشفافه من مخطوطاتٍ مبكرةٍ أخرى. وحاولت الدراستان، باستخدام الأدوات المعاصرة في التأريخ بالكربون المشعّ وبالاستفادة من تاريخ تدوين النصوص المهمة في مختلف الحضارات، بناء شجرةٍ نصّيةٍ لتاريخ انتقال القرآن.
افترضت الدراستان أكثر من مسارٍ لانتقال القرآن، بدايةً من القرآن الذي تلاه النبيّ محمد على أصحابه وصولاً إلى نسخة عثمان. وبالتحليل النصّي، رأى صادقي وبيرغمان أن إمامية مصحف عثمان تأتي من كونها أقرب نسخةٍ للنسخة النبوية المفترضة. لا تصبح الطبقة العلوية من طرس صنعاء بهذا تعميةً أو حجاباً يخفي نسخةً سابقةً أصليةً مُحِيَت لإزالة آثار سرٍّ قديمٍ، بل تصحيحاً قائماً على مبادئ معرفيةٍ يمكن مقارنتها بمبادئ الحضارات الأخرى في حفظ نصوصها ونقلها.
كذلك فتحت مخطوطات صنعاء باباً كبيراً لدراسة طرق نقل النصّ بين الشفاهة والكتابة، وبالتالي مهّدت طريقاً لفهم تطوّر المعرفة الإسلامية. ولعلّ أبرز الكتابات في هذا السياق التي ترجمها موقع "تفسير" سنة 2023 هي للهولندي ماراين فان بوتين تحت عنوان "خواصّ الرسم المشتركة في مخطوطات القرآن المبكرة"، والمصري هيثم صدقي بمقالٍ عنوانه "اختلاف مصاحف الأمصار". يدور النقاش في هذه الدراسات على طبيعة عملية نقل القرآن، وفيما إذا كان النقل شفاهةً أو اعتمد تدوين القرآن في عهد الخليفة الثالث على نسخةٍ مكتوبةٍ، أم وُجد المساران معاً. وكيف نشأت القراءات وتنوّعت في ظلّ هذا. وكذلك كيف تحوّلت القراءة الشفهية علماً وكيف تطوّر الخطّ وعملية الكتابة ذاتها، والتدوين للعلوم عموماً. بهذا حفّزت مخطوطات صنعاء طرح أسئلةٍ حول عملية التدوين الإسلامي للعلوم والمعارف عموماً. وهذا بفحص علاقة المخطوطات بواقع المرويات الإسلامية الشفهية، وكذلك بفحص نموذج التدوين نفسه.
وعلى هذا الدرب، قدّم مايكل كوك –وهو صاحب التشكيك الكبير في صلاحية التراث الإسلامي ومصداقيته– دراسةً صغيرةً عن "مصاحف الأمصار" تُرجمت على موقع "تفسير" سنة 2022. قارن كوك في دراسته بين نتائج دراسة المخطوطات وبين المرويات في كتب المحدّث وعالم القراءات الأندلسي أبو عمروٍ الدانيّ الذي توفي سنة 1053. انتهى كوك إلى الاقتناع بدقّة التأريخ الإسلامي لمخطوطات صنعاء. وهو الأمر نفسه الذي توصّل إليه بدراسة مصحف ابن أبي عامر، جدّ الإمام مالك بن أنس، في بحثٍ آخَر. أمّا السويسري غريغور شولر، الدارس المبرّز في تاريخ الشفاهة والكتابة، فقد حاول تقديمَ مخطوطات صنعاء دليلاً على معقولية الرواية الإسلامية عن تاريخ القرآن والإسلام المبكر، في انتقالها من الشفاهة للتدوين وإخلاصها للحدث التاريخي.
يظلّ الاختلاف حتى الآن في طبيعة الطبقة السفلية الممحوّة من طرس صنعاء. ولكن الباحثة التونسية أسماء هلالي ترى في كتابها "ذه سانا بالِمْبسيست" (طرس صنعاء)، الصادر بالإنجليزية سنة 2014، أن هذه الطبقة نتيجة عملية تدريبٍ أو مصحفٍ شخصيّ.
المتفق عليه في هذه الدراسات بالمحصلة أن لا سرَّ محجوبٌ تحت الطبقة العليا الموافقة للرسم العثماني المعتمد. وهذا ما يفصح عن كونِ فكرة القرآن الأصليّ والإسلام المحتجب وزيف المعارف الإسلامية مجرّدَ أفكارٍ قائمةٍ في ذهن بعض الدارسين. ويخبرنا الباحث الأمريكي من جامعة جورج واشنطن جوزيف لمبارد، في دراسته "تفكيك استعمارية الدراسات القرآنية" المترجمة سنة 2018، أن حقل الدراسات القرآنية الغربي ورث كثيراً من أفكاره متأثراً بالسياق الاستشراقي الذي تطوّر داخله وبلغ في ظلِّه مرحلة النضج. فقد قسّم الاستشراق العالَمَ معرفياً وحصر المعرفة الموثوقة على العالم الغربي وحده. هذا ما جعل الدراسة الغربية مرتابةً بدرجاتٍ تجاه المعارف غير الغربية عموماً. ويرى لمبارد أن هذه الأفكار المسبقة (النمطية) تحتاج إلى تفكيكٍ لأنها تعيق الوصول لرؤيةٍ أكثر منطقيةً وواقعيةً للتاريخ الإسلامي. ناهيك عن أنها تعيق الوصول لفهمٍ واستفادةٍ مثلى من تراث المسلمين المعرفي الطويل.
أدّى هذا النفي المسبق للمعارف غير الغربية أو "الاستعمار المعرفي"، كما يصفه جوزيف لمبارد أستاذ الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالشارقة، إلى تموضع المسلم الحديث دوماً في خانة المدروس لا الدارس. حالةٌ واحدةٌ تسمح لهذا الدارس بالانخراط في العلم الحديث للقرآن والتاريخ الإسلامي، ألا وهي أن يتخلّى عن تراثه المعرفي ويتقبل التشكيك المسبق في صلاحيته ومصداقيته ويستبدل به المنهجيات الحديثة وحدها. وهكذا ليبدأ النظر في القرآن متجرّداً من كلّ تراثٍ معرفيٍّ ناشيءٍ حوله. ويرى لمبارد أن الطريق للاستفادة المتبادلة بين الدارسين الغربيين غير المسلمين والمسلمين يبدأ من تخلّي الحضارة الغربية عن وهم كونها العارفة الوحيدة أو الذات الوحيدة في عالمٍ متكاملٍ من موضوعات الدراسة. ويرى أن تبنيَ الحضارة الغربية ضمن معارفها منظوراً متعدداً يعطي لكلّ الأصوات الصلاحيةَ والاعتبار.
في هذا السياق تصبح الدراسات الغربية للقرآن ميداناً حديثاً لا يعارض الانفتاح على المعارف الإسلامية التراثية، بل يتحرك لإغنائها وللاغتناء بها. ولعلّ قصة دراسة مخطوطات صنعاء تقدّم دليلاً على هذا. فَبِترك ادعاءات غرق التاريخ الإسلامي في التخفّي والاحتجاب، ومع الالتفات للتراث المعرفي للمسلمين للاستفادة منه، تبدأ صورة التاريخ الفعلية تزداد وضوحاً.