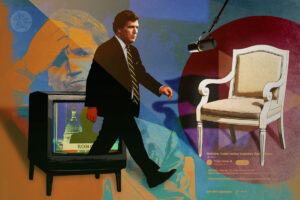لم أعرف حينها ما حدث حتى بدأت الأخبار بالتسرّب من الهواتفِ وأفواهِ المذعورين. الانفجارُ وقع في العنبر الثاني عشر داخل مرفأ بيروت، أكبر موانئ لبنان. فقد خُزنت في العنبر نحو 2750 طناً من "نتراتِ الأمونيومِ"، وهي مواد كيميائية شديدة الانفجار، ستَّ سنوات ونيف بلا إجراءاتِ سلامةٍ. اشتعلت النيران أولاً في مستودعٍ قريبٍ ثم وصلت إلى نترات الأمونيوم محدثةً واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. عادلت قوة الانفجارِ هزّةً أرضيّةً بلغت 3.3 درجاتٍ على مقياسِ ريختر، وشعر به الناس حتى في جزيرةِ قبرصَ، على بُعد أكثر من مئتي كيلومترٍ. وما إن خمد الغبار حتى بدأت الحصيلة تتضح، ما لا يقل عن 236 قتيلاً ونحو سبعة آلاف جريحٍ وثلاثمئة ألف مشرّدٍ بين ليلةٍ وضحاها. أحياء كاملةٌ في الجميزةِ ومار مخايلَ والكرنتينا وهي المناطق الأقرب إلى الانفجار تحوّلت إلى أنقاض، والمستشفيات المدمَّرة كانت تعالج المصابين في الممراتِ وعلى الأرصفة.
ترك الانفجارُ آثارَه النفسية والاجتماعية والاقتصادية على اللبنانييِّن مقيمين ومغتربين. لكن وقعه الممتد تجاوز الأثر الآني والمادي في بلد يعاني طبقاتٍ متراكمة من المشكلات، ليترجَم الألمُ لاحقاً في الفن بأشكاله المتعددة. تفاعلت روايةُ "غيبة مي" لنجوى بركات ومسرحُ "حديقة غودو" لأدهم الدمشقي وفيلم "شظايا مدينة" لكارول منصور مع آثار انفجار المرفأ خارج حدود التنظير وأسئلة السياسة والاقتصاد. فقد وجد الفنّانون اللبنانيون أنفسَهم أمام سؤال الذاكرة وغياب العدالة، وبهذه المنتوجات الفنية سعوا لتحويل الصدمة إلى مقاومةٍ وتوثيقٍ جماعي، مساحةً للنجاة من الإنكار السياسي وعلاجاً يخفف وطأة الوجع العام.
هذا ما بينته بعض الدراسات، ومنها دراسة بعنوان "تحقيق نوعي في تجربة طلاب الجامعات مع انفجار مرفأ بيروت" لعدد من الباحثين من الجامعة الأمريكية في بيروت نشرت سنة 2023. تناولت الدراسة تجربة طلاب الجامعات بعد انفجار الرابع من آب (أغسطس)، كما يطلق عليه اللبنانيون، واعتمدت على استبانة الكترونية شملت 1044 مشاركاً. خلص التحليل إلى أربعة محاور رئيسة، اضطراب عاطفي شديد وإدراك هشاشة الحياة ومحاولات للتكيف وتجاوز المحن وتغيير النظرة إلى الحياة والقيم الشخصية. في مخرجها العام، بينت الدراسة تراجعاً في الثقة بالنظام القضائي، وتفضيلَ الهجرة على المطالبة بالعدالة. كذلك بينت الدراسةُ دورَ الدعم الاجتماعي للأصدقاء والزملاء في التخفيف من التوتر النفسي.
عمرانياً واقتصادياً، أظهرت دراسة أجرتها ندين هندي بعنوان "مدينة مرفئية متوسطية في أزمة: حالة بيروت" نشرت سنة 2025، أن الانفجار دمّر البنية التحتية للمرفأ وقلّص قدراته التشغيلية، وأعاد طرح نقاش عن هوية بيروت مركزاً مرفئياً في شرق المتوسط. أبرزت الدراسة كذلك أن المرفأ كان حلقة وصل مهمة في التجارة الإقليمية، وأن تطوره ارتبط بالصراعات التاريخية والخصوصيات الجغرافية والسياسية للمدينة ما جعله عرضة للاهتزاز عند كل أزمة.
عند الجمع بين نتائج الدراستين، لم يكن الانفجار حادثاً مادياً فحسب، بل تجربة مركبة أعادت تشكيل الوعي الفردي والجماعي وغيّرت هوية المدينة ووظيفتها الاقتصادية. فمن جهة، كشف الجانبُ النفسي عمقَ الصدمة التي عاشها الأفراد. وأظهر الجانب العمراني، من جهة أخرى، كيف أعاد الانفجار رسم صورة المرفأ وعلاقته بالشبكات الاقتصادية العالمية. فبرز المرفأ رمزاً مزدوجاً للجرح المادي والمعنوي الذي أصاب بيروت وسكانها.
لم يعد ممكناً بعد الانفجار الاكتفاء بتحليلات الآثار النفسية والأبعاد السياسية أو الاقتصادية. فقد تجاوز ما حدث قدرة الخطاب اليومي على الاستيعاب، وصار بحاجة إلى أشكال أعمق من التعبير، لغةٍ تمنح الفاجعة بعداً إنسانياً يتجاوز اللحظة. إنها الفجوة التي حاول الفن جسرها.
صار المرفأ في عيون كثير من الفنانين والكتّاب والمسرحيين رمزاً للانفجار الداخلي في الذاكرة والهوية، وصار تمثيل الكارثة الفني وسيلة مداواة ما عجزت السياسة عن مداواته. ولا عجب، فالفن وسيلة علاجية فعّالة في مواجهة آثار الصدمة النفسية. يؤيد ذلك دراسة بعنوان "هاو كان آرت ثريبي هيلب ويذ تروما" (كيف للعلاج بالفن أن يساعد بالتعافي من الصدمة) صدرت سنة 2020، للكاتبة زوري وايت-غيبسون. جاء فيها أن الفن يتيح للفرد التعبير عن مشاعره وتجاربِه العميقة بطريقة آمنة وغير لفظية، ما يساعده على استعادة توازنه النفسي وتعزيز قدرته على التكيّف وبناء صورة أفضل عن الذات والعالم من حوله.
بهذا المعنى حاول فنانون لبنانيون أن يلتقطوا الحدث في النص الروائي وعلى خشبة المسرح وبالصورة السينمائية. وفي مواجهة الانفجار لم تعد هذه الفنون مجرد أدوات تعبير، بل محاولات متوازية لتأريخ المأساة وصياغة معنى لما بدا منذ البداية عصياً على التمثيل، بدءاً من الرواية.
في هذا السياق، تشكِّل رواية "غيبة مي" لنجوى بركات الصادرة سنة 2025 علامة فارقة، لأنها تنقل الرواية من فضاء الحرب الأهلية إلى فضاء كارثة الانفجار، من زمن الجبهات والمعارك إلى لحظة الانفجار المباغت في الرابع من أغسطس سنة 2020. نجوى بركات التي سبق لها أن كتبت عن ذاكرة الحرب في روايات سابقة، تضيف في هذا النص بعداً مختلفاً. إذ بينما كانت الحرب، رغم فظاعتها، تحمل منطقاً أو معنى ضمن سياقها السياسي والطائفي، فإن انفجار المرفأ يدخل حياة الناس بلا مقدمات أو معنى.
تسرد "غيبة مي" حكاية امرأة ثمانينية تقطن في شقة تطل شرفتها في الطابق التاسع على مدينة بيروت. يعيش أبناؤها في الخارج، فيما تغيب هي في فخاخ الذاكرة مراقبةً بيروتَ ونفسَها بين اليوم والأمس. يتحوّل الغياب إلى استعارة كبرى للحياة في لبنان ما بعد انفجار المرفأ. ولمواجهة هذا الغياب - في وقت تتلكأ فيه الدولة في التحقيق وتعمل آلياتها على طمس المسؤوليات - تعيد الرواية كتابة الحدث من الداخل عبر اللغة والعاطفة.
بهذا يمكن النظر إلى "غيبة مي" محاولةً للنظر إلى انفجار المرفأ فيما وراء ما تستطيع السياسة أو الإعلام استيعابه، التجربة الداخلية للفقد والغياب شرطاً وجودياً. وهو الشرط الذي يراه الروائي الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا، في كتابه "فن الرواية" المترجم إلى العربية سنة 1990، جوهرياً في الفن الروائي وأساساً في بنيته الأخلاقية. يقول كونديرا إنّ "الرواية التي لا تكتشف جزءاً من الوجود ما يزال مجهولاً هي رواية لا أخلاقية، فالمعرفة هي الأخلاقية الوحيدة للرواية".
وعن تجاوز السياسة والإعلام في رصد الحدث، تكتب نجوى بركات: "في البداية، قاومتُ فكرة النزول إلى المرفأ لمعاينة حجم الدمار كما فعل كثرٌ بعد كُمون الصدمة الأولى [. . .] زحفوا من كافَّة المحافظات للتعرُّف على جثَّة عاصمتهم، أو لوداعها في نظرةٍ أخيرة. نقلت لنا الشاشات عيوناً دامعة، وأفواهاً مزبدة، ونظراتٍ كسيرة، وظهوراً محنيَّة، ورأينا من جاء بدافع الفرجة فراح يتصوَّر ويتصاور، مصرّاً على حفظ اللحظة أمام روعة المشهد المريع [. . .]".
تتوغل نجوى أكثر في المشهد، فتقول: "[. . .] كنَّا في شهر آب اللهَّاب، عندما تهافت مئات الشابَّات والشبَّان، رافعين مكانسهم وكأنّها راياتٌ في جوِّ احتفاليِّ جنائزيّ، يكنسون الطرقات من أرتال الزجاج والردم، ومن كثير فجيعتهم وحزنهم على ضياع عاصمتهم بسبب الفساد والإهمال [. . .]".
وتضيف أن المكنسة صارت في أيديهم شعار المرحلة، "وبات كنس الكلِّ مطلوباً، لا بل ضرورةً للاستمرار في العيش، فنحن مواطنون يتامى، لا دولة تهتمُّ بنا ولا مؤسَّسات".
يذكّرنا كونديرا في كتابه بأن أحد أسباب وجود الرواية هو أن تحمي الإنسان من "نسيان الكائن"، أي نسيان الإنسان ذاته. وبنمط مشابه يقاوم نص نجوى بركات نسيان الرابع من أغسطس عبر تحويله إلى أرشيف مضاد يحمي الذاكرة من السقوط في صمت السلطة والنسيان الجماعي. ويضيف كونديرا أنّ "روح الرواية هي روح التعدد، فهي تقول للقارئ إن الأشياء أكثر تعقيداً مما تظن". وهو ما يمنح "غيبة مي" فرادتها، فالغياب لا يفسّر حصراً فقدان فرد، بل يتسع ليشمل غياب المدينة عن نفسها وغياب العدالة وغياب الأمان في شبكة من الدلالات التي ترفض أي تبسيط أو إجابة جاهزة.
في حديثها مع الفراتْس، تتوقَّف نجوى بركات عند هذه النقطة لتوضح أن الكتابة عن الانفجار لم تكن خياراً واعياً بقدر ما كانت ضرورة وجودية لمواجهة ما تصفه باسم "الامتحان والمحنة". تقول إنها ما زالت حتى اليوم تكتشف مدى عمق الأثر الذي تركه ذلك اليوم فيها وفي اللبنانيين جميعاً. وتشير إلى أنها شعرت منذ زمن بأن البلاد تتجه إلى الهاوية، وأن ما حدث يوم انفجار المرفأ لم يكن سوى لحظة تجلٍّ نهائي أو انحدار طويل. تقول: "كان لدي حدس أن الأمور تتجه نزولاً، وأن طريق الجلجلة وهذه الهاوية السحيقة التي كنا نتدحرج عليها لا يبدو أن لديها قاعاً أو نهاية". لهذا تربط بركات بين "غيبة مي" وروايتها السابقة "مستر نون" الصادرة سنة 2019، التي رأت فيها ملامح لما سيحدث لاحقاً. تقول: "في 'مستر نون' البطل يعاني من آثار الحرب، واصفاً المدينة وكأنها على حافة انفجار. الرواية صدرت قبل سنة من الانفجار، وكأنني كنت أصف المدينة قبل لحظة الكارثة بقليل".
وتشرح الكاتبة أن "الرواية لم تكن محاولة لتوثيق الانفجار بقدر ما كانت سعياً إلى فهم أثره الروحي والنفسي، سواء على الفرد أو على الجماعة". وتصف ما حدث بأنه خراب روحي ونفسي لا يحتمله العقل البشري، "شيء يفوق أي تصور وأي مخيلة في أكثر لحظاتها تشاؤماً ويأساً من المستقبل". من هنا، ترى أن الأدب قادر على تحويل التجربة الشخصية إلى ذاكرة جمعية، لأن العالم بأسره "تحسّس إزاء هذا الانفجار وتعاطف مع اللبنانيين، لأنها فعلاً لحظة تراجيدية تخطت ما يمكن للخيال أن يتوقعه من سيء".
تستعيد الكاتبة نجوى بركات مشهداً محورياً من الرواية حين تنزل البطلة مي إلى مكان الانفجار مع ناطور البناية السوري. في رأيها، هذا المشهد يختصر مأساة إنسانية تتجاوز الحدود: "يجلسان معاً على الركام عند مغيب الشمس فيشعران بنوع من التآخي، ليس فقط في مأساتهما سوريين ولبنانيين، بل بشراً أمام انحدارٍ وخسارة حلم يطال الإنسانية كلها". لهذا تضيف أن انفجار بيروت لم يكن حدثاً منفصلاً، بل فتح سلسلة من الانفجارات، مثل تدمير غزة وحرب سوريا، "كلها سلسلة مترابطة من المأساة. نحن شعوب تُباد، وهذا واقع لا يمكن تغافله".
في نهاية حديثها مع الفراتْس، تعود نجوى بركات إلى جوهر الكتابة نفسه، مؤكدة أن الأدب ليس ترفاً ولا وسيلة علاج، بل ضرورة روحية. تقول: "عندما نكتب لا يمكن تحاشي هذه الصورة التراجيدية ، أو أن تكون غائبة في كتابتك". فالرواية، كما تراها، "مقاومة للنسيان ورفضٌ للصمت، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن عبرها تحويل الألم إلى فعل إبداعي يمنح الذاكرة حياة أخرى".
مقاومة النسيان التي تحدّثت عنها نجوى ليست حكراً على الرواية، فهي فعل وجد مكانه أيضاً على خشبة المسرح، التي كان لها نصيبٌ من محاولات مداواة الصدمة.
في هذا السياق تبرز تجربة أدهم الدمشقي في "حديقة غودو" إحدى أكثر التجارب تعبيراً عن العلاقة بين الفن والصدمة، بين الألم الفردي والتشافي الجماعي. تبدأ المسرحية بانفصال عاشقين جمعتهما علاقة سامة. وبعد الانفصال، تبقى البطلة "ضنا" في الحديقة بانتظار الكلب "غودو"، الذي يأتي بعد مغادرتها بأسبوعين.
ينطلق الدمشقي في مسرحيته من تجربة شخصية عاشها في انفجار المرفأ. في تلك اللحظة، كما يروي في حديثه مع الفراتْس، كان برفقة كلبه غودو قرب مستشفى الروم، أحد أبرز مستشفيات العاصمة القريبة جداً من موقع الكارثة. عند وقوع الانفجار هرب الكلب وظنّ أدهمُ أنه فقده إلى الأبد. ركض الدمشقي في شوارع المدينة المدمّرة يبحث عنه وسط الركام والدخان والدم، قبل أن يجده عند عودته إلى المنزل ينتظره في الحديقة.
يقول الدمشقي: "كانت تلك أقرب لحظة شعرت فيها بالأمان، أمان لم توفّره لي دولتي، بل وفره لي كلبي". فقرّر أن يطلق على منزله اسم حديقة غودو، ليصبح المكان لاحقاً "وطناً بديلاً ومساحة ثقافية آمنة احتضنتني حين خذلتني كل الانتماءات الأخرى".
بعد الانفجار دخل الدمشقي في حالة أعراض ما بعد الصدمة، وبدأ رحلة تشافٍ عبر الفن مستخدماً الرسم والكتابة وسيلتين علاجيتين وتعبيريتين في آنٍ. يقول: "بدأت أرسم وأكتب بالتوازي، وكأن كل وسيلة منهما تكمل الأخرى. لم يكن الأمر مشروعاً فنياً مخطّطاً، بل استجابة تلقائية لحاجة داخلية في مواجهة الألم". ومن هذا التفاعل بين اللون والكلمة وُلد معرضه الأول "عنبر"، في إشارة مزدوجة إلى العنبر اثني عشر الذي انفجر، وإلى العنبر البحري المستخرج من أمعاء حوت العنبر الذي لا تُطلق رائحته إلا إذا احترق.
يقول المسرحيّ: "كان المعرض بمثابة فعل مقاومة ثقافي، إذ تحوّل الحدث إلى مهرجان عفوي، ومنذ ذلك اليوم أصبح بيتي مركزاً ثقافياً سنوياً تحت اسم مهرجان عنبر وحديقة غودو، يجمع الفنون والناس تحت سقف واحد". من هناك انطلقت التجربة نحو المسرح ليقدّم عملاً يحمل العنوان نفسه على خشبة مسرح مونو في بيروت، بمشاركة كلبه غودو إلى جانبه على المنصة. فأصبح العمل المسرحي امتداداً لتجربة التشافي الشخصية، وشهادة حيّة تنقل الشفاء من البعد الفردي إلى البعد الجماعي.
في المسرح جمع الدمشقي بين النصوص التي كتبها والرسومات التي أنجزها، فكانت النتيجة عملاً هجيناً يجمع بين الفنون الأدائية والبصرية، بين الاعتراف الذاتي والتعبير الجماعي. يقول: "المسرح بالنسبة لي يجمع النص واللوحة والحضور الجسدي الحيّ، وجدت فيه وسيلة لكل هذه الوسائط، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بلغته الخاصة واستقلاليته فناً".
أثناء العرض يصرخ الدمشقي في مشهدية تعكس لحظة الانفجار: "تخيلوا أن الكلب أشعرني بالأمان، وهو ما لا تستطيع دولتي أن تفعله، حديقة غودو هي وطني البديل وخارجها لا شيء يعنيني. نموت من انفجار أو من هزة أرضية أو بسبب كورونا، لا شيء يعنيني، أريد أن أضع رأسي بين كفيّ وأبكي [. . .]".
لكن التجربة لا تقف عند حدود الفن وسيلةَ علاج، بل تتجاوزها إلى الفن فعلاً وجودياً. يوضح الدمشقي للفراتس: "أؤمن أن الفن لا يُمارَس ليثير الشفقة أو الاستعراض العاطفي، بل ليخلق تعاطفاً واعياً، ويطرح أسئلة عميقة تقود إلى التصالح مع الذات والمجتمع".
ومن ضمن هذا التصالح مع الذات يبرز الإقرار بالواقع، لذا يشبه الدمشقيُ بيروتَ بـحبيبٍ نرجسي وما يحمله ذلك من علاقة جاذبية وأذى في آن. يقول "بيروت بالنسبة لي ليست مجرد مدينة [. . .] أشبّهها بحبيب يعرف تماماً كيف يُغوينا، كيف يجذبنا إليه بقوة، ثم يُحطّمنا، ليعود ويستدرجنا من جديد". ويضيف: "حين شاركت هذه المقاربة مع الجمهور، لاحظت أنهم تفاعلوا معها بعمق، وكأنهم جميعاً يشاركونني هذا الحبيب. في الحقيقة، كلّنا عشّاق هذا الكائن الغامض والمربك الذي يُدعى بيروت. مدينة تمارس سحرها علينا رغم كل الجراح، ولا نملك إلا أن نحبّها ونعود إليها، رغم الألم والانكسار".
من تجربته يثبت أدهم الدمشقي أن المسرح في لبنان لا يزال قادراً على أن يكون مرآة للذات وللمجتمع، وأن يحوّل الركام إلى خشبة والفقد إلى طاقة خلاقة والفن إلى شكل من أشكال النجاة الممكنة. تنطبق هذه الحالة الفنية أيضاً على السينما، وجهاً آخرَ لمحاولة الصمود في عين الذاكرة المشظّاة.
الفيلم الذي أنجزته كارول منصور بعد شهرين فقط من الانفجار لا يقدّم مادة خبرية أو تقريراً صحافياً، بل يخلق تجربة حسية تستند إلى الصوت والصورة معاً، وتجعل المشاهد شريكاً في إعادة عيش الانفجار وما خلّفه من آثار نفسية وجسدية. يمتد الفيلم ستّ عشرة دقيقة، وهو من إنتاج "درج" (منصة صحافية مستقلة)، وقد فاز بجائزة "أفضل فيلم وثائقي قصير" من مؤسسة "رايتد إس آر" في نيويورك.
وأبرز ما يميّزه تركيزه على صوت الزجاج المنتشر على امتداد المدينة. إذ إن الزجاج المتكسّر الذي داسته الأقدام أو جمعه المتطوّعون تحوَّل إلى خلفية صوتية تلاحق المشاهد. وإلى جانب صوت الزجاج اعتمدت كارول على تسجيلات صوتية غير مكتوبة مسبقاً تبادلتها مع أصدقائها ومقرّبيها، يعبرون فيها عن الغضب والعجز والمرارة. وكأن هذه الأصوات مجتمعة صارت مقطوعة موسيقية لمدينة جريحة، تعبّر عن هشاشتها وعن الغضب الكامن في وجدان سكانها.
يحمل الفيلم طابعاً شخصياً، ومثلما فعلت نجوى بركات في "غيبة مي"، تستعيد كارول منصور ذاكرتها مع الحرب الأهلية وما خلّفته من صور انفجارات وزجاج متساقط وتضعها في مواجهة الانفجار الجديد الذي بدا لها خاتمة قاسية لتاريخ طويل من العنف. تقول كارول في أكثر من موضع في الفيلم إن هذا الحدث جعلها تشعر أن "كل شيء انتهى".
لذلك جاء غضبها صريحاً رافضاً حتى أسطورة "طائر الفينيق"، الذي يخرج من تحت الرماد، التي طالما ارتبطت بصورة بيروت. تقول: "الله لا يردّوه لطائر الفينيق [. . .] ما بقا بدي أصمد ولا أتحمّل". هنا، ينقلب الفيلم إلى مساحة تمرّد على خطاب الصمود التقليدي مفضّلاً التعبير المباشر عن الانكسار والعجز.
لم تكتفِ المخرجة بتوثيق تجربتها، بل فتحت المجال لأصوات الآخرين لتصبح التجربة الشخصية شهادة جماعية تنطق بلسان المدينة بأكملها. شمل ذلك أصدقاء في الداخل والخارج، ناجين وجرحى ومغتربين. كل صوت جاء ليضيف طبقة جديدة من المعنى. من الغضب والسخرية إلى الأسئلة القاسية التي تتوارد من المخرجة في الفيلم، "ماذا نقول؟ وكم مرّة يحقُّ لمدينة أن تقهر أهلها إلى هذا الحدّ؟".
الفيلم جزءٌ من مشروع أوسع، سلسلة بعنوان "بيروت 6:07" قدّمت خمسة عشر فيلماً قصيراً لمخرجين ومخرجات لبنانيين، جميعها مستوحاة من قصص حقيقية لضحايا وناجين. هذه السلسلة التي عُرضت على منصة البث العربي على الانترنت "شاهد" مثّلت محاولة بصرية جماعية، اجتمع فيها مخرجون شباب على إنتاج أرشيف سينمائي جماعي لانتزاع الحق في الذاكرة، والانتقام الرمزي للضحايا بتحويل الكارثة إلى قصص حيّة.
تؤكد كارول منصور للفراتس أن فيلمها لم يكن مجرّد توثيق لحدث، بل مواجهة شخصية مع الذاكرة والمكان والذات. تعلق: "لم أفلح في الهروب من المشهد. الزجاج المتكسّر في كل شارع كان يذكّرني بالحرب الأهلية، بشكل أقرب وأشد ألماً". وتضيف أنها لم تفكر بالفيلم مشروعاً فنياً بقدر ما كان ضرورة داخلية "لتفريغ ما لم يُحتمل من الصمت والغضب، خشيتُ أن أنسى، لأن النسيان هو الجريمة الأكبر. لزم أن أوثّق، ليس للتاريخ بل إنصافاً للألم نفسه".
هذا الألم الذي حملته كارول إلى الشاشة لم يكن خاصاً بها وحدها. إذ تشير إلى أن ما لفتها في العمل هو التماهي الكبير بين ألمها الشخصي وألم الناس من حولها، "شعرت أن المشهد الذي صوّرته اليوم عشته من قبل وأن كل بيت هو بيتي، وكل زجاج مكسور هو زجاج بيتي أنا". وترد كارول على من يرى في أفلام ما بعد الانفجار نوعاً من استغلال الألم، "هذا الاتهام لا يخصني لأن جميع أفلامي نابعة من الواقع. حين يكون الألم حقيقياً يصبح التعبير عنه فعل صدق، وليس استغلالاً". هي بذلك لا تبحث عن الأمل بقدر ما ترفض الصمت، وتصرّ على إبقاء الجرح مفتوحاً للحفاظ على الذاكرة.
بهذا تكمل الأشكال الفنية المختلفة بعضها بعضاً في بناء أرشيف متعدد الطبقات للكارثة. الرواية تحفظ التجربة الفردية في نص يمكن قراءته وتأمّله، والمسرح يحوّلها إلى طقسٍ جماعي يعيشه الحاضرون، والسينما تضمن استمرارية الذاكرة بصرياً عبر إعادة المشاهدة والانتقال عبر الأجيال.
وإذا كانت الصدمة التي خلّفها انفجار المرفأ أكبر من أن تُختزل في خطاب سياسي أو إعلامي، فإن هذا التعدد الفني يقدّم بديلاً قد يساهم في بناء ذاكرة جماعية لا تُطمس بسهولة.