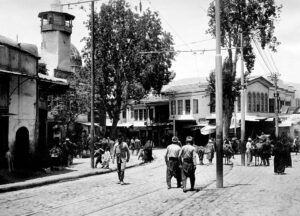أبرز هذه الأمثلة حيّ بَرْزة، على حافّة مدينة دمشق الشمالية، وعلاقته مع الحيّ المجاور، عشّ الوَرْوَر. فقد توسّع الحيّ عمرانياً في السبعينيات فوق أراضٍ زراعيةٍ لمنطقةٍ ما تزال مأهولةً بسكانها الأصليين تعرف بِاسم "برزة البلد"، بعد أن استملكت الدولة أراضيَ لصالح مشروعٍ سكنيٍ مخصصٍ للطبقة الوسطى يسمّى "مساكن برزة". كذلك استملِكَت أراضٍ بغرض إقامة منشآتٍ عسكرية. تَعمَّق تفكُّك أراضي برزة وتَرسَّخ عداء السكان للنظام السابق عندما وُطّنَت عائلات وحدةٍ عسكريةٍ تابعةٍ لقوات ما كان يعرف باسم "سرايا الدفاع" التي كان يقودها رفعت الأسد شقيق حافظ، على أرضٍ صخريةٍ تدعى "عش الورور"، عُدّت فيما سبق جزءاً من مجال برزة المجتمعي الطبيعي. تطور الأمر إلى أحداث عنفٍ بين سكان المنطقتين سنة 1975، بعد تعدّي سكانٍ من عش الورور على مقهىً شعبيٍ في حيّ برزة وقتلِهم عدداً من مرتاديه. وبعد الثورة السورية سنة 2011 اصطفّ سكان المنطقتين على طرفَي الضدّ. فقد أقدم سكانٌ من عش الورور على مهاجمة المظاهرات في حيّ برزة، وانتشرت تحذيراتٌ بين سكان عش الورور من أنّ سكان برزة يخططون للهجوم لاستعادة أرضهم التي سلبت.
وبالمِثل، برز الانقسام المجتمعي بين حيّ المَزّة 86 وحيّ المزّة المجاور له مع بدايات الحراك الثوري. أُنشئ حي المزّة 86 في البداية ثكنةً عسكريةً لقوات "سرايا الدفاع" نفسها في السبعينيات على أراضٍ استُولِيَ عليها بالقوة العسكرية، وهي ملك سكانٍ محليين من حيّ المزّة المجاور. تطوّر حي المزّة 86 لعمرانٍ غير منظمٍ ضمّ سكاناً على أساسٍ طائفيٍ غالبهم من العلويين من مناطق الساحل السوري وحمص ممن حصلوا على مساكن، بناءً على قربهم من النظام وقواته العسكرية.. يُطالب سكان حيّ المزّة اليوم عقب سقوط الأسد باستعادة أراضيهم المسلوبة منذ عقودٍ، معتضِدين في دعواهم بأن السندات القانونية تثبت ملكيتهم لها.
وإن انتهى نمط الاستلاب هذا منهجاً لبثّ الانقسام السياسي مع سقوط نظام الأسد في نهاية 2024، إلا أن آثاره ما زالت حاضرةً اليوم، بل ازدادت تعقيداً. فمشكلة العقارات المسلوبة والتغيير السكّاني شملت المدن السورية التي شاركت في الثورة كافةً، وطالت ملايين السكان. عاد كثيرٌ من المهجّرين إلى مناطقهم. وفي حين فقد بعضهم مأواه بفعل القصف والتدمير، لم يُكتب لآخرين العودة إلى بيوتهم بسبب الاستيلاء عليها أو ضياع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها. كذلك فإن الأهالي الراغبين بإعادة إعمار عقاراتهم المدمرة يواجهون المشكلة نفسها، مع صعوبة اتفاق جميع السكان، أو الخلاف في الحصص العقارية، أو وجود بناءٍ فوق ممتلكاتهم الأصلية. وقد كشفت محاولات أصحاب الملكيات العقارية المسلوبة استردادها عن تعقيدات الواقع القضائي والقانوني، وحجم الفراغ والعطالة الإدارية التي تَحول دون إيجاد آليّاتٍ فعالةٍ لاسترداد الحقوق وجبر الضرر. وفي مواجهة هذه التعقيدات وغياب خطةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمعالجة هذا الملف، بدأت محاولاتٌ محليةٌ لتنظيم استرداد الحقوق وتسوية نزاعات المِلكية في بعض المناطق مثل كفرسوسة وداريّا في دمشق والقْصير في ريف حمص ومناطق عدة في حلب، وإن حاق بهذه الممارسة بعض الإشكالات القانونية.
استمرت لاحقاً عمليات التهجير القسري لتشمل مناطق الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي سنة 2018. أُبعد الملايين خارج البلاد أو داخلياً نحو الشمال السوري، حيث حصروا في مساحةٍ ضيقةٍ ما لبثت أن ضاقت أكثر بفعل حملات الاجتياح والقصف العنيفة.
ولأن عودة المهجرين بدت تهديداً للتجانس الذي دأب النظام على ترسيخه، لم يدّخر مُوالُوه وآلَتُه الإعلامية جهداً في شيطنة الشمال السوري الذي ضمّ مهجَّري الاتفاقيات، وإطلاق الدعوات المباشرة لاستكمال الحرب عليه. وحسب إحصائية شبكة "منسّقو الاستجابة" سنة 2021، فقد شكّل النازحون ما لا يقلّ عن مليونين ومئة ألف من أصل نحو أربعة ملايين يسكنون مناطقَ الشمال السوري الخارجةَ عن سيطرة النظام حينئذ.
مع ذلك، وفي سبيل إعادة تأهيل النظام وانخراطه مجدّداً في المجتمع الدولي تمهيداً لإعادة الإعمار، أطلق النظام دعواتٍ شكليةً للّاجئين للعودة. ففي سنة 2019 أعلن عن السماح بعودة الأهالي لدخول مناطق كانت محظورةً عليهم مثل القصير وداريا. لكن الدخول كان مشروطاً بموافقاتٍ أمنيةٍ، فضلاً عن الخطر الذي يحيق بالعائدين والذي شمل الملاحقات الأمنية والقتل والتغييب القسري. وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع سنة 2014 حتى يونيو 2024 ما لا يقلّ عن 4714 حالة اعتقال عائدين من اللجوء أو النزوح على يد قوات النظام.
هذا التحرك الهائل للجماعات والكتل البشرية في سوريا، لم يكن مجرّد أثرٍ جانبيٍ لعملياتٍ عسكريةٍ خاضها النظام للقضاء على معارضيه، بل كان نتيجةً لسياسةٍ متعمدةٍ من الطرد والإحلال لجأ إليها النظام لاستبدال التركيبة السكانية بأخرى خاضعةٍ سياسياً وأمنياً. استهدف الأسد في سبيل ما أسماه "التطهير" التركيبةَ المجتمعيةَ في المناطق التي خرجت عن سيطرته بالقصف الممنهج والواسع الذي طال الكتل السكنية. وكذلك جاء استهدافه تدميرَ مقومات الحياة وفرض الحصار وسياسة الأرض المحروقة، مقدمةً لفرض التهجير.
وبينما كان النظام يطارد السكان جماعاتٍ خارج حدود سيطرته، كان يلاحقهم أفراداً ويمارس الطرد والإحلال بضوضاءٍ أقلّ في المناطق الخاضعة له. وكان معتمداً في ذلك على الملاحقة الأمنية والتجنيد الإجباري والانتهاكات التي طالت حقوق الملكية والسكن، والاستيلاء عليها (بغطاءٍ قانونيٍ أحياناً). إلى جانب وضع النظام سياسات التطوير العقاري التي تهدف إلى إحلال بنيةٍ سكانيةٍ متوافقةٍ مع بنيته.
وفي حين أن ممارسات نظام الأسد كانت موجهةً ضدّ شعبه، إلا أنها تقاطعت في جوهرها مع نماذج الاستعمار الإحلالي، ومنها فلسطين. يقول عالم الاجتماع الفلسطيني ساري حنفي في مقالته "فروم سبيسيوسايد تو جينوسايد" (من الإبادة المكانية للإبادة الشاملة) سنة 2023، إن الإبادة المكانية تجعل المساحة المكانية غير صالحةٍ لحياة الفئة المستهدَفة بالتطهير والطرد. وتتجسد هذه الإستراتيجية، بحسب حنفي، بالاستيلاء المستمر على الأرض وهدم المنازل وفرض الاستيطان. وكذلك إقامة الحواجز بين المناطق وتقييد الحركة، إضافةً إلى استخدام السلطات استثناءاتٍ قانونيةً لتجريد السكان من الحقوق وتمنح الدولة الحقّ بوضع اليد على مساحاتٍ واسعةٍ من الأملاك بحجّة التطوير العقاري.
ومقابل سياسات "تهويد المكان" في فلسطين، حدث ما يمكن تسميته "أَسْدَنة المكان" في سوريا. إذ أعيد تغيير هوية المكان بتدميره، إما بالقصف أو بتجريف مساكن وأحياءٍ سكنيةٍ بكاملها. ومن أمثلة ذلك تجريف مساحاتٍ واسعةٍ من حيَّيْ مشاع الأربعين ووادي الجوز في مدينة حماة، وحيَّي التضامن والقابون في مدينة دمشق. كذلك استولى النظام على كثيرٍ من العقارات، إما بوضع اليد أو بغطاءٍ قانوني. وعمّق الانتهاكاتِ انتشار شبكات التزوير وضياع إثباتات الملكية. ووُزّعت الأراضي والممتلكات بما يضمن ولاءً سياسياً واجتماعياً يقصي الجماعات غير المتشابكة مع بنية النظام ومنظوره.
من خلال مقابلاتٍ مع لاجئين سوريين عادوا من الأردن ولبنان بين سنتَيْ 2017 و2021، رصد تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "حياة أشبه الموت" نشر سنة 2021، استعصاء عودة المهجّرين بسبب دمار الملكيّات وسلبها. وجد أكثر من نصف المحاوَرين منازلَهم مدمَّرةً جزئياً أو كلياً، أو أنها نهبت. كذلك رصد تقريرٌ لمنظمة "اليوم التالي" الحقوقية، نشر سنة 2024، أن حوالي 80 بالمئة من العائدين لم يُقدِموا على أيّ محاولةٍ لاستعادة ممتلكاتهم وقال 60 بالمئة منهم إنهم لم يحاولوا بسبب الخوف من الاعتقال بينما قال 25 بالمئة إن وصولهم تعذّر إلى المنطقة. بينما اضطرّ معظم القلّة الذين حاولوا استرجاع ممتلكاتهم، إلى دفع رشاوى إلى جهاتٍ حكومية.
ويعلّق تقرير منظمة باكس الهولندية، "فيوليشين أوف هاوسينغ" (انتهاكات حقوق السكن) المنشور سنة 2020، بأن نحو 70 بالمئة من اللاجئين لم يكن لديهم الوثائق الأساسية الضرورية لآليّات إثبات ادّعاء الملكية في المستقبل. والسبب فقدانهم الوثائق نتيجة القصف والنزوح، أو لأن قوات النظام صادرتها.
وبين ممارسة نزع ملكيةٍ وأخرى، ومن إحلالٍ سكانيٍ لآخَر في أرجاء سوريا، برز حيّ كفرسوسة في دمشق مثالاً فظّاً لممارسات نظام الأسد في استلابه ممتلكات المواطنين.
ومع تصاعد النفوذ الإيراني إبّان سنوات الحرب، تحول الحيّ تدريجياً إلى أحد مراكز التمدد الإيراني في العاصمة دمشق. اعتاد كبار القادة والمستشارين الإيرانيين التردد عليه. وبمحاذاته مع حيّ المزة تقع السفارة الإيرانية والمدرسة الإيرانية التي كان يرتادها أبناء القادة وعائلات المتنفِّذين الإيرانيين واللبنانيين المرتبطين بحزب الله الذين استقروا في دمشق.
وتمثل صورة السيطرة الأمنية والنفوذ الإيراني نقيضاً لحيٍّ طالما عُدّ من بؤر الحراك الثوري في العاصمة. شهد الحيُّ المظاهرةَ الأولى في سوريا مع بداية الربيع العربي أمام السفارة المصرية في يناير 2011. ومع اندلاع الثورة في مارس 2011، أصبح مركزاً للحراك الثوري، وخاصةً مع انحياز "جماعة زيد" الدينية للثورة، والتي يقودها الشيخ أسامة الرفاعي، المفتي الحالي لسوريا، وكان مركزها جامع عبد الكريم الرفاعي الواقع في الحي. خرجت في الحيّ مظاهراتٌ وجنازاتٌ لثوّارهِ بأعدادٍ كبيرةٍ، ونال أبناءَه ما نالهم من الاعتقال والملاحقة الأمنية. ومع تصاعد المواجهات المسلحة فرض النظام سيطرته على الحيّ أواخر 2012، فلجأ كثيرٌ من ثوار كفرسوسة إلى داريا. كانت أعدادهم كبيرةً بما يكفي لتشكيل "لواء المقداد" الذي قاتل هناك حتى سيطرة النظام على داريا وتهجير الثوار منها في أغسطس 2016.
نتيجة هذا الثقل الثوري، مُورِسَت على الحيّ انتهاكاتٌ واسعةٌ عقب إحكام النظام سيطرته على المنطقة. وإضافةً إلى الاستيلاء مباشرةً على أملاك المعتقلين والملاحقين أمنياً عنوةً أو بالاعتماد على قوانين الإرهاب التي تتيح مصادرة أملاك المتهمين، أصدر الأسد المرسوم 66 في سبتمبر 2012، الذي قضى بإحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن مخطط المدينة العامّ بحجة "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي". وشملت المنطقتان مساحاتٍ واسعةً من ملكيات وأراضي أهالي كفرسوسة. تلقّى أصحاب الملكيات إنذاراتٍ بالإخلاء سنة 2015 لصالح مشروع "ماروتا سيتي" الذي كان سيشيّد مكان الأملاك المصادرة.
اضطرّ معظم الأهالي إلى الإذعان مع منحهم أسهماً تنظيميةً بدلاً من ملكيّاتهم، وهي حصصٌ في ملكية عقاراتٍ متدنية القيمة ضمن مناطق تخضع لتنظيمٍ عمراني. اضطر قسمٌ منهم لبيع هذه الأسهم لاحقاً للشركة القائمة على المشروع، فيما حُرم المبعَدون بسبب الملاحقة الأمنية أو المعتقلون من أيّ تعويض. وجُرّفت لاحقاً العقارات والمنازل الواقعة ضمن حدود المشروع ليبدأ تنفيذه سنة 2018. وما زال المتضرّرون حتى اليوم يطالبون بإعادة تقييمٍ عادلةٍ لقيمة الأسهم المستحقة لهم، وتعويض المبعدين والمعتقلين وذويهم ممّن حرموا إمكانية إثبات ملكيتهم.
وبشأن ملف استرداد الملكيات المسلوبة للعقارات القائمة في حيّ كفرسوسة، أجرت الفِراتْس مقابلةً موسعةً مع عبد الله الأكرم، وهو أحد أبناء حيّ كفرسوسة ومنظّمي الحراك الثوري فيه وعضوٌ في اللجان المحلية التي نشطت عقب سقوط النظام لمعالجة قضايا الملكية في الحيّ. تركّز نشاط الأكرم في داريا بعد سيطرة النظام على كفرسوسة، ثم خرج بعد ذلك إلى خان الشِيح في ريف دمشق وهُجّر مع الثوار إلى إدلب سنة 2016، ومنها عاد إلى حيّه كفرسوسة نهاية سنة 2024، وكان مشاركاً في معركة "ردع العدوان" التي انتهت بسقوط النظام.
يقول الأكرم إن لجاناً من محامين متطوعين وفاعلين مدنيين وأفرادٍ من الحراك الثوري والمشاركين في المعركة الأخيرة، تشكّلت في الحيّ. كان هدف اللجان استرداد العقارات بالتراضي مع سكّانها الجدد حيناً، أو الطرق القانونية والقضائية حيناً آخر.
إحدى أبرز القضايا التي تعاملت معها اللجان كانت العقارات التي استخدمها الإيرانيون وحزب الله اللبناني. يقول الأكرم إن الوجود الإيراني في الحيّ يمتد إلى ما قبل الثورة لكنه توسع خلال سنوات الثورة، بالإضافة إلى قدوم عناصر من حزب الله أيضاً.
وبحسب الأكرم كان الاستئجار لا التملّك هو وسيلة الإيرانيين المفضلة لتفادي الاستهداف الإسرائيلي. وعند تصعيد إسرائيل ضرباتها في سوريا قبل سقوط النظام السابق لم يغادروا الحيّ، ولكن رصدت حركة تغييرٍ وتبديلٍ للمنازل داخله. إلّا أن عمليات الاستئجار كانت أصعب بسبب إحجام الأهالي عن التأجير للإيرانيين خوفاً من الاستهداف. عند ذلك لجؤوا إلى الاستئجار عبر وسطاء وموكّلين أرهبوا الأهالي تارةً أو رغّبوهم بدفع قيمٍ ماليةٍ أعلى تارةً أخرى ليقبلوا بتأجير عقاراتهم.
وفقاً لإفادات الأهالي، كما ينقل الأكرم، فإن عدد هذه العقارات المستأجرة من الإيرانيين أو وكلائهم بلغ نحو خمسةٍ وستّين شقّةً ومنزلاً. ويوضح أنها استخدِمت سكناً لضباطٍ من الحرس الثوري ومسؤولين كبارٍ من حزب الله. كما استخدِم بعضُها مقارَّ عسكريةً وغرفَ عملياتٍ داخل مبانٍ مأهولةٍ بالسكان، إذ عثر في داخل بعضها على منتجاتٍ عسكريةٍ، منها طائراتٌ مسيّرةٌ انتحاريةٌ وموادّ متفجرة.
مع سقوط نظام الأسد بدأت التبليغات تَرِد من الأهالي عن وجود شققٍ مرتبطةٍ بإيران أو حزب الله، إما عبر شبكات علاقاتٍ محليةٍ بين الأهالي والثوار العائدين، أو عبر أرقام تواصلٍ نشرت علناً آنذاك، أو بإبلاغ القوات العسكرية الجديدة في الحيّ. ويروي الأكرم أن أحد السكان الذين تقدموا بشكوىً حول منزلٍ مشبوهٍ في عمارته، كان ممنوعاً من الدخول إلى شقّته إلا في أوقاتٍ محددةٍ وحين يسمح له فقط، إذ كانت تتمركز حراسةٌ أمنيةٌ على البناء.
في مثل هذه الحالات لم تتمكن اللجان المحلية من إيجاد حلولٍ فعالة. ولكن في حالاتٍ أخلى فيها المرتبطون بالنظام السابق العقارَ بأنفسهم مع تقدّم الثوار نحو دمشق، كان أصحاب الحقّ في المنزل من ورثة المالك الأصلي يتسلمون العقار، وإن بقوا بحاجةٍ لمعالجة التزوير الحاصل في أوراق الملكية.
في معظم حالات تزوير الملكية بالإكراه يلجأ أقرباء المعتقلين أو ورثتهم إلى الإجراءات ضمن الأطر القانونية والقضائية. ولكن الطعن في قضايا تزوير الملكية هذه صعبٌ قانونياً، لأن القاضي يرى سند ملكيةٍ قانونياً بيد المالك الجديد، ولا يستطيع إثبات وقوع جريمة المصادرة أو الإكراه. ويعلّق الأكرم أن القضاة أنفسهم لا يزالون من تركة النظام السابق، ما يزيد تعقيد أيّ مسارٍ قضائيٍ جادّ.
ثمّة نوعٌ آخَر من قضايا الملكية المحمية بموجب القانون الحالي، وهي ما يسمّى "الإيجار القديم". وهو نمطٌ عقاريٌ يعود إلى ما قبل الثورة بعقود. ويسمح باستمرار مستأجِر العقار في المنزل سنواتٍ طويلةً، دون قدرة المالك الأصلي على استعادته، حتى في حال وفاته أو مغادرته البلاد. كان العقار يتوارث كما لو كان ملكاً للمستأجر. وإن كان المستأجر يتبع مؤسسات النظام الأمنية أو العسكرية، فقد كان يبيع إيجار العقار لغيره بعقودٍ خارجيةٍ دون علم المالك الأصلي أو موافقته.
حالاتٌ أخرى من سلب الملكية كان يمارسها الضباط والمرتبطون بالنظام السابق، إذ يصادرون الملكية عنوةً وبلا حججٍ قانونيةٍ أو أمنية. تعود ملكية هذه العقارات في الغالب إلى مهجّرين أو معتقلين أو ملاحقين أمنياً، فصارت تستخدم لإيواء عوائل مقربةٍ من النظام لا تملك أيّ إثبات حقٍّ في هذه المنازل. وبلغ عدد الشكاوى من الأهالي لحالاتٍ من هذا النوع في كفرسوسة قرابة أربعين حالةً، وجميعها أعيدت إلى أصحابها، حسب الأكرم.
أما عن طريقة عمل اللجان المحلية، يردف الأكرم، فقد كانت في البداية توجّه طلباً لشاغر العقار غير الشرعي بالإخلاء مع مهلةٍ زمنيةٍ. استجاب بعضهم مباشرةً، خاصةً في الحالات التي لا يملك فيها شاغر العقار أيّ إثباتٍ لحقّه في البقاء في المنزل. وفي حالاتٍ أخرى كان الموضوع يُحَلّ بجلسة إصلاحٍ بين الطرفين والتوافق بالتراضي. وثمّة حالاتٌ، ومعظمها من قضايا الإيجار القديم، رفض القاطنون الخروج بحجّة وجود قانونٍ يحميهم. هنا جاء دور المحامين المتطوعين الذين لجؤوا إلى الإجراءات ضمن الأطر القانونية والقضائية، بصرف النظر عن الوقت الطويل الذي يمكن أن يستغرقه البتّ في القضية، ولا سيّما في ظلّ غياب تعديلٍ لبنية القضاء والقوانين الجائرة. ويرى الأكرم أن الحلّ بالتراضي هو الأفضل على المدى الطويل، "لأنه يحفظ العلاقات الاجتماعية في الحيّ".
يبقى العائق الأكبر اليوم أمام عودة كثيرٍ من أهالي كفرسوسة فقدانهم منازلهم وأملاكهم التي سُلبت، "هناك أصحاب أملاكٍ في الحيّ كانوا من الأغنياء. وبسبب هذه الانتهاكات اليوم ليس لديهم مترٌ واحدٌ يعودون إليه". ولم يختلف الوضع كثيراً في مدينة داريا المجاورة لكفرسوسة.
عمل النظام وحلفاؤه الإيرانيون على تغيير التركيبة السكّانية في داريا لصالح النفوذ الإيراني. ولتتبّع آثار هذا المشروع بعد سقوط النظام، أجرت الفِراتْس مقابلةً مع حسام اللحام، أحد الفاعلين في الإدارة المدنية في داريا ومسؤول قسم المبادرات فيها.
قال اللحام إن القبضة الأمنية كانت شديدةً في مدينة داريا قبل الثورة بسبب موقعها الإستراتيجي. فهي قريبةٌ من مطار المزّة العسكري ومساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة. ناهيك عن أن جذور النفوذ الإيراني في المدينة تعود إلى ما قبل الثورة. ففي داريا يَسّر نظام الأسد للإيرانيين بناء مقام السيدة سكينة.
وللمقام قصةٌ حدّدت دوره في السنوات اللاحقة. فحسب كتاب "السيدة المجهولة" المنشور سنة 2010 لعالم الدين الشيعي محمد رضا الواحدي، بدأت قصة المقام سنة 1985 عند تعبيد طريقٍ جديدٍ في داريا. تواصَل محافظ دمشق حينها مع عالم الدين الشيعي أحمد الواحدي لإبلاغه بوجود القبر، قائلاً إن القبر كان معروفاً لأهالي المنطقة أنه قبر "السيدة سكينة بنت الحسين"، وهو ما ينفيه الأهالي. ذهب الواحدي إلى إيران واجتمع بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وشُكّلت على الأثر لجنة متابعةٍ إيرانيةٌ لإعمار القبر. اشترت اللجنة البيوتَ والأراضيَ والعقاراتِ المجاورةَ ثم بدأت بتشييد المقام تدريجياً. ولم يبدأ بناء المبنى الضخم إلّا سنة 2004. وكانت هذه السنة ذروة نشاط التشييع في سوريا بعد سماح بشار الأسد بها، كما يذكر أستاذ علم الاجتماع الديني عبد الرحمن الحاج في كتابه "البعث الشيعي في سورية 1919-2007" المنشور سنة 2010.
خلال حصار داريا بين سنتَيْ 2012 و2016، شاركَت في الهجوم على المدينة مجموعاتٌ مسلحةٌ متعددة الجنسيات مدعومة من إيران تحت شعار الدفاع عن المقام. وبعد التهجير منع النظام السابق سكّانَ داريّا دخولَ المنطقة، على خلاف ما جرى في مناطق أخرى سيطر عليها. ظلّ منع عودة السكان سارياً حتى سنة 2019، فبدأ الأهالي النازحون في المناطق القريبة بالعودة تدريجياً. وفي فترة تحريم المدينة على سكّانها هَدم النظام وجَرّف ما تبقّى من المباني السكنية في محيط المقام، وبدأ وسطاء محاولاتٍ لشراء ملكيات المهجرين وأراضيهم في هذه المنطقة بمبالغ زهيدةٍ، مستفيدين من غياب الملّاك ومستغلّين حاجتهم في ظرف النزوح والتهجير.
النمط السائد للاستحواذ على العقارات في داريا كان الشراء، وذلك مع ضغوطٍ من الوسطاء المرتبطين بالنظام على بعض الملّاك لبيع ممتلكاتهم. إلّا أن الاستحواذ على العقارات دون موافقة المالك لم يكن شائعاً. وهناك عديدٌ من الملّاك الذين رفضوا البيع رغم الظروف الاقتصادية السيئة وضغوط الوسطاء، بحسب اللحام.
كان انتشار الإيرانيين ومن تحتهم من المقاتلين العراقيين كبيراً في داريا بعد سيطرتهم مع قوات النظام السابق عليها. ولكن بعد السابع من أكتوبر 2023 وتكرار الضربات الإسرائيلية على أهدافٍ إيرانيةٍ في سوريا، انحسر وجودهم إلى الأطراف وتركّزوا في مناطق محددة.
اختفى الإيرانيون والمقاتلون العراقيون من داريا قبل نحو ستة أشهرٍ من سقوط النظام. وتوقف حينئذٍ مشروع إعادة تأهيل مقام سكينة. ولم يُفتح في داريا بعد ملفّ الملكيّات الإيرانية، ولم يعرف الأهالي من يملك الأراضيَ حول المقام. ويسود اعتقادٌ لديهم بوجود أملاكٍ مستترةٍ لصالح إيرانيين مسجّلة بأسماء سوريين، بحسب اللحام.
بعد سقوط النظام تشكلت الإدارة المدنية لمدينة داريا لملء الفراغ الذي خلّفه غياب السلطة ولتسيير الأمور الإدارية في المدينة، مستندةً إلى تجربة المجلس المحلّي إبان سنوات الثورة. وساهم بعض أعضاء المجلس السابق في تشكيل الإدارة المدنية الحالية. كان اللحام أيضاً ضمن المجلس السابق منذ تأسيسه وحتى التهجير. وساهم في تقوية الإدارة الجديدة وجود أفرادٍ من ثوار داريا في القوة الأمنية التي قَدِمَت مع معركة "ردع العدوان" إلى المدينة.
بمبادرةٍ محلّيةٍ، شكّلت الإدارة المدنية "لجنة الصلح" للتعامل مع نزاعات الملكية، وتضمّ خمسة محامين ووجهاء محلّيين. ونالت اللجنة لاحقاً تفويضاً رسمياً من النائب العامّ حسان يوسف التربة، ما وسّع القدرة التنفيذية المرتبطة بقراراتها، فباتت تعمل بتنسيقٍ مع قسم الشرطة في المنطقة. تعاملت اللجنة مع حالاتٍ عدّةٍ لملكياتٍ مغتصبةٍ عنوةً. ويقول اللحام إنّ الذين بقوا في هذه المنازل كانوا إما عائلات عسكريين أو مدنيين مرتبطين بالنظام.
وفق اللحام تتواصل اللجنة عادةً مع الشخص المدّعي، ثم ترسل دوريةً تنفيذيةً إلى العقار لتسليم أمر إخلاء المنزل إلى القاطنين فيه عنوةً، مع منح مهلةٍ من أربعة أيامٍ إلى أسبوع. اضطرت اللجنة في بعض الحالات إلى تكرار طلب الإخلاء، ولجأت أيضاً إلى إبلاغ القاطنين دون عقد إيجارٍ بالمبلغ المستحق عليهم وفق مدّة إقامتهم. وبعد فترةٍ من الزمن كانوا يستجيبون لأمر الإخلاء من غير إجراءاتٍ أخرى. كما تُطلع لجنة الصلح صاحبَ الحق في الملكية على هوية شاغل العقار السابق بغير وجه حقٍّ، في حال أراد رفع دعوى ضدّه لاحقاً.
وتدخلت لجنة الصلح بنزاعات حول الملكية بين سكان المجتمع المحلي نفسه. ولأنها لم تتمكن من حلّ جميع النزاعات، فقد أحالت بعضها إلى القضاء. بين هذه حالاتٌ رَمّم فيها سكّانٌ محلّيون منزلاً مهجوراً وسكنوه إبان تهجير أصحاب المنزل الأصليين ولكن أصحاب المنزل طالبوا بإخلائه عند عودتهم، بينما يشترط القاطنون استعادة تكاليف الترميم قبل الإخلاء.
بالتوازي مع لجنة الصلح فُتحت ملفات الاستملاك الجائر القديمة، التي تعود إلى ما قبل الثورة. إذ استملكت الدولة أملاكَ أفرادٍ بذريعة التطوير العقاري ودخولها ضمن مقترحٍ أو مخططٍ تنظيمي. إلا أن هذا الاستيلاء قد وقع دون أيّ تعويضٍ، ما جرّده من قانونيته، وحتى التطوير العقاري المقترح لم يُنفذ أيضاً.
وفق اللحام، أنشأت الإدارة المدنية "مكتب الاستملاك"، بهدف تعويض المتضررين من حالات الاستملاك الجائر، وذلك بعد توثيق حالاتهم وخوض المسار القانوني والقضائي الحكومي. وسجّل المكتب أكثر من ألف ضبط استملاكٍ في منطقة داريا.
وجدت في داريا حالات تزويرٍ وتلاعبٍ بالملكيات نفّذتها شبكات تزويرٍ مرتبطةٌ بنظام الأسد. وهناك عديدٌ ممّن فقدوا أو أضاعوا ثبوتيات أملاكهم بسبب ظروف القصف والنزوح. لمواجهة هذه الإشكاليات، أطلقت الإدارة المدنية مشروعاً لتوثيق الملكيات وتثبيتها على مستوى المدينة. فقد قُسمت داريا إلى قطاعاتٍ، على أن يطلب من الملّاك في كلّ قطاعٍ تقديم مستندات ملكيتهم خلال شهرٍ واحد. يلي تلك المرحلة فتح باب الطعون مدّة شهرٍ واحدٍ أيضاً لتلافي أيّ تلاعبٍ في السجلات العقارية. يمكَّن مَن يدّعي التلاعبَ بملكيته مِن تقديم الإثباتات، ويليه الإقرار أن الملكية الجديدة المزوّرة أو المسجّلة بالإكراه باطلةٌ بالاستناد إلى الدلائل. يقول اللحام: "نعتمد أيضاً على شهادات الجيران المعروفين".
تكتسب هذه الخطوة أهميةً إضافيةً مع الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار. ويرى اللحام أن تثبيت الممتلكات يجب أن يسبق نقاشَ أيّ مشروعٍ في المنطقة، لضمان التعويض والاستفادة العادلة لسكان المنطقة المدمرة، وهو ما دفعهم إلى تسريع العمل به.
ليست آثار التمدد الإيراني على سلب الملكية محصورةً في داريا ومحيطها، بل طالت أيضاً مدينة القصير في محافظة حمص بالقرب من الحدود اللبنانية. إلّا أن السكّان هناك واجهوا مشاكل أكثر متعلقةً بالنزاعات المحلية.
تحتل القصير موقعاً استراتيجياً بالقرب من الحدود اللبنانية على خط الإمداد الإيراني السابق لحزب الله، وتحيط بها مواقع عسكريةٌ مثل مطار الضبعة العسكري الذي يبعد عنها حوالي خمسة كيلومتراتٍ، وكتيبة الصواريخ في منطقة أم الصخر القريبة.
انخرط سكان القصير على نطاقٍ واسعٍ في الثورة السورية منذ بدايتها، وقوبلت مظاهراتها بالعنف والرصاص مثل بقية مناطق الثورة. في مرحلة الصراع المسلح انخرط حزب الله اللبناني في الحملة العسكرية عليها وحصارها منذ بداية سنة 2013، حتى السيطرة عليها في يونيو من العام نفسه. ترافقت الحملة مع قصف المدينة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي سبّبت دماراً واسعاً، وانتهت بطرد معظم سكانها الذين نزح العدد الأكبر منهم إلى منطقتَيْ وادي خالد وبلدة عرسال في لبنان. تحولت القصير إلى منطقةٍ عسكريةٍ بعد ذلك، ومنع حزب الله والنظام السابق عودة الأهالي حتى سنة 2019، حين سمحوا بعودةٍ مشروطةٍ لبعض الأهالي بموافقاتٍ أمنيةٍ فقط.
مع ما عايشته القصير من وجودٍ أجنبيٍ دام سنواتٍ، إلّا أن سجلات الملكيات فيها لا تَشِي بتغيراتٍ جذرية. يقول أبو محمد إن المسؤولين في الحكومة الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد، كشفوا عن عقود الشراء لصالح حزب الله أو الجهات المدعومة إيرانياً لكن عددها كان قليلاً. ولكن في فترة غياب سكان المدينة عنها، حصلت عمليات شراءٍ محدودةٌ لصالح إيرانيين قادها أشخاصٌ سوريون. اتَّهَم أبو محمد منهم شخصاً عمل بالتعاون مع وسطاء محليين. وشخصاً آخر تحوّل منزله إلى مقرٍّ لاستقبال مسؤولين ورجال دينٍ لبنانيين وإيرانيين، وفق الشاهد، ولم تتمكّن الفِراتْس من التأكد من هذه المعلومة. قُدّمت عروضٌ مغريةٌ لمالكين غائبين. وبسبب أوضاع النزوح وفقدان أمل العودة باع كثيرون ممتلكاتهم. بلغ عدد تلك العقارات بين سبعين وثمانين عقاراً فقط، من أصل نحو ثلاثة عشر ألف عقار.
ويبقى الدمار الكبير في الممتلكات العائق الأول اليوم أمام عودة مهجّري القصير إليها. واستمرّ الضرر حتى ما قبل سقوط النظام بفترةٍ وجيزةٍ، فقد تعرضت المنطقة الصناعية وسوق الهال (سوق الخضار والفاكهة) المحاذي لها إلى أضرارٍ جسيمةٍ عقب القصف الإسرائيلي في أكتوبر 2024، إذ كان حزب الله يتخذها ثكنةً عسكريةً، مغلِقاً مداخلَها. أما ما بقي من المساكن فهو متهالكٌ وتعرّض للنهب واقتلعت حتى أبوابها ونوافذها. لذا يضطر بعض العائدين إلى الإقامة في منازل غير صالحةٍ للسكن، يرقّعون جدرانها بألواحٍ بلاستيكية ويغلقون نوافذها بأقمشةٍ أو نايلون، أو يرممون غرفةً واحدةً في المنزل ليسكنوها بينما تبقى الغرف الأخرى محروقةً أو مدمرة.
أما النزاعات القائمة اليوم حول الملكية فهي بين أهل البلد أنفسهم، وخاصةً حول العقارات الصالحة للسكن. ومع بدء عودة المهجرين ثمّة من وجد منزله مسكوناً بأقرباء أو جيرانٍ عادوا قبله وأعادوا تأهيله واستقروا فيه. ويرفض بعض هؤلاء الخروج دون استرداد كلفة الترميم. وما زالت هذه النزاعات متروكةً لتفاهماتٍ فرديةٍ بين أطراف النزاع. وحصل أن دفع بعض الملّاك الأصليّين تعويضات الترميم للقاطنين لاستعادة منازلهم.
ولا ينتهي الأمر هنا، حسب أبو محمد، فثمّة أيضاً مشاكل مرتبطةٌ بضياع الإثباتات للعديد من الملكيات. قبل الثورة، كانت القصير تضم عدداً من ملكيات الأراضي غير المقيّدة في السجل العقاري لتعقيداتٍ قانونيةٍ بسبب حاجتها إلى موافقاتٍ أمنيةٍ، إلى جانب تكاليف ماديةٍ إضافيةٍ لم يكن يراها السكان ضرورية. لتجاوز ذلك كانوا يلجؤون إلى تثبيت ملكيتهم عبر الكاتب بالعدل، وهي ملكيةٌ تحتاج إلى دعوى لتثبيتها بحكمٍ قابلٍ للتسجيل في السجل العقاري. يحتفظ الكاتب بالعدل بنسخةٍ من العقود المبرمة، كما توجد نسخٌ منها في محكمة القصير. اعتقلت قوات النظام مطلع 2013 الكاتب بالعدل الوحيد في مدينة القصير، يحيى حربا، وصودرت جميع الوثائق التي كانت بحوزته والتي كانت تثبت مساحاتٍ واسعةً من الملكيات في القصير وريفها. وبعد شهرين من اعتقاله ذاع نبأ مقتله تحت التعذيب.
قبل ذلك تعرضت محكمة القصير سنة 2011 لحريقٍ، ما أتلف كلّ الوثائق فيها. فتح هذا الفراغ القانوني البابَ أمام نزاعاتٍ معقدةٍ، فدعاوى التشكيك بسندات العدل تحتاج إلى شهودٍ رحلوا أو نسخٍ احترقت مع احتراق المحكمة أو ضاعت مع أصحابها بسبب ظروف القصف والنزوح.
يفتح أبو محمد نسخة السجلات العقارية أمامه على المكتب ويقول: "ما زالت عقارات بأكملها مثل هذا العقار رقم 3462، البالغة مساحته عشرين دونماً [الدونم ألف متر مربع] والمسجل بِاسم سيدةٍ ولدت سنة 1857، تحمل أسماء أشخاصٍ لم يعد لهم أثرٌ سوى في السجلات، بينما تقطنها عشرات العائلات دون أيّ سندٍ قانونيّ".
عند سقوط النظام لم تكن عائلة منافيخي المهجّرة تعرف ما حلّ بمنزله. صعد شقيقه المحامي محمد منافيخي نحو المنزل ولم يتمكن من فتح الباب الموصد بالقفل الجديد، فطرق أبواب الجيران الذين أخبروه أن محامياً كان يتردد إلى المنزل ويؤجّره لآخرين خلال السنوات السابقة.
عندما وصل النبأ إلى أُسَيْد ذهب مباشرةً إلى المحامي وطلب منه مفتاح المنزل. أنكر المحامي علاقته بالمنزل، وتحولت المواجهة إلى مشادّةٍ استدعى على إثرها المحامي شرطة مخفر الحمدانية. وفي المخفر شرح أُسَيْد حقّ عائلته بالمنزل، وصادف أن كان أحد عناصر الشرطة من الثوار القدامى فأخبره أن يجلس في المنزل ولن يتعرض له أحد. غيّر أُسَيْد الأقفال ولكن المحامي أتى لاحقاً إلى المنزل مع عناصر الشرطة وبدّلوا الأقفال مرّةً أخرى ورفع شكوى ضدّه تتهمه بالشروع بالقتل والتعدي على أملاكه.
كان المخفر قد تسلم دعوى من النيابة العامة، حاولوا بناءً عليها توقيف أُسَيْد الذي رفض وأطلق سراحه بعد مشادةٍ حادّة. يقول أسيد إن القضية بالنسبة إليه ليست مجرد قضية عقارٍ مسلوبٍ، وإنما "قضية حقوق الشهداء والثوار التي استولى عليها النظام"، ويضيف "سلبوا منافيخي حياته وجسده ثم بيته". وحاولت قوات الشرطة الحالية اعتقال أُسَيْد بسبب مطالبته بحقّ عائلة شقيقته بعد أن اعتقله النظام السابق ثلاث مرّاتٍ خلال الثورة.
بعد تلك الحادثة بدّل أُسَيْد الأقفال مجدداً واتفق مع عائلة من الجيران لتسكنه، ولكن المحامي عاد مرّةً أخرى مع عناصر من ضابطة المحافظة واتهموا الساكنين بالاستحواذ غير المشروع. وبعد أن نشر أُسَيْد مقطعاً مصوراً حول الحادثة وتحوّلت إلى قضية رأيٍ عامٍّ، تدخّل الأمن العامّ لصالح استعادة عائلة منافيخي منزلهم. يقول أُسَيْد: "حتى الآن، حصلنا على المنزل حيازةً فقط، لكن ما زالت الملكية في الأوراق الثبوتية بِاسم مزوّريها". ويضيف أن المحامي ما زال طليقاً مع كلّ الشكوك حوله بعضوية شبكة تزويرٍ واسعة. ويضيف: "للمصادفة، أحد أصدقائي كان ينوي شراء أرضٍ في خان العسل تبيّن عند البدء بالإجراءات أن عقد ملكية الأرض مزوّرٌ، وأن المحامي نفسه يتولّى إدارته".
توجّهت العائلة بعد ذلك إلى المسار القانوني، إذ تقدّم المحامي محمد منافيخي بشكوى إلى "لجنة الغصب البيّن" في محافظة حلب. والتي أنشئت آنذاك للتعامل مع هذا النوع من حالات سلب الملكية.
قابلت الفِراتس ملهم عكيدي، معاون محافظ حلب والذي كان قائداً عسكرياً في الجيش الحرّ قبل ذلك، للتعليق على المسألة. كشف عكيدي لنا عن انتشار شبكات تزويرٍ للملكيات نشطت في مدينة حلب عقب التهجير، واستهدفت هذه الشبكات ملكيات العقارات المثبتة بحكم محكمةٍ أو المملوكة على الشيوع، أي حين يكون العقار مقسّماً إلى أسهمٍ غير مفروزةٍ بعد للمالكين.
وتبدأ آلية النظر في القضايا بإحالة الشكوى من المحافظ إلى قيادة الشرطة، التي تتحقق من وضع اليد على العقار قبل سنة 2011 وبعد 2016، عبر مراجعة إفادات المالكين المزعومين وشهادات الجوار. تتولى دائرة الشكاوى في المحافظة غربلة الملفات وإحالتها إلى اللجنة. بينما تقع مهمة التنفيذ الميداني لقرارات اللجنة بالتحقيق وإعادة الحيازة على إدارة الشرطة.
يرفع قسم الشرطة في منطقة العقار نتائج التحقيق إلى اللجنة للبتّ فيها، ثم تنفذ الشرطة قرار اللجنة بإعادة الحيازة إن ثبت وقوع التعدي على العقار. في بعض الحالات التي تنضوي على نزاعٍ حول الملكية وأصل الحقّ، تحيل اللجنة الشكوى إلى القضاء المدني المختص.
حتى منتصف 2025، تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى، عالجت اللجنة منها حوالي 411 حالة، وأعادت الحقّ في ثمانيةٍ وثمانين عقاراً بعد إزالة الغصب. بينما أحيلت إلى القضاء المدني ثلاثون حالةً لخروجها عن اختصاص اللجنة.
تكرر استهداف المزورين ملكيات الضحايا الذين قتلهم النظام السابق خلال سنوات الثورة والحرب، ويزداد تعقيد الحالة مع بيع المنزل لأكثر من مالك. فكما جرى مع ملكية إبراهيم منافيخي، تعرض منزل ماجد كرمان للاستلاب بعد تزوير سند الملكية. وكان كرمان من المشاركين في المظاهرات ثم أصبح مقاتلاً في الجيش الحر، وقُتل في إحدى المعارك سنة 2014.
قال لنا عكيدي، وهو زوج شقيقة كرمان، إنه عندما طرق باب منزل كرمان وجد شخصاً غريباً، "سألته: 'من أنت؟' فأجاب أنه مالك المنزل … 'وممّن اشتريتَه؟' فأجاب بِاسم شخصٍ غريبٍ آخر". بحث عكيدي عن المالك السابق ووجد أربعة مشترين للمنزل، حتى وصل إلى مزوّر العقار الذي تبيّن أنه يسكن البناء نفسه. أحضر هذا الشخص محامين وزوّر عقد الملكية بعد معرفته بوفاة كرمان وغياب عائلته بعد تهجيرها. وكان أول مشتريين يعلمان بوجود ما يريب حول سند العقار، ولذلك بيع المنزل بسعرٍ زهيد.
ولأن حَلّ قضايا من هذا النوع يتطلب عادةً الدخول في مسارٍ قضائيٍ طويلٍ، لجأ عكيدي إلى لجنة الغصب البيّن التي تختصر العملية وما فيها من إجراءاتٍ معقدة. وتعدّ قرارات اللجنة قانونيةً بإعادة الحقّ إلى أصحابه.
ولكن، على جهودها لإعادة الحق لأصحابه، تعرضت اللجنة لانتقاداتٍ بسبب تأخر قراراتها للبتّ في الشكاوى. يقول عكيدي: "استغرق قرار اللجنة بإعادة الحيازة لمنزل ماجد كرمان ثلاثة أشهر". ولكنه يبيّن أن عمل اللجنة مؤخراً أصبح أسرع بعد الوصول إلى تنسيقٍ أعلى بين الجهات المعنية للتغلب على معوقاتٍ قانونيةٍ وإداريةٍ عديدةٍ بين محافظة حلب ووزارة الداخلية والقصر العدلي.
وفي حديثنا مع عكيدي، تبيّن لنا أن كثيرين يرَوْن بأن حلّ قضايا الملكية المسلوبة في مدينة حلب ما زال يعرقله جهازٌ قضائيٌ من تركَةِ النظام السابق. إذ إن شبكات التزوير التي انتشرت نشطت بتنسيقٍ مع قضاةٍ ما زالوا على رأس عملهم، مما يقدح في حياد الإجراءات القضائية أو يضع شكوكاً حولها لدى الأهالي. وقد خرجت مظاهرةٌ في القصر العدلي في 27 يوليو 2025 طالبت بطرد مرتبطين بالنظام السابق، ممّن ما زالوا في مناصب قضائيةٍ وقياديةٍ ضمن القصر العدلي.
ولا تقتصر مشكلة النزاعات العقارية على المدن المذكورة، ولكنها تظهِر أزمة المنظومة القضائية وغياب خطّةٍ وطنيةٍ لعلاجها، ما دفع الأهالي لمبادراتٍ محليةٍ في كلّ منطقة. ومع اقتصار هذه المبادرات على عقاراتٍ فرديةٍ، فإن المشكلة الأكبر تتمثل في إعادة إعمار المناطق المدمّرة على نطاقٍ واسع. وخاصةً في المباني التي تهدّمت وتحولت الأرض إلى منطقة حقوقٍ ملتبسةٍ لشاغلي العقار السابق. وهؤلاء سكّان أحياءٍ ومدنٍ كاملةٍ أضحى معظمها ركاماً.
ولكن المشكلة تبقى بتوفير الموارد المالية اللازمة. فلتعيين قضاةٍ جددٍ، وجب توافر موارد تسمح برواتب هؤلاء القضاة والتعويضات وتأمين أماكن عملهم، وجملة من الضمانات المالية التي تنص عليها القوانين فيما يتعلق بالقضاة لضمان نزاهتهم وعدالتهم.
وبينما يجد بعض المواطنين أن عمل اللجان المحلية في ردّ المظالم المرتبطة بالملكية أمرٌ إيجابيٌ قد يخفّف العبء عن الدولة، يعتقد صبرا أن عملها، جماعةً أهليةً، ينبغي أن يقتصر على حصر الحقوق وجمع الوثائق للّجان القضائية المختصة، وأن منحها صلاحياتٍ تنفيذيةً مزاحمةٌ للدولة في وظيفتها. فالوظيفة القضائية تمتد إلى ما بعد إصدار القرار، والذي يتعلق بقوة التنفيذ الجبري لقرارات القضاء.
ومع انتشار مطالباتٍ بإلغاء جميع قرارات الاستملاك التي استحوذت بموجبها الدولة على أملاكٍ خاصّةٍ في عهد النظام السابق، إلّا أن إلغاءها غير ممكنٍ دون إجراءاتٍ قانونيةٍ معتمدةٍ في القانون النافذ نفسه أو تشريعٍ جديدٍ يضع أساساً للإلغاء. وحسب صبرا، فمن كان لديه مظلمةٌ بحدوث استملاكٍ دون تعويضٍ يمكنه مراجعة القضاء الإداري من أجل حصوله على التعويض، أو المطالبة بإلغاء القرار عندما يتضمن أساس الاستملاك انحرافاً وخللاً في البواعث والغايات، مع دليلٍ أن الاستملاك لم يكن للمصلحة العامة.
ينطلق المحامي محمد صبرا في طرحه من مراعاة مبدأ استمرارية الدولة، إذ يميز القانون السوري النافذ بين شكلَيْن أساسَيْن من الملكية. الأول هو الملكية الشرعية، إذ يجتمع في يد المالك حق ملكية الأصل والانتفاع معاً، وغالباً ما نجدها داخل مراكز المخططات التنظيمية في المدن والبلدات. أما الأساس الثاني فهو متعلق بالملكية الأميرية، وفيه تبقى ملكية الأصل بيد الدولة، في حين يمتلك الأفراد حق التصرف والانتفاع.
يغطي الشكل الثاني أغلبيةَ الأراضي الزراعية خارج مراكز المدن والمناطقَ الخارجة عن المخططات التنظيمية. ولذلك فإن غالبيةَ البيئة العمرانية المدمرة ممتلكاتٌ أميرية. وينشأ هنا الإشكال الأكبر، فغالباً ما تكون هذه العقارات مملوكةً على الشيوع، أيْ مسجلةً على شكل أسهمٍ يتقاسمها عددٌ كبيرٌ من المالكين. ومع أن هذه الملكيات تحولت إلى مبانٍ سكنيةٍ ومحالّ تجاريةٍ، إلا أن صكوكها الرسمية تصفُها قانونياً أراضيَ زراعية. لذا فعملية حصر الحقوق وتثبيت الملكيات المتشابكة تحتاج إلى جهازٍ قضائيٍ ضخمٍ وكلفةٍ ماليةٍ عاليةٍ قد ترهق ميزانية الدولة الناشئة، وإلى وقتٍ طويلٍ للتثبت من الحقوق.
لا يتنفي هذا التعقيد عن مناطق دُمّرت ضمن المخططات التنظيمية وتحتوي ملكياتٍ شرعيةً، مثل حيّ جوبر في مدينة دمشق. فالصعوبة هنا بحسب صبرا تكمن في وجود نظام الطبقات، إذ يمتلك الفرد شقةً محددةً، ولكن تبقى أجزاءٌ من البناء مثل المصاعد والسلالم والوجائب والمدخل مملوكةً على الشيوع. وهذا ما يزيد من التباس عملية حصر أصحاب الحقوق في الملكية بوضعها المدمر بعد عودتها أرضاً جرداء.
ويرى صبرا أن الحل لا يكون بمعالجةٍ فرديةٍ لكلّ عقارٍ أو ملكيةٍ، وإنما عبر إصدار تشريعٍ عامٍّ يحلّ جميع الملكيات في المناطق المدمرة ويحوّلها إلى منطقةٍ تنظيميةٍ جديدةٍ، بحيث يُمنح أصحاب الحقوق أسهماً في المنطقة التنظيمية الجديدة. ويرى كذلك إمكانَ بدء الدولة بحصر أصحاب الحقوق من خلال البلديات، عبر تشكيل مكاتب تتلقى الطلبات والوثائق لمحاولة إثبات أصحاب الحقوق حقوقهم.
تقف هذه المعضلة القانونية عائقاً أمام عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة. فلم تتشكل لجنةٌ وطنيةٌ لحصر الحقوق التي تطال ملايين السكّان، ولا يبدو أن الدولة الناشئة تمتلك الميزانية لذلك مع حجم الدمار الكبير.
قدّمت المبادرات الأهلية على مستوى المدن حلولاً إسعافية للنزاعات حول الملكيّات المسلوبة على يد مرتبطين بالنظام السابق غالباً. ولكن مع غياب خطةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لعلاج ملفّ تثبيت حقوق الملكية العقارية، سواءً بالنسبة للملكيّات المدمّرة أو المسلوبة أو التي طال التزوير وثائقَها أو التي فُقِد إثباتها، فإن هذه الأزمة ستعيق إمكانية إعادة الإعمار وستبقى بوابةً للانقسامات والنزاعات الأهلية، والشعور الفردي والجماعي بالغبن، واستمرار أزمة النزوح والتهجير.