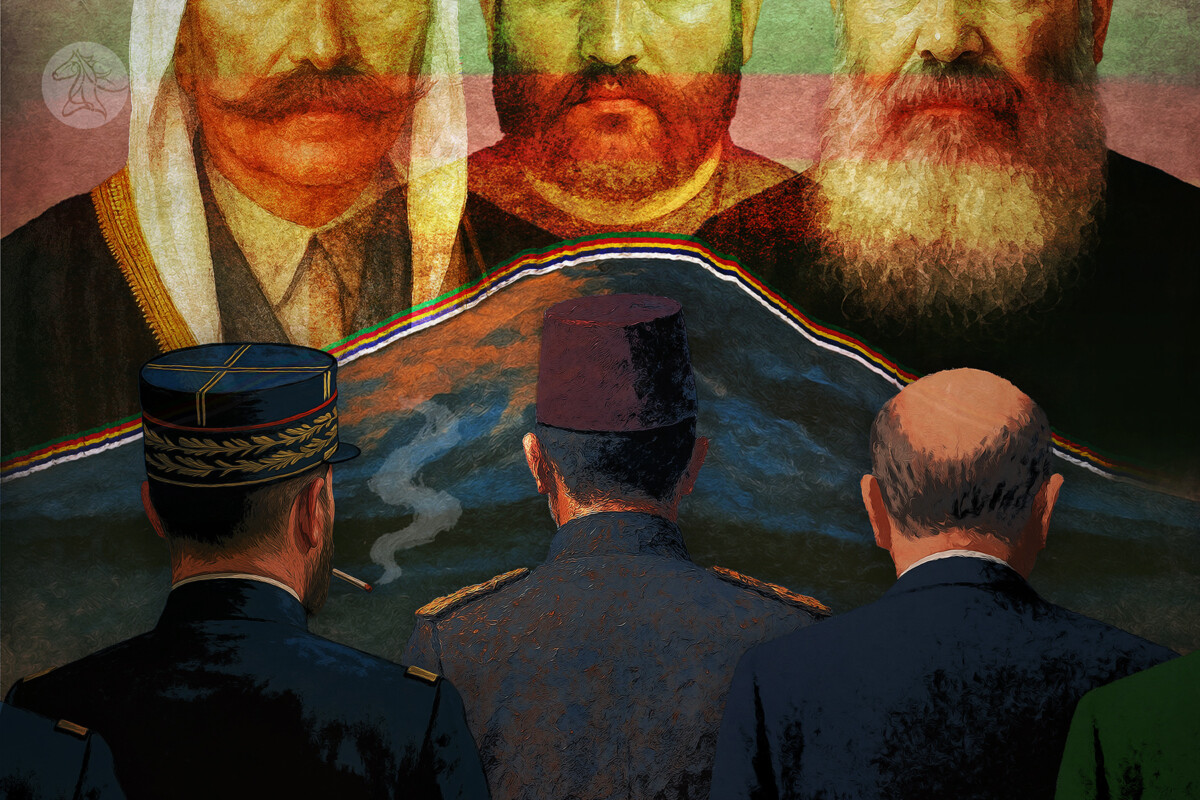ومنذ استقرار الدروز في المنطقة، مثّل الجبل معضلةً سياسيةً مزمنةً أمام كل سلطةٍ مركزيةٍ حاولت بسط نفوذها على جميع الأراضي السورية. فلم تتمكن السلطنة العثمانية من تطويع الدروز إدارياً، ولم ينجح الانتداب الفرنسي في ترسيخ سلطته هناك. وظلت الجمهورية السورية بعد الاستقلال عاجزةً عن دمج الجبل في الدولة بلا صدامات. في المقابل لم يكن الجبل فضاءً متمرّداً دائماً، بل كان كياناً محلياً يفاوض الدولة من موقع استقلالي، محكوماً بتقاليد الزعامة والعُرف والسلاح والمكان ويعيد تعريف علاقته بالمركز في كل لحظةٍ سياسية مفصلية. كان الجبل يشارك بشروطه ويعارض حين يشعر بتهديد خصوصيته ويطالب بحصته من الإدارة والموارد، ولكن يرفض الخضوع لمعايير السلطة المركزية. وكلما حاولت الدولة فرض سيادتها أمراً واقعاً، قابلها الجبل بمنطق الندّية والمواجهة.
تبدو العلاقة بين جبل حوران والمركز، بمختلف صورها الإمبراطورية والانتدابية والجمهورية، علاقة تفاوض مستمر بين مركز عاجز عن إنتاج عقد وطني شامل، وهوامش تملك من القوة ما يكفي لتأجيل الإدماج دون كسره. فلم يكن النزاع بين الطرفين بسبب الامتيازات الإدارية أو الشكل المؤسسي فحسب، بل حول تعريف الدولة نفسها ومدى فرض المركز سلطته على المكوّنات. بهذا لا يبدو جبل الدروز استثناءً محلياً، بل نموذجاً كاشفًا لأزمة الدولة السورية برمّتها.
درس كتاب "التعريف بمحافظة جبل العرب" المنشور سنة 1962، التحول السكاني في الجبل. يقول المؤلف المشارك شبلي العيسمي إن الهجرات الدرزية الكبرى إلى الجبل بدأت في أواخر القرن السابع عشر وتحديداً سنة 1685. حينها وصلت أولى موجات المهاجرين الدروز من لبنان مؤلّفة من نحو مئتي رجل وعائلاتهم، بقيادة أحد أمراء الدروز من آل معن (أو علم الدين حسب روايات أخرى)، فراراً من العثمانيين والأمراء الشهابيين الذين أنهوا حكم أسرة آل معن أو المعنيين على مناطق جبل لبنان سنة 1697.
كانت الهجرة الثانية الكبرى إثر معركة عين دارة في جبل لبنان سنة 1711 بين الدروز القيسيين واليمنيين. كان يقود القيسيين آل جنبلاط وأرسلان ومالوا إلى التحالف مع الموارنة، فيما قاد اليمنيين آل هرموش وعلم الدين. انتصر في المعركة التحالف القيسي بدعم الأمير حيدر الشهابي، وأدى ذلك إلى هجرة مجموعات من الدروز المهزومين إلى جبل حوران، حيث نزلوا ضيوفاً على من سبقهم من الدروز. ثم انخرطوا في صراعات طويلة مع القبائل البدوية للسيطرة على القرى الشمالية في جبل حوران، ونجحوا تدريجياً في فرض وجودهم.
استمرت الهجرة الدرزية في القرن الثامن عشر بسبب صراعات النفوذ في لبنان وفلسطين. فمع سعي حاكم عكا الظاهر العمر الزيداني إلى توسيع إمارته في إقليم الجليل في فلسطين، هاجم الدروز وأرتكب فيهم مذبحة طربيخا سنة 1721. أدَّت المذبحة إلى هجرة الدروز الذين باتوا يُعرفون في جبل حوران باسم "الصفدية" نسبة إلى صفد شمال فلسطين، حسب المؤرخ السوري تيسير خلف في مقاله "لعنة جبل الدروز" المنشور سنة 2023. ثم هاجر آخرون مع حملة الوالي العثماني أحمد باشا الجزار سنة 1788 على الأمير يوسف الشهابي في جبل لبنان، التي انتهت بعزله وتعيين شقيقه بشير الثاني الذي لم يسلم أيضاً من مضايقات الجزار.
في مطلع القرن التاسع عشر وقعت الهجرة الدرزية الثالثة حين دفع التشدد السني لوالي حلب العثماني كنج يوسف سنة 1811 أعداداً كبيرة من دروز جبل السماق (يتبع إدارياً إلى محافظة إدلب حالياً) إلى النزوح باتجاه حوران. واستمرت الهجرة بعد في أحداث سنة 1860 الدموية بين الدروز والمسيحيين الموارنة في جبل لبنان، التي بدأت ثورة فلاحين موارنة ضد إقطاعيين دروز وإن اختلفت تفاصيل الرواية بين المؤرخين. أدت الأحداث إلى تهجير نحو ثلاثة آلاف رجل درزي مع عائلاتهم إلى جبل حوران.
يورد كتاب "التعريف بمحافظة جبل العرب" أن الدروز واجهوا في بداية استقرارهم مقاومة شرسة من القبائل البدوية التي اعتبرت مناطق جبل حوران جزءاً من أراضي نفوذها التقليدية للرعي والماء، فشنّت غزوات متكررة لطرد الوافدين الجدد. غير أن التنظيم العسكري لبني معروف (لقب يطلقه الدروز على أنفسهم) مكّنهم من صد هذه الغارات وفرض توازن جديد، خصوصاً بعد تحالفهم مع قبيلة الجوابرة في منطقة اللجاة (إلى الجنوب من دمشق) ومع قبيلة الشنابلة جنوب شرق السويداء.
الصراع بين الدروز والبدو في تلك المرحلة، لم يكن طائفياً بقدر ما كان نزاعاً قبلياً واقتصادياً على الموارد والنفوذ. وبحلول القرن التاسع عشر توصل الطرفان إلى تفاهم حذر، قائم على تبادل المنافع وضبط التوترات، كما وصفه الرحّالة السويسري يوهان لودفيغ بوركهارت في زيارته الجبل سنة 1811، وذلك في كتابه "ترافيلز إن سيريا آند ذا هولي لاند" (رحلات في سورية والأرض المقدسة) المنشور سنة 1822.
مع الوقت انتقل الدروز من موقع الدفاع والتفاهم إلى موقع السيطرة، فصاروا يفرضون الإتاوة على القبائل البدوية مقابل السماح لهم بسقاية مواشيهم من ينابيع القرى وخزاناتها، وذلك حسب حديث الشيخ إسماعيل الأطرش للرحّالة والمبشّر البروتستانتي الأيرلندي جوزياس بورتر سنة 1853، في كتابه "فايف ييرز إن دمسكس" (خمس سنوات في دمشق) المنشور سنة 1855.
غير أن هذه الامتيازات كانت هشة، إذ سرعان ما اصطدمت بمحاولات السلطة المركزية فرض سيادتها التدريجية، فدخل الطرفان في دائرة مفرغة من التمردات والحملات العسكرية والتسويات المؤقتة. وعلى حد تعبير المؤرخ الفلسطيني الأمريكي حنا بطاطو في كتابه "فلاحو سورية" المنشور مترجماً للعربية سنة 2014، فإن الانتفاضات الدرزية طيلة فترة الحكم العثماني الطويلة كانت تؤدي إلى نتائج مستقلة عما بعدها في كل مرة، أي أن نتيجة كل انتفاضة أو صدام أو صيغة تفاوضية كان يصلها الطرفان لم تؤثر على التفاهمات اللاحقة.
لم يكن الصدام الأول الفعلي بين الجبل والمركز مع الولاة العثمانيين، وإنما مع إبراهيم باشا في حملته على بلاد الشام بين سنتي 1831 و1840. فقد مدّ نفوذه نحو جبل الدروز بوسائل مباشرة شملت بناء الحصون قرب منابع المياه ومصادرة السلاح وفرض التجنيد. وبعد مفاوضات لم تُثمر، تمرّد الدروز وأطلق إبراهيم باشا ثلاث حملات عسكرية فاشلة ضدهم بين سنتي 1837 و1838، ثم قاد إبراهيم باشا نفسه حملة ضمّت أكثر من عشرين ألف جندي في صيف 1838. ولكنه اضطر إلى التوجه نحو وادي التيم في لبنان لقمع ثورة اندلعت هناك ردّاً على حصار الدروز. ومع فارق القوة العسكرية الكبير، أنهى الحملة بصلح مع زعماء الجبل ومنحهم إعفاءات واسعة من الضرائب والتجنيد، وأقرّ لهم حق اختيار مشايخهم.
مع انسحاب إبراهيم باشا من بلاد الشام سنة 1840 عادت السلطنة العثمانية، وبدأت مرحلة توتر طويلة بسبب رفض الدروز الخضوع للتجنيد الإجباري ودفع الضرائب. ففي سنة 1851 أرسل والي دمشق محمد باشا القبرصي قوة عسكرية إلى الجبل انتهت بهزيمة العثمانيين في معركة صاري عسكر. أنشئ في هذه المرحلة سنجق حوران سنة 1856 الذي ضمّ قضاء "جبل دروز حوران". وشهدت هذه المرحلة صدامات مع بدو اللجاة وفلاحي سهل حوران أيضاً، الذين أطلق عليهم المؤرخون الدروز مثل حنا أبي راشد اسم "الحوارنة". كان أهم هذه الصدامات معركة مسيكة في اللجاة سنة 1857، وأسفرت عن انتصار الدروز وسيطرتهم على سبع عشرة قرية في اللجاة وسهل حوران وتهجير أهلها.
بعد عدة سنوات أرسلت السلطنة لجنة بقيادة جميل بك وعاكف بك واستقروا في بصرى الشام، وهناك طلبوا مقابلة وفد من مشايخ الدروز. وعندما حضر الوفد طلبت منهم اللجنة استعادة القرى وتقديم الأموال والأعشار إلى الحكومة وطرد كل دخيل يلتجئ إلى الجبل. ولكن أبو علي قسام الحناوي المتحدث باسم الوفد ردّ بالقول: "أما الأموال الأميرية فإنها تُدفع بطيبة خاطر لأنها تدفع كزكاة أموال وفرض واجب، أما تسليم القرى لأصحابها فهذا أمر لا تقبله العشائر، فكما أخذناها نحن بالسيف فليأخذوها هم بالسيف أيضاً، وإذا أردتم أن تستلموها بالقوة فسنسلمها بعد أن نروي ترابها بالدم، وإذا مشيتم علينا فلا نقابلكم إلا بالبارود واليوم المقروض [المشؤوم]"، نقلاً عن كتاب "جبل الدروز" للمؤرخ الدرزي حنا أبي راشد المنشور سنة 1925.
استمرت حلقات المواجهة في السنوات التالية، التي تداخل فيها الصراع الأهلي مع السياسي، مع اصطفاف الدروز ضد البدو والحوارنة والعثمانيين. وكان أبرزها معركة أولى في قرية قراصة سنة 1876، واشتباكات قرية الكرك (في درعا) في 1877، ثم معركة قراصة الثانية سنة 1878 التي خسر فيها الدروز ستمئة مقاتل، ولكنها انتهت أيضاً بتراجع الجيش العثماني.
استغلت السلطنة العثمانية التوترات العشائرية بين الدروز والحوارنة سنة 1882 لبسط نفوذها وتهدئة التوتر مع بني معروف بدمجهم في بنيتها الإدارية. فأرسلت المشير حسين فوزي باشا وأنشأت قائمقامية في جبل الدروز، ضمّت ثماني نواحٍ ومجلساً إدارياً ومحكمة، وعيّنت الأمير إبراهيم الأطرش قائمقاماً فيها. لكن "الثورة العامية" اشتعلت بين سنتي 1887 و1890، وهي تمردٌ درزيٌ ضد تسلط إبراهيم الأطرش على الفلاحين. كان للأطارشة امتيازات كبيرة، ولم يعترفوا بملكية الفلاحين الأراضي التي يزرعونها، وكانوا يفرضون السخرة عليهم في أعمال الزراعة والحصاد، أو يرحّلونهم عند أدنى تمرد.
قاد الحركةَ بعض وجهاء القرى بدعم شبلي الأطرش الذي وقف ضد شقيقه إبراهيم. ولم تتدخل السلطة المركزية في دمشق إلا بعد هروب الأطارشة إلى قلعة المزرعة وطلبهم المساندة من الوالي العثماني. اغتنمت السلطنة الفرصة وأرسلت حملة عسكرية على السويداء وأعادت إبراهيم الأطرش. ولكن العثمانيين فرضوا شروطاً صارمة وسّعت نفوذهم في الجبل، إذ بُنيت قلعة للحامية العثمانية، وثبّت حقوق الفلاحين في أراضيهم ومنع ترحيلهم. ومع أن آل الأطرش استعادوا موقعهم إلا أن الثورة كشفت هشاشة بنية الحكم المحلي وإمكانية الانقسام الدرزي حوله.
ثم اندلع تمرد جديد سنة 1896، فأُرسلت حملة عسكرية إلى قرية عرمان، جنوب غرب السويداء، وهزمت هناك. ولكن القائد العسكري ممدوح باشا تبعها بحملة ضخمة فرض فيها اعتقالات ونفياً جماعياً للمتمردين إلى الأناضول. إلا أنّ التمرد تجدد مع عودة بعض المنفيين سنة 1900، ثم انتهى بعفو السلطان عبد الحميد الثاني عن المتمردين وقبول مطالبهم بعودة باقي المنفيين ورفع التجنيد الإجباري وتخفيف الضرائب. لكن السلطنة قررت حينها إضعاف قضاء جبل الدروز بتقسيمه إلى ثلاثة أقضية، السويداء وصلخد وعاهرة (تُسمى اليوم عريقة).
استمرت الحملات العسكرية التأديبية بعد ذلك بسبب الصدامات بين الدروز وبين بدو اللجاة وفلاحي سهل حوران، ثم صارت أعنف مع صعود جمعية الاتحاد والترقي.
في المقابل لم تكن الضرائب مجرد عبء اقتصادي، بل أصبحت رمزاً للصراع على السيادة. إذ كان الفلاح الدرزي لا يعترف إلا بالزكاة، واعتبر باقي أنواع الجباية اعتداءً خارجياً، والتجنيد الإجباري تهديداً لهوية الجماعة التي اعتادت أن تختار معاركها بمعزل عن المركز. ففي نهايات القرن التاسع عشر هرب قرابة ستة آلاف رجل من الجبل إلى المناطق الوعرة، حتى صارت نسبة المجندين من الجبل من بين الأدنى في ولايات الشام، حسب ما تبيِّن دراسة الباحث التركي سردار بيه "سبريسينغ ريبيليون، بروجيكتينغ آثوريتي" (قمع التمرد، فرض السلطة) المنشورة سنة 2025.
وفي ميدان القضاء اصطدمت محاولات الدولة إنشاء محاكم حديثة بقوة الأعراف المحلية. إذ كان للمجتمع الدرزي منظومة متكاملة لحل النزاعات الداخلية، فرفض المثول أمام محاكم الدولة وقضاتها، ما أفشل معظم مشاريع التقنين.
امتدت مقاومة الدمج إلى التعليم، فالمدارس الرشدية (مدرسة حكومية عثمانية) التي أنشأها السلطان عبد الحميد الثاني بداية القرن العشرين لم تجد إقبالاً. وزاد الإحجام مع صعود جمعية الاتحاد والترقي القومية إلى الحكم سنة 1908. إذ أصبح التعليم مظهراً للتتريك، مع تدريس كل المواد باللغة التركية. وصف الصحفي والسياسي السوري محمد كرد علي هذا النفور عن التعليم في جريدته المقتبس سنة 1910 بالقول: "لا توجد مدرسة حية في حوران ولا مدرسة ابتدائية منتظمة مفيدة". ولم يكن فيها سوى مفتش وحيد هو عبد الجليل الدرة، وهذا حسب ما ينقل المؤرخ السوري فندي أبو فخر في كتابه "تاريخ لواء حوران الاجتماعي" المنشور سنة 1999.
وقع التمرد الأخير بعد صعود الاتحاد والترقي، فكانت حملة سامي باشا الفاروقي سنة 1910 آخر محاولة قاسية لجمع الضرائب والتجنيد الإجباري. شارك في الحملة نحو ثلاثين ألف جندي، واعتُقل العشرات من الدروز وأُعدم آخرون، بينهم ذوقان والد الزعيم الدرزي سلطان الأطرش. ولكن الفاروقي أطلق سراح المعتقلين لاحقاً.
مع اقتراب الحرب العالمية الأولى تراجع حضور الدولة في الجبل، فأصبح آل الأطرش المرجعية السياسية والإدارية والعسكرية، وأعلنت بعض القرى نفسها "إمارات" تتبع المشيخة.
عند اندلاع الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي سنة 1916 ضد العثمانيين، تحول الجبل إلى قاعدة دعم للثوار، واستقبل آلاف اللاجئين من المناطق الأخرى. وانخرط سلطان الأطرش مبكراً في تنسيق العمليات مع الشريف فيصل ابن الشريف حسين، وشارك في المعارك على مشارف دمشق حتى دخلها ورفع العلم العربي فوق دار الحكومة سنة 1918. وبدأت حينها محاولة أخرى للدمج بين الجبل والحكومة العربية الناشئة في دمشق.
اختارت الحكومة العربية التعاون مع زعامات الجبل التقليدية مع تباين المواقف السياسية. فعيّنت سليم الأطرش متصرفاً لجبل حوران الذي أصبح محافظة سورية، مع أنه لم يكن من مناصري الثورة العربية. وشارك نسيب الأطرش في مجلس الشورى، ثم انتُخب ممثلاً في المؤتمر السوري العام قبيل وصول لجنة كينغ كرين الأمريكية في يونيو 1919، وهي لجنة شكلها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لاستطلاع آراء سكان المشرق العربي حول مستقبلهم السياسي بعد انهيار الدولة العثمانية. ومع إعلان المملكة السورية في الثامن من مارس سنة 1920، أثار غياب وزير درزي عن حكومة علي باشا الركابي استياءً في أوساط الدروز.
مع انهيار الحكومة العربية بعد الهزيمة أمام الجيش الفرنسي في معركة ميسلون في يوليو 1920 وخروج الملك فيصل إلى المنفى في بريطانيا قبل عودته للعراق ملكاً، بدأ الفرنسيون مشروعهم التقسيمي. فقد وافقوا على إنشاء كيان إداري خاص في جبل حوران الذي سمّوه "جبل الدروز" بعد استمالة بعض زعمائه وتوقيعهم عرائض تطالب بالانتداب الفرنسي شريطة الحكم الذاتي، حسب ما يورد حسن البعيني في كتابه "دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي" المنشور سنة 1993. تحول الجبل إلى دولة شبه مستقلة أثناء الاستعمار الفرنسي، وبدأت مرحلة الحكم الأهلي في أبريل 1921 حين كُلف سليم الأطرش بتشكيل حكومة محلية، وانتُخب المجلس النيابي لدولة الجبل.
حاول الأطرش تمويل مشاريع حكومية من جيبه الخاص، وصار يوقّع باسم "الحاكم العام لدولة جبل الدروز". بينما سمّى الفرنسيون السكانَ "الشعب الدرزي" و"الأمة الدرزية"، وكان للفرنسيين السلطة الفعلية غير المباشرة.
كانت حادثة اعتقال الفرنسيين المقاومَ اللبناني أدهم خنجر سنة 1922، بعد لجوئه إلى قرية القريا في ريف السويداء، شرارة أول المواجهات المسلحة بين سلطان الأطرش والانتداب الفرنسي. حاول الأطرش ورجاله تخليص خنجر واشتبكوا مع الفرنسيين في معارك كر وفر. هدمت الطائرات الفرنسية بيتَ سلطان الأطرش، وحكم الفرنسيون عليه بالإعدام فلجأ إلى الأردن، قبل أن يعود في السنة التالية إلى السويداء بعد عفو فرنسي عنه وعن جماعته. كانت مشيخة العقل قد اتخذت حينها موقفاً مؤيداً للفرنسيين ضد سلطان الأطرش. ووصفت أدهم خنجر بالشقي الذي اعتدى "على حركة شخص فخامة الجنرال غورو صديق الجبل ومحب الدروز المخلص".
مع وفاة سليم الأطرش في سبتمبر 1923 انهارت صيغة الحكم المحلي النسبية، وبدأ الفرنسيون الحكم المباشر بتعيين الضابط غابرييل كاربيه حاكماً على الجبل. يذكر القانوني والسياسي السوري إدمون رباط الذي عاصر تلك المرحلة في كتابه "تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب" المترجم للعربية سنة 2020، أنه لم يكن للدروز حينئذ سوى السلطة الرمزية بينما كانت السلطة الحقيقية للموظفين الفرنسيين.
زادت التوترات تدريجياً بين الجبل والفرنسيين مع سياسات كاربيه الذي سعى لتحجيم سلطة الزعامات التقليدية، وفرض ضرائب عالية وسياسات رقابة وقمع ضد السكان، مع فرض اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي. وانترع كاربيه ما بقي من مواقع قيادية للدروز. تحوّلت قيادة الشرطة للفرنسيين، فعزل مسؤولين محليين من وجهاء الجبل مثل عبد الغفار الأطرش ونسيب الأطرش، وطارد آخرين مثل متعب الأطرش، شيخ قرية رساس جنوب السويداء، وصادر ممتلكاته.
تجاهلت السلطات الفرنسية مطالب إعادة الحكم الأهلي، وتصاعدت حملات الاعتقال، مع تواصل مجموعات المقاومة ضد الانتداب الفرنسي بين الجبل وبقية المناطق السورية. وتُوّج هذا ببدء المعارك المسلحة بين سلطان الأطرش والفرنسيين في يوليو 1925، ثم بيان سلطان في إعلان الثورة يوم 23 أغسطس 1925، موقعاً باسم "قائد جيوش الثورة السورية الوطنية العام". انطلقت الثورة السورية الكبرى بمطالب توحيد البلاد وطرد المستعمر، واختار قادتها من مختلف المناطق السورية سلطان الأطرش قائداً عاماً لها، إلى أن أنهاها الفرنسيون وطردوا قادتها خارج سوريا سنة 1927.
لم تبدأ صدامات الدروز مع الفرنسيين إلا حين أخلوا باتفاق الحكم الأهلي، على رمزيته، والذي نصّ على أن يكون الحاكم محلياً. واستمرت محاولة بعض الوجهاء التفاوض مع المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان ماكسيم ويغان، ثم خليفته موريس بول ساراي، للوقوف في وجه سياسات كاربيه وإعادة الحكم المباشر للسكان المحليين. وذلك حسبما أورده المؤرخ الروسي فلاديمير لوتسكي في كتابه "الحرب الوطنية التحررية في سوريا" المنشور مترجماً إلى العربية سنة 1964.
بهذا كشفت الثورة عن توجهين في الجبل، الحفاظ على مكسب الحكم المحلي والتفاوض مع الفرنسيين لتثبيته، والنزعة الوطنية المطالبة بطرد الانتداب وإقامة دولة وطنية مستقلة لكلّ السوريين تتجاوز التقسيم الطائفي.
ويوضح إدمون رباط في كتابه أنه عقب قمع الثورة السورية الكبرى وطرد سلطان الأطرش إلى الأردن، عادت فرنسا لحكم الجبل عسكرياً مع شيء من المرونة. ثم سعت فرنسا لتثبيت الانفصال الدرزي عبر عرائض جمعتها من شيوخ محليين، وأصدرت دستوراً خاصاً لدولة جبل الدروز سنة 1930 دون مشاركة أهله.
وفي مقابل المشروع الانفصالي المدعوم فرنسياً، تمسكت القوى المنفيَّة بقيادة سلطان الأطرش بالوحدة الوطنية ورفض الانفصال، واعتبروا العرائض الانفصالية أدوات استعمارية. وبين سنتي 1931 و1932 تصاعد الصراع بين وحدويين مدعومين من الوطنيين السوريين وانفصاليين تدعمهم فرنسا مثل عبد الغفار وحسن الأطرش. وسعت فرنسا لتكريس الانفصال عبر أحزاب محلية أسسها موالون لها. فقد أسس حمزة الدرويش، وكان أحد قادة الثورة السورية الكبرى، "حزب الشعب" الذي استند إلى دعم بعض العامة الرافضين هيمنة عائلة الأطرش. بينما ركّز متعب الأطرش عبر "الحزب الوطني الحر" على التنسيق الرسمي مع الفرنسيين. استخدمت هذه الأحزاب أدوات دعائية وعرائض سياسية لتبرير سياسة العزل الإداري، وتحولت إلى منصات صراع عشائري بين العائلات الكبرى، ما زاد تشتت البنية الاجتماعية في الجبل.
مع تقدم المفاوضات السورية الفرنسية التي انتهت بتوقيع معاهدة الاستقلال في باريس سنة 1936، تعزز التيار الوحدوي وضعف التيار الانفصالي، ما مهّد الطريق لإعادة دمج الجبل بسوريا. وأطلق الكاتب اللبناني عجاج نويهض تسمية جبل العرب بديلاً عن جبل الدروز في حفل وداع سلطان الأطرش من الأردن سنة 1937، ووافقه سلطان واعتمد المسمّى في خطاباته. ومع رواج التسمية أدبياً إلا أن المسمّى الرسمي ظل جبل الدروز.
نصّت المعاهدة السورية الفرنسيّة على إبقاء القوات الفرنسية خمس سنوات في جبلي الدروز والعلويين، مع نقل السيادة تدريجياً إلى الحكومة السورية. وبموجب ذلك تحوّل جبل الدروز إلى منطقة سورية تتمتع باستقلال إداري ومالي. وفي لحظة رمزية، رُفع علم الجمهورية السورية فوق دار الحكومة في السويداء، وأُنزل العلم الدرزي بصمت وسُلّم إلى شيخ العقل أحمد الهجري المتوفى سنة 1953.
ومع هذا الاندماج الرسمي استمر الصراع السياسي والاجتماعي، خاصة حول منصب المحافظ والانتخابات والموظفين المعينين من العاصمة، ولم تتوقف مطالب الانفصال المُرسلة إلى الفرنسيين وعصبة الأمم. فعندما حاول الرئيس السوري هاشم الأتاسي سنة 1937 تعيين محافظ من خارج الجبل هو السياسي السوري نسيب البكري ووجه برفض الوجهاء، ألغى القرار وترك الجبل بلا محافظ معيّن من الحكومة.
كذلك احتفظ الفرنسيون بنفوذ فعلي في الجبل، وظهر تعارض بين قراراتهم والحكومة السورية في قضايا عدة، من العطل الرسمية إلى التعيينات. ولم يعترف الفرنسيون رسمياً بإعادة الجبل إلى الدولة السورية إلا سنة 1942، وسُمّي حينها محافظة جبل الدروز، مع بقاء القوات الفرنسية هناك.
وبعد سنتين صوّت المجلس الإداري للمحافظة برئاسة حسن الأطرش على إلحاق الجبل في "سوريا الأم". ثم في سنة 1945 أُعلنت ثورة مسلحة ضد القوات الفرنسية في الجبل فطردتها منه، ودعمت الحكومة السورية هذا الحراك. ففي تلك السنة خرجت مظاهرات طلابية في السويداء تطالب بتسليم "جيش الشرق"، الذي شكّله الفرنسيون من مجنّدين سوريين منذ بداية الانتداب، إلى الحكومة السورية. وحسب ما يروي الضابط الدرزي أمين أبو عساف في كتابه "ذكرياتي" المنشور سنة 1966، هاجم المتظاهرون نادي الضباط وخربوه وطالبوا الجنود والضباط الدروز في كتيبة الفرسان الدرزية بالخضوع للحكومة السورية، وهو ما حصل.
عبّر سلطان الأطرش عن هذا الاعتداد بمكانة الجبل التاريخية حين رفض دعوة الرئيس شكري القوتلي للمشاركة في احتفالات عيد الجلاء الأول، وأقام عرضاً منفصلاً في السويداء. يقول السياسي السوري عبد اللطيف اليونس في كتابه "مذكرات" المنشور سنة 1992، إن سلطان الأطرش اشترط للحضور الاعتراف الرسمي بدوره في قيادة الثورة السورية الكبرى، وتنظيم عرض عسكري رسمي في جبل العرب.
تزامن هذا التوتر الرمزي مع مفاوضات سياسية أعقد بين وزير الداخلية السوري والأمير حسن الأطرش، الذي كان يمثل السلطة الفعلية في الجبل لأنه محافظه الرسمي وزعيمه غير المعلن. ويذكر الباحث الأمريكي جوشوا لانديس في دراسته "شيشكلي آند ذا دروز" (الشيشكلي والدروز) المنشورة سنة 1998، أنه في تلك المفاوضات رفع الأمير لائحة مطالب اقتصادية وإدارية. ولكن المطالب الأهم كانت الحفاظ على الامتيازات السياسية التي منحها الفرنسيون لجبل الدروز، وعلى رأسها السيطرة على التعيينات الإدارية المحلية وقوة الشرطة والجهاز الأمني. بل إن الأمير حسن ذهب أبعد من ذلك، مطالباً بوزارة دفاع خاصة بالدروز تُشرف على شؤونهم العسكرية باستقلالية عن دمشق. وكان التهديد بالانفصال والالتحاق بالمملكة الأردنية الهاشمية يُلوَّح به باستمرار، لا خطة عمليةً فورية، بل أداة ضغط في لعبة المفاوضات.
في يوليو 1947 انفجر التوتر الكامن مع إجراء الانتخابات النيابية في عموم البلاد، وفاز مرشحو آل الأطرش الخمسة في دوائر الجبل. لكن الحكومة في دمشق أعلنت أن الانتخابات مزورة، مع أنها تجاوزت التزوير الذي وقع في مناطق أخرى منها دمشق، بحسب مذكرات الضابط محمد معروف "أيام عشتها 1949-1969" المنشورة سنة 2003. إلا أن الرئيس شكري القوتلي أصر على إلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة لم تعقد أبداً. وبقيت مقاعد جبل الدروز شاغرة في البرلمان السوري حتى سقوط حكم الرئيس أديب الشيشكلي في فبراير سنة 1954 بانقلاب عسكري، ما مثّل قطيعة سياسية بين الجبل والدولة المركزية.
بحسب بحث المؤرخة الألمانية برجيت شيبلر، في كتابها "انتفاضات جبل الدروز - حوران [. . .]" المنشور مترجماً إلى العربية سنة 2004، دعمت دمشق معارضي آل الأطرش من زعماء العشائر الثانوية التي شكّلت فرقة "الجبهة الشعبية" أو "الشعبيين" العسكرية التي رفعت شعارات الجمهورية واتهمت الأطارشة بالاستبداد. وبعد الانتخابات تحوّل الخلاف إلى صراع مفتوح بين الزعامة التقليدية المدعومة بجماهيرها، والجبهة الشعبية المسنودة من دمشق. سيطر "الشعبيون" سنة 1947 على مدينة صلخد، جنوب السويداء، وأعدموا أنصاراً للأطرش. ثم هاجموا القريّا، ما مثّل تحدياً مباشراً لهيبة سلطان باشا وأثار خطر اندلاع حرب أهلية.
قاد سلطان باشا والأمير حسن الأطرش حملة مضادة استعادت صلخد وأَسرت قادة "الشعبيين"، وفرضت حصاراً على مداخل الجبل لمنع تدخل الجيش. عجزت الدولة عن التدخل المباشر، فاتجه الرئيس شكري القوتلي إلى معاقبة الجبل بقطع الإعانة السنوية البالغة نحو مليون ليرة سورية. ما شكّل ضربة مالية للإدارة المحلية، وكشف ضعف سلطة المركز في المنطقة.
كانت تلك السنوات مرحلة تمزق داخلي وجفاء عميق بين الجبل والدولة، قد تُفهم في ضوء الإرث الثقيل الذي ورثه الجبل من الانتداب، من شعور بالخصوصية الإدارية وامتيازات سياسية وبنية سلطوية شبه مستقلة. هذه الامتيازات التي يعتبرها سكّان الجبل حقوقاً، رأتها دمشق تحدياً صريحاً لفكرة السيادة المركزية الناشئة، وما لبثت تتكرر بعد أول انقلاب عسكري في تاريخ سوريا المستقلة.
يقول الصحفي البريطاني باتريك سيل في كتابه "الصراع على سوريا" الصادر سنة 1964، إن العلاقة بين المركز وجبل الدروز ما لبثت أن تدهورت حين أرسل الزعيم قوات من الجيش السوري إلى السويداء بهدف "حماية الجبل"، إلا أن الرسالة كانت عودة السلطة المركزية بالقوة إلى منطقة كانت خالية منها منذ عقود. فُهمت هذه الخطوة في الجبل تحركاً عدائياً، خصوصاً وأن حسني الزعيم هدّد الأطرش علناً، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع كان عنوانها هذه المرة سيطرة الجيش.
بدا أن موازين القوى قد تغيّرت نهائياً، إذ لم يعد الفرسان في الجبل قادرين على الوقوف في وجه مؤسسات الدولة بعد الانقلاب. فالجيش السوري، الذي لم يكن يتجاوز تعداده سبعة آلاف جندي سنة 1947 في زمن القوتلي، نما بعد حرب فلسطين سنة 1948. رفع حسني الزعيم تعداد الجيش إلى نحو اثنين وثلاثين ألف جندي بحلول سنة 1949، ثم أوصله العقيد أديب الشيشكلي لاحقاً إلى أكثر من ثلاثة وأربعين ألفاً نهاية 1951. وهو ما دفع الجبل إلى التراجع في الندية مع الدولة المركزية بعد أن قويت شوكتها، حسب الباحث جوشوا لانديس.
نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه الأول في ديسمبر 1949 ودخلت سوريا في حكم مزدوج بين الرئيس هاشم الأتاسي والمجلس العسكري الخماسي الذي شكّله الشيشكلي وكان الأقوى نفوذاً فيه. ثم نفذ انقلابه الثاني في ديسمبر 1951 وعُيّن الزعيم (رتبة عسكرية تعادل العميد) فوزي السلو رئيساً، ولكن الشيشكلي كان الحاكم الفعلي. إلى أن أصبح رئيساً مباشراً بعد استفتاء يوليو 1953.
ومنذ سنة 1951 بدأ مسار مركزة الدولة يأخذ طابعاً عدائياً صارماً ضد المناطق ذات الاستقلال الجزئي، وعلى رأسها جبل الدروز. لم يكتفِ الشيشكلي بإرسال الجيش إلى أطراف الجبل، بل حرص على تكريس السيطرة المركزية في كل تفصيل إداري ومالي وأمني. أُخضع تمويل الجبل كلياً لوزارة المالية في دمشق، وأُلغي تمويل الإدارة المحلية. ومنذ ذلك الحين بدأ تفكيك البنية الاقتصادية المستقلة التي اعتمد عليها الجبل وآل الأطرش، التي قامت على الإعانات الخارجية والتهريب وزراعة الحشيش.
توقفت الإعانات الأردنية بعد اغتيال الملك الأردني عبد الله الأول في القدس سنة 1951، وضعف التهريب مع تعزيز نقاط قوات حرس الحدود وتولّي صلاح الشيشكلي – شقيق الرئيس – إدارة هذه القوات. وحُظرت زراعة الحشيش التي كانت مصدر تمويل رئيس للأطارشة. ويعلّل لانديس هذه الخطوات بتقويض بنية القوة التقليدية في الجبل، ونقل مركز الثقل إلى دمشق. أضيف إلى ذلك تهميش الجبل تنموياً في تلك الفترة التي شهدت فيها سوريا طفرة في مشاريع البنية التحتية والزراعة، بينما ضخت الحكومة استثمارات في الجزيرة السورية شرق البلاد، بين فرعي دجلة والفرات وفي حوران.
مع استتباب الحكم للشيشكلي عقب انقلابه الثاني، بدأت مرحلة جديدة أكثر صرامة في التعاطي مع الجبل. تمثّلت الخطوة الأولى في تفكيك الإدارة المحلية التي كانت تحت هيمنة آل الأطرش، فعُيّن في مناصب المحافظ ورؤساء المناطق موظفون غير دروز ينتمون إلى حزب الشيشكلي "حركة التحرير العربي".
وامتدّ إلغاء الاستثناءات المحلية للقضاء. ففي سنة 1952 صدر قرار إدخال الإجراءات القضائية السورية العادية إلى جبل الدروز، وأُصدِر حكم لأول مرة حسب القانون السوري ضد قاتل من أهل المنطقة، في سابقة اعتُبرت إنهاءً للاحتكام إلى الأعراف العشائرية والدينية.
وفي الجيش كانت التصفية أعمق. فمنذ منتصف 1953 بدأت حملة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتناسب تصوّر الشيشكلي القومي. بحسب شهادة الوزير والسياسي البعثي أحمد أبو صالح في برنامج "شاهد على العصر" على قناة الجزيرة سنة 2014، لاحظ الشيشكلي تفوقًاً عددياً للأقليات في الجيش، وأبرزهم الشركس والمسيحيون. فأصدر قراراً ضمنياً يفرض "كوتا طائفية" تنهي سيطرة هذه المجموعات، وتعيد للعرب السنّة هيمنتهم على الجيش. وبعد ذلك أُحيل مئات الضباط من الأقليات، وبينهم دروز، إلى التقاعد أو نُقلوا إلى مناطق نائية. أبرزهم العقيد أمين أبو عساف الذي شغل موقعاً عسكرياً مهماً في سلاح المدرعات في قطنا في ريف دمشق.
اعتبرت الأقليات السورية تلك السياساتِ طائفية وإقصائية، ولكن يمكن قراءتها متوافقةً مع التوجه القومي والسلطوي للشيشكلي، وتكتيكاً عسكرياً للهيمنة على سلاح المدرعات الذي طالما قاد الانقلابات في سوريا. فقد دفع بعدها الضباط الشباب الموالين له إلى قيادة المدرعات في قطنا، بحسب مذكرات رئيس الحزب العربي الاشتراكي أكرم الحوراني المنشورة سنة 2000.
نتيجة هذه السياسات تحوّل الجبل إلى منطقة محاصرة سياسياً ومعزولة اقتصادياً ومُراقَبة أمنياً، مع تصاعد النقمة الشعبية وغياب أفق للتمثيل أو التفاهم مع المركز.
جاءت اللحظة الكاشفة في يناير 1954 حين اعتُقل منصور الأطرش، الصحفي والسياسي ابن سلطان الأطرش، بتهمة توزيع منشورات بعثية معارضة للشيشكلي، فاندلعت مظاهرات واسعة في السويداء. وعندما تحركت قوة أمنية إلى القريّا لاعتقال سلطان باشا الأطرش، وقعت مواجهة دامية قُتل فيها بعض عناصر الشرطة، فدفع الشيشكلي تعزيزات عسكرية ضخمة كان بعضها من عرب اللجاة ذوي الخصومات التاريخية مع الدروز. سقط في الحملة عشراتُ الضحايا من المدنيين واعتُقل المئات، بينما لجأ سلطان باشا إلى الأردن.
اتهم الشيشكلي في حملة دعائية العراق وبريطانيا بالتآمر، وزعم العثور على أسلحة إسرائيلية بحوزة مقاتلي الجبل لدعم روايته. ووفق رواية رئيس الشعبة الثانية (الاستخبارات العسكرية) الضابط مصطفى رام حمداني في مذكراته "شاهد على أحداث سورية وعربية وأسرار الانفصال" المنشورة سنة 1999، اضطر الشيشكلي لإرسال الجيش لإحباط "مؤامرة خارجية" وليس لقمع أهل السويداء باعتبارهم طائفة درزية. في نهاية المطاف انتهت الانتفاضة بهزيمة قاسية للجبل وتكريس سلطة الدولة المركزية بالحديد والنار، ولم يعد بمقدور الجبل المطالبة بالامتيازات التي حازها سابقاً أو الطعن في مركزية الدولة.
وبقدر ما مثّلت تجربة الشيشكلي لحظة قمع غير مسبوقة، فقد مثّل الانقلاب عليه واستقالته في فبراير 1954 انعطافة معاكسة. فقد عاد الزعماء الدروز المنفيّون والمعتقلون إلى مواقعهم سريعاً وبشعبية أقوى، واستُقبل سلطان باشا استقبال الأبطال. وبرز الأمير حسن الأطرش مجدداً في موقع رسمي، وزيراً للزراعة في الحكومة الجديدة. وفي انتخابات البرلمان تلك السنة فاز الدروز بأربعة مقاعد، وأعادوا الجبل إلى واجهة العمل البرلماني.
استُعمل اسم محافظة السويداء في الوثائق الرسمية منذ سنة 1949، ولكن مع استعمال اسم محافظة جبل الدروز أيضاً. وحسب دراسة منشورة سنة 2022 لزيدون الزعبي وآخرين عنوانها "تطور خريطة التقسيمات الإدارية في سوريا"، فإن اختلاف الاسمين لم يُحسم لصالح السويداء حتى سنة 1960 أثناء الوحدة السورية مع مصر.
أتت عودة الدروز بعد الشيشكلي في سياق سياسي جديد، إذ طويت صفحة التهديد بالانفصال والامتيازات الخاصة بفعل القمع وتغير موازين القوى، وغدت الدولة مركزية متماسكة والجيش أداة صلبة. ومع استعادة الزعامات التقليدية مواقعها، إلا أنها أضحتْ جزءاً من النظام لا في مواجهته، ولم يعد الصراع على هوية الدولة بل على شروط الاندماج فيها حكماً ذاتياً.
وأمام تماسك الدولة الوطنية في مواجهة التهديدات الداخلية، وفي الوقت ذاته غياب طرف خارجي قادر على تقديم الدعم لمطالب الجبل الاستقلالية، تلاشت ملامح الانفصال. ففي حقبة الشيشكلي توفّر شرط قوة الدولة وتماسكها، وتحقّق الشرط الثاني المتمثل في عدم تدخل إسرائيل بما يجري في الجبل. ولكن هذا تغيّر لاحقاً في الأولويات الإسرائيلية وتعاملها مع جبل الدروز.
باشرت وزارة الخارجية ووحدة الأقليات في الجيش الإسرائيلي محاولات تجسّس ومراسلات سرية، وجسّ نبض الزعامات المحلية، على حد قول وزير الخارجية حينها موشيه شاريت، كما نقل كتاب "الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية" للصحفي البريطاني إيان بلاك والمؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، المترجم إلى العربية سنة 1998. قدّمت هذه الوحدات مقترحات لدعم "ثورة درزية" قد تُخرج سوريا من الحرب العربية ضد إسرائيل، وأُرسل عميل إسرائيلي يدعى لبيب إلى حاصبيا والجبل لاستطلاع النوايا ومد جسور التعاون، لكنه فشل إذ ظل عالقاً في حاصبيا بعدما صار موضع شك وتتبع. وحذّر شاريت القائمين على المهمة من أن إسرائيل ببساطة تفتقر إلى الإمكانيات المالية والعسكرية اللازمة لدعم هذا التمرد. لذا بقيت هذه المحاولات في مرحلة الاستطلاع والتخطيط بلا ممارسات فعلية في تلك الحقبة.
مع سيطرة الشيشكلي على مقاليد الحكم في دمشق كُبحت الجهود الإسرائيلية، ولكنها تجددت مع حملة الشيشكلي العسكرية على الجبل، وفشلت لقصور في الجانب الاستخباراتي.
فمع بدء الحملة تحرك الدروز في الجليل والكرمل وأشعلوا المشاعل وتظاهروا، وأثار نائباهم صالح خنيفس وجبر معدّي القضية في الكنيست الإسرائيلي مطالبين حكومتهم الإسرائيلية بالتدخل العسكري وتسليح شبابهم للقتال في سوريا. ومع أن رئيس الأركان موشيه ديان أبلغهم بأنهم أحرار في العمل دفاعاً عن طائفتهم، لكن ذلك لم يحصل. وفي مذكراته "يوميات شخصية" المنشورة بالعربية سنة 1996، كتب موشيه شاريت الذي أصبح رئيس وزراء في تلك المرحلة أن "الدروز العرب [في إسرائيل] يؤيدون غزو سوريا لاحتلال جبل الدروز باسم تحريره، لكنهم غير مستعدين لتعريض أنفسهم للخطر". ورفض شاريت مقترح موشيه ديان التدخل العسكري وتسليح الدروز في الجبل لتوسيع حدود إسرائيل نحو الجنوب السوري، وقال إن "غياب الوعي بما كان يجري في جبل الدروز كشف عن عيب خطير في استخباراتنا خلال لحظة حرجة".
في بحثه "ذا شيشكلي أسّولت أون ذا سيريان دروز [. . .]" (هجوم الشيشكلي على الدروز السوريين [. . .]) المنشور سنة 2015، كشف الباحث الأمريكي راندال غيلر المحاضر في جامعة ماساتشوستس أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست اجتمعت في فبراير 1954 لمناقشة الخيارات. إلا أن شاريت اعترف أن معلوماته عن جبل الدروز جاءت من السفير الفرنسي في دمشق وليس الاستخبارات الإسرائيلية، كاشفةً محدودية جاهزية إسرائيل الاستخباراتية في الجبل.
كانت النتيجة قراراً بعدم التدخل، والاكتفاء بطرح القضية في المحافل الدولية. وأعاد شاريت تقييم موقفه من الدروز، فقال عنهم في مذكراته: "لا أعرف إن كانت هناك أقلية أخرى متقلبة كالدروز [. . .] فهم يتقلبون من العداء إلى الصداقة، ومن الصداقة إلى العداء [. . .] والدافع الأساس لهم عبر التاريخ كان البقاء، وهذا يبرر كل شيء". في النهاية تخلّت إسرائيل الوليدة عن الرهان على "الكيان الدرزي في الجبل" وانتقلت إلى استراتيجية داخلية فرضت فيها التجنيد الإجباري على دروز الداخل سنة 1956.
عادت الفكرة بعد الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967. فقد أرسل وزير العمل يغال ألون مذكرة رسمية إلى رئيس الحكومة ليفي إشكول، اقترح فيها أن "تقام دولة درزية تابعة لإسرائيل في جبل العرب، تكون بمثابة منطقة عازلة بين الجولان المحتل وسوريا، وتمنع هذه الأخيرة من المطالبة مجدداً بالمرتفعات". وفق ما نقل أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني أحمد سعدي في كتابه "الرقابة الشاملة" المترجم إلى العربية سنة 2020. إلا أن الفكرة لم تلق حماسة كبيرة من المؤسسة السياسية التي اعتبرت أن الوضع في سوريا لم يكن ناضجاً لتقبل مشروع انفصالي جديد. فضلاً عن أن المخابرات الإسرائيلية، بعد تجارب 1948 و1954، لم تكن واثقة من إمكانية بناء شراكة مستقرة مع زعامات درزية في الجبل.
وبهذا، تراجعت جذوة استعمال "الملف الدرزي السوري" أداةً إسرائيلية لتفكيك سوريا من الداخل، وبدا أن جبل الدروز تحوَّل من هدف سياسي مهم إلى مجرد بند في تقارير الاستخبارات وجبهة تتطلب المتابعة لا الانخراط النشط فيها. وتزامن ذلك مع وصول حزب البعث إلى السلطة في سوريا وهو الذي اتبع سياسات أكثر مركزية وقسوة.
وجد أبناء الأقليات، ومن ضمنهم الدروز، في الخطاب البعثي إطاراً للاندماج في المجال الوطني الأوسع. وكان للتعليم دورٌ في هذا المسار، إذ تولّى بعثيون إدارة المدارس وتأسيسها في الجبل، وكان من أبرزهم منصور الأطرش والشاعر نجم الدين الصالح. شكّل هذا التداخل بين المؤسستين التربوية والحزبية قاعدة لانتشار الفكر البعثي، وأسّس شبكات حزبية قروية سرعان ما تحوّلت إلى أدوات نفوذ سياسي واجتماعي فاعلة، وأتاحت هذه الشبكات للبعث التمركز في الجبل عبر أدوات غير صدامية، وفتحت للدروز فرصاً نوعية في مؤسسات الدولة.
مع استيلاء البعث على السلطة في انقلاب 8 آذار (مارس) 1963، لم تُسجل مؤشرات عدائية تجاه الدروز، بل حاز بعضهم مناصب سيادية غير مسبوقة منذ الاستقلال. تولّى حمد عبيد وزارة الدفاع من سبتمبر 1965 إلى يناير 1966، وشغل شبلي العيسمي موقع نائب رئيس الجمهورية من ديسمبر 1965 إلى فبراير 1966، وأصبح منصور الأطرش عضواً في المجلس الرئاسي تحت إمرة أمين الحافظ في مايو 1964.
تغيّر هذا التمكين النسبي مع انقلاب ضباط اللجنة العسكرية في حزب البعث (المحسوبين على القيادة القطرية) على الرئيس أمين الحافظ والقيادة القومية المعروف بحركة 23 شباط (فبراير) 1966. إذ شكّل الانقلاب نقطة تحوّل نحو إقصاء الدروز، وبدأت الاصطفافات تأخذ طابعاً طائفياً بيناً، وتحولت مراكز القرار تدريجياً إلى محميات لصالح الحلقة الأمنية المرتبطة بصلاح جديد وحافظ الأسد (كلاهما من العلويين).
كان الضابط الدرزي المقدم سليم حاطوم من أعضاء اللجنة العسكرية البعثية المشاركين في الانقلاب على أمين الحافظ. ولكنه وجد نفسه مهمّشاً بعد نجاحه، إذ بقي في رتبته العسكرية وكُلّف بحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون. بينما أصبح حافظ الأسد وزير الدفاع، وصلاح جديد الأمين العام المساعد للحزب.
تزامن هذا التراجع مع تزايد نفوذ الضباط العلويين داخل الجيش والحزب. ودفع هذا التهميش حاطوم إلى التحرك السياسي والعسكري، فبدأ التنسيق مع شخصيات قومية وحزبية رافضةٍ هيمنةَ المجموعة العسكرية الجديدة. أنشأ السياسي البعثي منيف الرزاز حينها مكتباً سياسياً عسكرياً سرياً أسند قيادته إلى اللواء الدرزي فهد الشاعر. وكان هدف المكتب استعادة التوازن داخل الحزب، والعودة إلى الخط القومي المرتبط بمؤسسي حزب البعث ميشيل عفلق وصلاح البيطار، بعد أن استأثرت اللجنة العسكرية بمفاصل السلطة.
في إطار التحضير لانقلاب مضاد، وسّع حاطوم شبكة تنسيقه لتشمل مجموعة من الضباط الدروز من داخل المؤسسة العسكرية. أبرزهم قائد القوات السورية على الجبهة الإسرائيلية المقدم طلال أبو عسلي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في السويداء العقيد مصطفى الحاج علي، واللواء فهد الشاعر. وحصل حاطوم على تأييد وزير الدفاع السابق اللواء الدرزي حمد عبيد الذي أُقصي من منصبه عقب صعود حافظ الأسد إلى السلطة.نسج حاطوم علاقات مع جناح مدني معارض في السويداء عُرف بجماعة "الشوفيين"، وهم بعثيون منشقون عن القيادة الجديدة يدينون بالولاء لحمود الشوفي، الأمين العام السابق لحزب البعث، الذي استقال احتجاجاً على استئثار اللجنة العسكرية بقيادة حافظ الأسد وصلاح جديد على القرار الحزبي.
في أواخر أغسطس 1966 كشفت أجهزة الأمن خيوط التنظيم العسكري والسياسي المعارض، وأحبطت التحرك قبل اكتمال خطة التنفيذ. ومع استدعاء حاطوم إلى جلسات تحقيق حزبي، فإن ذلك لم يردعه عن التحرك. وفي أوائل سبتمبر داهم اجتماعاً حزبياً في السويداء واحتجز قادة بينهم صلاح جديد، معلناً تمرده على القيادة المركزية. ردّ تحالف صلاح جديد وحافظ الأسد سريعاً، ففرض حصاراً عسكرياً على السويداء، واستخدم سلاح الجو لقصف بعض المواقع، ما أدى إلى انهيار الحركة وفرار حاطوم إلى الأردن.
أدّت هذه الأحداث إلى حملة تصفية واسعة استهدفت ضباطاً وقيادات بعثية درزية، وهمشت الفرع الحزبي في السويداء، وأنهت عملياً أي حضور مستقل للدروز داخل المؤسسة العسكرية.
وفي خضم هذه المواجهة، وجّه سلطان باشا الأطرش رسالة احتجاج إلى رئيس الأركان السوري أحمد سويداني قال فيها: "أولادنا في السجون مضربون، ونحملكم مسؤولية النتائج. لقد اعتاد الجبل وما زال أن يقوم بالثورات لطرد الخائن والمستعمر ولكن شهامته تأبى عليه أن يثور ضد أخيه ويغدر ببني قومه. هذا هو الرادع الوحيد. ونقتصر مبدئياً على المفاوضات".
يشير بطاطو إلى أن نسبة الدروز داخل حزب البعث بلغت ذروتها سنة 1965 بنسبة 18.8 بالمئة، مقابل 6.2 بالمئة للعلويين. ثم تراجعت بحدة بعد انقلاب 1966، فهبطت إلى 14.3 بالمئة في سنة 1970، في حين قفزت نسبة العلويين إلى 28.6 بالمئة. ما عكس انتقالاً في التركيب الطائفي للنظام، وإقصاء أي مركز ثقل سياسي وعسكري من الدروز لصالح البنية الأمنية الجديدة.
ظلت هذه المعادلة تحكم علاقة السويداء والدروز مع المركز طوال حكم حافظ الأسد الطويل.
ساعدت البنية الحزبية في إضعاف العلاقات العشائرية التقليدية في الجبل دون أن تنتج تمثيلاً سياسياً حقيقياً. وينقل بطاطو عن أحد فلاحي مدينة شهبا في السويداء سنة 1985 قوله: "فلاح بسيط بات يمكنه أن يذلّ آل عامر"، في إشارة إلى انكسار الهالة الاجتماعية للعائلات الإقطاعية أمام آليات الضبط الجديدة التي فرضها النظام.
ومع أحداث حماة سنة 1982 حين شنّ حافظ الأسد حملة لقمع تمرد الإخوان المسلمين، وظّف النظام خطاب المظلومية التاريخية للدروز، مركزاً على فترة حكم أديب الشيشكلي وقصف السويداء سنة 1954، لإبراز خطر "السنّة المتشددين الحمويين" الذين قصفوا الجبل سابقاً. وهذا حسب ما روى الكاتب سعدو رافع في مقالته "واقع الدروز في الثورة السورية" المنشور في أكتوبر 2011. وفّرت هذه اللغة غطاءً سياسياً للسلطة لإحكام قبضتها، وفتحت المجال أمام تحالفات جديدة مع نخب دينية محلية موالية، دُعمت لتكون مرجعية معتمدة بدلاً من البنى التقليدية والشخصيات المستقلة.
ومع نجاح نظام الأسد في فرض هذا النموذج، بقيت رمزية سلطان الأطرش عصية على الاحتواء الكامل، ولم يزره الأسد إلا في جنازته سنة 1982. وفي سنة 1986 تحوّلت ذكرى تأبينه إلى مناسبة احتجاجية، بدأت بمسيرات طلابية وامتدت إلى مظاهرات شعبية في عموم السويداء، رفعت مطالب معيشية في ظل الحصار الاقتصادي الذي كانت تعانيه سوريا. ويشير رافع إلى أن تلك المظاهرات خرجت عن سيطرة الأجهزة واتخذت منحى احتجاجياً عاماً.
ضمن هذا السياق السياسي والاجتماعي، برزت حالة حمود الشوفي نموذجاً لمثقف بعثي درزي سعى النظام إلى احتواءه. فقد عينه الأسد مديراً لإدارة أمريكا في وزارة الخارجية بين سنتي 1972 و1978، وبعدها أصبح مندوب سوريا في الأمم المتحدة سنة 1978. ولكنه قدّم استقالته في نهاية 1979 في مؤتمر صحفي، منتقداً غياب الحياة الديمقراطية وتفشي الفساد في سوريا، ومعلناً أن حملة مكافحة الفساد توقفت فور أن طالت الحلقة المقربة من حافظ الأسد. رُدّ على الشوفي بحكم الإعدام ومصادرة أملاك زوجته، لينضم سنة 1982 إلى تشكيل التحالف الوطني لتحرير سوريا من الأسد، إلى جانب شخصيات قوى قومية ويسارية وإسلامية، ومنها شبلي العيسمي. وهو تحالف كان من أوائل الصيغ العابرة للطوائف في معارضة نظام الأسد الأب.
ومع توريث الحكم إلى بشار الأسد سنة 2000، واصلت السلطة اتباع النمط الإداري الأمني ذاته تجاه جبل الدروز. يقول المؤرخ السوري محمد جمال باروت في كتابه "العقد الأخير في تاريخ سوريّة: جدليّة الجمود والإصلاح" المنشور سنة 2012، إن السويداء لم تُدمج في المعادلة التنموية للنظام. إذ عانى الجبل على المستوى الاقتصادي ولم تعد الزراعة البعلية (المعتمدة على مياه الأمطار) كافية، فاقمها غياب الاستثمار التنموي منذ عهد الأسد الأب. دفع ذلك شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين أو وظائف الدولة التي لم تكن متاحة للجميع، ولكنها شكّلت أحد مداخل السلطة إلى المجتمع لأنها ربّ العمل الأساس.
بعد خمسة أشهر من تولى الأسد الابن الحكم واجه أول اختبار حقيقي في السويداء، تمثل في اندلاع اشتباكات واسعة بين الدروز والبدو، نتيجة نزاع متجدد حول رعي البدو مواشيهم في أراضٍ زراعية مملوكة لأهالي الجبل. غير أن هذه المرة كانت مختلفة الحدة والتصعيد، إذ أدى مقتل شاب درزي على يد مسلحين بدو إلى اندفاع الأهالي الدروز نحو مواجهات مباشرة وثأرية معهم، ونحو التظاهر أمام مقار السلطة للمطالبة بحمايتهم ومحاسبة الفاعلين.
سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات ضد النظام نفسه بعد الرد الأمني عليها، وانتهى الأمر بتدخل الجيش في السويداء لفرض الأمن، ما أسفر عن قتلى ومصابين من أبناء المحافظة.
فُرض التعتيم الإعلامي على الحدث، حسب رواية رافع، وروّج النظام شائعة أن الضابط الذي أعطى أوامر إطلاق النار على المتظاهرين حموي، في إحالة ضمنية إلى الثأر التاريخي مع أديب الشيشكلي (الحموي). هذا الاستخدام المتقن للذاكرة الأهلية كان أحد أدوات السلطة في تحويل أي احتجاج إلى مناسبة لإعادة إنتاج رواية طائفية وتثبيت انقسام عمودي يمنع التقاء الخصوم على قاعدة وطنية مشتركة.
لم تكد تلك المواجهة تُطوَى حتى عاد الجبل إلى الواجهة. فعلى إثر تصاعد السجال اللبناني حول الوجود السوري في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري سنة 2005. برز وليد جنبلاط في مقدمة الأصوات المطالِبة بانسحاب القوات السورية، ما أثار مخاوف النظام من ارتدادات محتملة في السويداء. وبحسب مقال إياد العبد الله وعبد الله الحلاق "دروز سورية" المنشور سنة 2017 في صحيفة "الجمهورية"، فقد سهّل النظام تحرك أنصاره من دروز لبنان، مثل طلال أرسلان ووئام وهاب، لإجراء تواصل سياسي واجتماعي مع دروز الجبل لعزل خطاب جنبلاط عن الأوساط الدرزية السورية.
كانت السويداء قد شهدت انخراطاً من شبّانها المسيّسين مع انطلاق النشاط السياسي في سوريا إثر وفاة حافظ الأسد المعروف بفترة "ربيع دمشق" في عامي 2000 و2001، سواء في الفضاءات الجامعية أو المنتديات السياسية أو عبر الصحف والاعتصامات، خصوصاً في دمشق. شارك أبناء الجبل في لحظة الانفتاح جزءاً من التيار المدني السوري، لا مكوّناً طائفيّاً مستقلّاً، ونالهم ما نال غيرهم من الاعتقالات والملاحقات والإقصاء من الوظائف. وبدا أن الرئيس الجديد حينها بشار الأسد لن يسمح بأي مساحة حرة، حتى ضمن البيئات التي حاول احتواءها رمزياً مثل السويداء، ما مهّد لاحقاً لانفجار التناقضات الكبرى مطلع سنة 2011.
قوبلت المظاهرات السلمية بقمع أمني أقلّ حدة من المحافظات الأخرى، إذ سارع النظام إلى اعتقال العشرات من أبناء المحافظة في محاولة لاحتواء الحراك. شكل هذا القمع نقطة تحول مبكرة في وعي الحراك المحلي، وبدأت تتبلور قناعة متزايدة أن الحراك السلمي وحده ربما لن يكون كافياً لضمان حماية المجتمع في ظل تصاعد العنف وتحوّل المشهد إلى حرب واسعة.
حافظت السويداء على موقف شبه حيادي في السنوات اللاحقة، فلم تتحول إلى انتفاضة شعبية كبيرة أو حراك مسلح ضد النظام، مع وجود ضباط منشقين منها شكلوا كتائب تابعة للجيش السوري الحر (المظلة العامة لمقاتلي الثورة السورية حينها) في درعا. كان أبرز هؤلاء الملازم أول خلدون زين الدين، أول ضابط من محافظة السويداء وأول درزي ينشق عن قوات النظام السابق. قُتل زين الدين بنيران النظام السابق مطلع سنة 2013 حين حاول نقل المعارك إلى المحافظة.
كان التحول الأهم في أبريل 2014 أثناء احتفالات نظمها أتباع النظام بترشيح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية. تسبب صدام بين عناصر أمن النظام من جهة ورجال دين دروز يقودهم وحيد البلعوس من جهة أخرى بحراك واسع دُعي "انتفاضة مشايخ الكرامة" طالب بإقالة رئيس فرع الأمن العسكري وقتها العميد وفيق ناصر. كان البلعوس بدأ تشكيل مجموعة مسلحة حوله قبل ذلك، وأنشأ مظلة جديدة للدروز خارج عباءة المشيخة الروحية دون محاولة إسقاطها، والتي أصدرت بياناً في العاشر من أبريل سنة 2014 يرفض حراك البلعوس ويحرّم حمل السلاح مع الزي الديني. ولكن البلعوس أصرّ على موقفه ودعا جميع شبان الدروز إلى حمل السلاح "لصدّ كل عدوان على جبلنا".
كانت عمليات الخطف المتبادلة بين الدروز وبدو اللجاة ومقاتلي درعا أحد مبررات البلعوس لحمل السلاح والتدخل مع عجز الدولة عن حلّ قضايا الخطف. ولكن حراكه كان بداية التشكيلات المسلحة المستقلة عن النظام والثورة معاً في السويداء. وتحوّل اسم حركته لاحقاً إلى "حركة رجال الكرامة".
بدأ البلعوس نهج "الحياد المسلّح"، إذ نادى برفض التحاق أبناء السويداء بالخدمة العسكرية الإجبارية في جيش النظام، وضمن لهم الحماية من الاعتقال، وهو ما استجيب له طيلة السنوات اللاحقة. انطلق الموقف من خصوصية الجبل وأولوية حماية أبنائه، ورد النظام بأساليب عقابية منهجية مثل فصل الموظفين وملاحقة المطلوبين، دون الدخول في صدام عسكري واسع. ولكن البلعوس اصطدم عسكرياً مع عناصر النظام في أكثر من مناسبة، وخاصة مع حواجز تابعة للمخابرات الجوية والعسكرية.
في ذات الوقت، واصل نظام الأسد سياسة مزدوجة تجاه الجبل. استمر النظام في توظيف شخصيات درزية في المناصب الحكومية والأمنية محلياً، في محاولة لاستمالة بعض الشرائح الاجتماعية، وأبرز ضباطاً دروزاً في قيادة حملاته العسكرية ضد الثورة مثل عصام زهر الدين. ولكنه في المقابل تجاهل المطالب الاقتصادية، وعزّز وجود قواته الأمنية وشكّل مجموعات عسكرية رديفة موازية مثل قوات الدفاع الوطنية التي ظهرت سنة 2012، و"قوات الفجر" بقيادة راجي فلحوط، الذي اتخذ من بلدته عتيل ومحيطها مقراً له.
بلغ التوتر ذروته عند اغتيال الشيخ وحيد البلعوس بتفجير استهدف موكبه في الرابع من سبتمبر 2015. ومنذ ذلك الحين، تحوّل موقف "رجال الكرامة" من الحياد المسلح إلى موقع أقرب إلى المعارضة. وبرزت الحركة قوةً عسكرية محلية منظمة لا تدين بالولاء للنظام، بل تدافع عن حقوق أبناء السويداء وتتصدى لأي تهديد خارجي أو داخلي يمسّ أمنهم.
تعرض نهج الحياد لضربة قاسية في يوليو 2018، حين تعرضت السويداء للهجوم الأعنف خلال سنوات الثورة السورية. إذ نفّذ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سلسلة عمليات في قرى المحافظة أسفرت عن مقتل 158 مدنياً واختطاف العشرات، وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2018. شكّل هذا الحدث صدمة كبرى هزّت المجتمع المحلي، خاصة مع اتهام النظام بالعجز أو التواطؤ. وحسب التقرير، فقد قُطعت الكهرباء عن القرى المستهدفة قبيل الهجوم مباشرة، وقصف الطيران الحربي التابع للنظام مناطق بعيدة عن عناصر التنظيم.
في المقابل، اتهم بشار الأسد رافضي الخدمة الإجبارية والساعين للحياد بالمسؤولية عن النتيجة، وأيده شيخ العقل حكمت الهجري الذي دعا إلى وقف الامتناع عن الخدمة و"تلبية نداء الوطن". ولكن الحدث الدموي وتعامل النظام معه والشكوك بتواطئه، أدت إلى اعتماد أكبر على الفصائل المحلية، ومهّدت لتحول السويداء إلى بؤرة معارضة بعد ذلك.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سورية في السنوات اللاحقة، ومع أن الأزمة كانت عامة، إلا أن الطابع الزراعي والاقتصاد الهش في السويداء جعلها أكثر عرضة للتدهور. وقفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، مع غياب سياسات تنموية أو تدخل حكومي فعّال، فتحوّلت المعاناة الاقتصادية إلى عامل تفجير للاحتقان الكامن.
كانت الشرارة الأبرز لهذا الانفجار قرارَ النظام في فبراير 2022 حين قُطع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من المواطنين. ووصلت تداعياتها إلى خروج احتجاجات معيشية في السويداء في يوليو تحوّلت إلى مطالب سياسية ورفعت شعارات الثورة السورية التي تطالب برحيل بشار الأسد. ولكن في أغسطس 2023 بدأت مظاهرات السويداء اليومية التي استمرت حتى سقوط نظام الأسد، وكانت تشبه ملامح الانتفاضات المحلية بداية الثورة السورية، بشعارات الثورة نفسها.
بعد رسوخ الحراك في السويداء دعمت مشيخة العقل المتظاهرين، الذين أغلقوا مقرات النظام وحزب البعث وحوّلوا المحافظة إلى مركز معارض داخل مناطق سيطرة النظام. لم يتدخل النظام في المقابل درءاً لصدام عسكري واسع مع الطائفة، ما عدا بعض محاولات القمع الأولى. ولكن عدم تدخله شجّع الحراك على الاستمرار والتوسع في المقابل. وبرز الشيخ حكمت الهجري، الذي رسّخ حضوره مرجعيةً دينية واجتماعية للطائفة، بعد موقفه الداعم مطالب المظاهرات بعد تأييده السابق للنظام، الذي أدى سقوطه بعد أشهر من الحراك لعودة الجبل لواجهة الأحداث بصيغ أخرى.
تجلّى الانقسام في مواقف مشايخ العقل الثلاثة. فقد دعا الشيخ يوسف جربوع إلى المصالحة والانخراط بشروط محددة في إطار دولة سورية موحدة. فيما تبنى الشيخ حمود الحناوي موقفاً معتدلاً رافضاً أي تدخل أجنبي، لا سيما من إسرائيل، مؤكداً في كل مناسبة على وحدة سوريا والانتماء الوطني الدرزي. في المقابل اتجه الهجري إلى مواقف أكثر صرامة، وصلت في النهاية إلى الدعوة لإنشاء كيان درزي مستقل، وذهب في عدة مناسبات إلى طلب الحماية من إسرائيل.
انفجرت هذه التناقضات في الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء في يوليو 2025، حين تحوّل الصراع التاريخي المتكرر بين البدو والدروز إلى معركة معقدة. فتدخلت الحكومة عسكرياً واقتحمت السويداء، وتوحّدت معظم الفصائل الدرزية المسلحة على مقاومتها. ثم تدخل الطيران الإسرائيلي لصالح الهجري وقواته، وسارت أرتال من العشائر السورية للمشاركة في الاقتحام. سقط مئات الضحايا من جميع الأطراف في المواجهات، إلى أن توقفت باتفاق دولي. وبقيت السويداء معزولة عن الدولة المركزية، ويرفع صاحب القرار الأول فيها الشيخ حكمت الهجري مطالب إعلان دولة مستقلة.
وفي محاولات تدارك التصدعات، بُنيت العلاقة بين المركز والجبل غالباً على تسويات هشة سرعان ما تداعت عند تبدّل موازين القوة. فيما ظلت اللحظات التي اجتمع فيها ضعف الدولة مع تدخل أو دعم خارجي، مساحةً لتقدم خطاب الانفصال والحكم الذاتي ومطالب الخصوصية والامتياز.
خلف هذا كله تُظْهر أزمة جبل العرب أزمةً أوسع في آليات الدمج الوطني عند مراحل التحوّل في سوريا. إذ كانت محاولات فرض السلطة من خارج الجبل بالقسر تفشل غالباً وتترك احتقاناً لا يلبث أن ينفجر، أو تصبح بوابة لتدخل خارجي يستغلّ الانقسام. ولم تقم محاولات حوار طويل الأمد لبناء علاقة قوامها المشاركة والاعتراف المتبادل وتبديد المخاوف في الطرفين.
بهذا كانت السويداء، ويبدو أنها ما زالت، مرآة تكشف مأزقاً تاريخياً. دولة تمتلك أدوات القسر ولكن تفشل في الدمج الطوعي، وجبل يطالب بامتيازات استثنائية ويملك قرار الرفض.